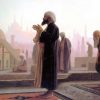المحتويات
توطئة
عَرَف السّلوك السياسي للعلماء المغاربة في التاريخ الراهنِ تباينًا كبيرا على مستوى خلفياته ورهاناته، نظرا للاختلاف في الموقف من نظام الحكم، ولتباين التراتبية الطبقية والاجتماعية بين العلماء أنفسهم في علاقتهم بامتيازات السلطة والوجاهة الاعتبارية للوظيفة الدينية الرسمية، وهو ما تجلى في تعدُّد المبادرات السياسية لنخبة علماء الدعوة، المتوسِّلة بمنهجية النصح السياسي المتمثلة للنموذج التاريخي الإسلامي “لسلطان العلماء” بينما نجد على مستوى الحقل الديني، فعل سياسي موسمي ومحافظ نهجه علماء الدولة كلّما دعت إلى ذلك مصلحة السلطة السياسية.
علماء المؤسسات الرسمية.. دعامة دينية للمؤسسة الملكية
أكدّ الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف على رفضه تصنيف العلماء إلى علماء للدولة وعلماء للدعوة والشعب، باعتبار أنّ هذا التقسيم لا مرجعية له في السياق المغربي، وذلك بقوله “في تقاليدنا المغربية لا يجوز التفريق بين علماء الأمة بجعلهم طائفتين، طائفة مع ولاة الأمر وطائفة مع الشعب لأن في ذاك التصنيف ضرراً خطيراً، ولذلك لا مكان لهذا الطرح الذي لا مرجعية له في تاريخنا ولا في ثقافتنا”[1].
لكن رغم هذا الاعتراض على توصيف “علماء الدولة” والمنتصر لعضوية نخبة العلماء ضمن أهل الحل والعقد في الدولة فإن واقع حال المؤسسات الرسمية للعلماء يبين بأن وظيفتها الأساسية تنحصر إلى حد بعيد في تزكية ودعم الاختيارات السياسية للسلطة الحاكمة، وإيجاد المسوغات الدينية لشرعنتها داخل المجتمع المغربي.
وعموما، ما كان ممكنا بحسب المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز، لمؤسسة الإسلام الرسمي بأن تقوم بغير هذه الوظيفة في التسويغ للسلطان السياسي، وفي التمكين له من تحقيق أعزّ الأهداف بالنسبة إلى أية سلطة، الهيمنة الثقافية والايديولوجية، فهي في النهاية لا تقوم إلا به، ولا تستمد سلطانها الأيديولوجي إلا من سلطانه السياسي المادي، ناهيك بأن تمثل جزءاً من كيان ذلك السلطان، وتتلقى عن وظيفتها “عائدات محترمة” تبرِّر لها ما تقوم به!”[2].
فقد أدى الارتباط العضوي لمؤسسة العلماء بالنظام السياسي إلى انحصار دورها في التأطير الدِّيني الضيق القائم على التعريف بقطعيات الدين التعبدية وتبليغها لعموم جماعة المؤمنين، مع التخلي عن الوظيفة السياسية المعيارية للمؤسسة الملكية المحتكرة للحقلين الديني والسياسي، التي حرصت منذ السنوات الأولى للاستقلال على نهج سياسة إدماج العلماء ضمن مؤسسات دينية تابعة لها، بُغْيَة التحكم فيها وجعلها دعامة أساسية للحكم، وبالأخص في التأصيل الشرعي لمشروعيته الدينية القائمة على إمارة المؤمنين والنسب الشريف والبيعة.
ومن ثم فلا غرو، أن يمتد الدعم الديني الذي يقدمه العلماء الرسميون للنظام السياسي من سياق الشأن الديني وروحانيته إلى مساق الحقل السياسي وصراعاته، فيتأسّس الدعم الإيديولوجي العلمائي للنظام على مسلمتين:
- قيام العلماء بأدوار سياسية تروم مساندة توجهات الدولة، دون التحول إلى فاعلين سياسيين.
- استثمار التراث الإسلامي لإنتاج عُدّة فقهية وكلامية تؤصل لقداسة المؤسسة الملكية وتَعَاليها على جميع الفاعلين في الحقلين الديني والسياسي، وفقا لقراءة محافظة لإمارة المؤمنين والإمامة العظمى مستنبطة من الفقه السياسي لكتب الآداب السلطانية.
وقد دافع وزير الأوقاف أحمد التوفيق عن ذلك في مناسبات مختلفة ومنها في محاضرته حول “مهمة العلماء في سياق الاختيار الديمقراطي”، إذ ربط دعم العلماء للاختيارات السياسية للنظام بأدوار معظمها من باب الافتراض، وذلك بقوله: “وارتباط العلماء بإمارة المؤمنين، هو العقيدة الصلبة التي تؤهل المغرب لبناء نموذج بلد يدافع عن الإسلام لا بالمجاملة الكلامية؛ بل بتجربة كاملة غير مسبوقة تلعب فيها الرسالة المعنوية للعلماء دوراً مهما في تقوية الدولة، وتنمية الاقتصاد ورعاية العلوم والثقافة، ودعم العائلة، وتربية الناشئة، وإقناع الشباب بأساليب متعددة بقيم تصونهم من العبث. إن الطاقات التي يكبلها التوجس بين الغيورين على الدين، ينبغي أن تنطلق للإسهام في هذه التجربة بضمانة تجلت متانتها في مدونة الأسرة الأخيرة”[3].
علماء المؤسسات والقضية النسائية
انحصرت أهم أولويات السلوك السياسي لعلماء الدولة منذ حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، في عنوان الحفاظ على الأصالة والخوف من اندثار الهوية الدينية للمجتمع والدولة، وقد التَقى هذا التخوف موضوعيا مع وجود إرادة سياسية لحصْرِهم في الوظائف التقليدية المنحصرة في البعد الهوياتي المحض، وفي هذا السياق كانت لهم إسهامات واضحة في ميلاد أول قانون للأحوال الشخصية بالبلاد سنة 1958، إذ كانت لهم السيطرة التامة على اللجنة التي وضعت المشروع، من خلال تعيين الملك محمد الخامس بتاريخ 19 غشت 1957 لجميع أعضائها دون استثناء من خريجي جامعة القرويين[4].
كما سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن عين ثلة من العلماء أعضاء في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية في شتنبر من سنة 1993 برئاسة المستشار الملكي الراحل عبد الهادي بوطالب.
ففي سياق التفاعل مع مبادرة اتحاد العمل النسائي بجمع مليون توقيع للمطالبة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس سنة 1992؛ وجَّه الملك الحسن الثاني خطابا للشعب بمناسبة ثورة الملك والشعب في 20 غشت في نفس السنة، أكد فيه أنه هو المسؤول الأول بصفته أميرا للمؤمنين عن تعديل المدونة، وأن على المنظمات النسائية الرجوع إليه لحل مشاكلها، كما حذر من استغلال هذا الموضوع في الحملات الانتخابية لحساسيته وخطورته، كما طالب الجمعيات النسائية بأن توجه إليه مؤاخذاتها على المدونة واعدا إياها بالاجتماع بالعلماء لحل هذا المشكل[5].
وبعد ست سنوات من إصلاح مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993 وعلى إثر إعلان الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي عن مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية في احتفال رسمي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في يوم التاسع من مارس من سنة 1999 بمسرح محمد الخامس بالرباط بحضور نائب رئيس البنك الدولي وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية، أسّست وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة من العلماء لإبداء الرأي في مدى شرعية المضامين والتدابير الإجرائية التي تضمنتها الخطة[6]، وقد عارضت هذه اللجنة في تقريرها الصادر عن مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ماي سنة 1999 مقترحات الخطة فيما يتعلق برفع سن الزواج إلى 18 سنة، وإلغاء الولاية في الزواج، ووضع الطلاق بيد القضاء وإلغاء تعدد الزوجات، وكذا اقتراح توحيد سن الحضانة بين الذكر والأنثى في سن الخامسة عشر وإلغاء الفصل 105 من مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1993 الذي يحرم الأم من الحضانة بعد زواجها، وإحداث محاكم مختصة بالأسرة ومنح الحق للنساء لتولي قضاء التوثيق.
وقد تأسّست معارضة علماء الدولة للخطة بكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، وبأنها أقصت العلماء الذين هم أهل الاختصاص فيما يرتبط بالأسرة والأحوال الشخصية وتعديل المدونة. فورد في تقريرهم السالف بأنه ينبغي “ألا تكون هذه المهمة لأحد غير العلماء المختصين بالشريعة، أما ما يقال عن القضاة والمحامين والأطباء النفسانيين ومن شابههم من الفئات الاجتماعية الأخرى فليس لهم الحق في ذلك، لأن وظيفتهم محصورة في العمل الذي يقومون به، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ترقى إلى درجة مراجعة القوانين وخاصة تلك التي تستمد وجودها من أحكام الشريعة الإسلامية كقانون مدونة الأحوال الشخصية، فالعلماء وحدهم لهم الحق في إضفاء الطابع الشرعي على مختلف النصوص التي يمكن مراجعتها في هذا المجال، لأن الأمر ديني تعبُّدِي، محكوم بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، ومحكوم بقواعد الشريعة الإسلامية وبأحوالها وبمقاصدها[7].
وتعضّدَت معارضة العلماء هاته برفض جمعيات العلماء شبه الرسمية للخطة وفي مقدمتها رابطة علماء المغرب وجمعية خريجي دار الحديث الحسنية وفئات واسعة من علماء حقل الدعوة أفرادا ومؤسسات، مثل البيان الصادر عن علماء وخطباء مدينة الدار البيضاء بتاريخ 20 يوليوز 1999 وبيان جمعية علماء وخريجي كلية الشريعة بأكادير بتاريخ 8 شتنبر1999.
كما أدى الاختلاف الإيديولوجي حول مضامين خطة الوزير سعيد السعدي القيادي السابق بحزب التقدم والاشتراكية إلى تنظيم مسيرتين وطنيتين يوم 12 مارس 2000، الأولى نظمت بمدينة الرباط كانت داعمة للخطة وشاركت فيها الجمعيات النسائية والقوى الحداثية واليسارية، والثانية جابت أهم شوارع الدار البيضاء وتميزت بالمشاركة العددية القوية لمختلف أطياف التيار الإسلامي وعلماء وسلفيين وأتباع جماعة الدعوة والتبليغ، وانضاف إليها لأسباب سياسة رموز أحزاب اليمين الإداري كالاتحاد الدستوري والحركة الشعبية بقيادة أمينها العام حينئذ المحجوبي أحرضان .
وعلى إثر التداعيات السياسية للاستقطاب الحاد الذي خلَّفه مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية على المستوى المجتمعي؛ أسهم العلماء المعينون من قبل الملك محمد السادس في اللجنة الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية بتاريخ 27 أبريل 2001 في الوصول إلى صيغة توافقية حول قانون مدونة الأسرة سنة 2004.
وباستقراء النتائج السياسية لجهود العلماء في التأصيل الفقهي لاجتهادات مدونة الأسرة في القضايا الخلافية مثل إلغاء الولاية، التي انفتحت فيها المدونة على المذهب الحنفي أو في مسألة اقتسام الممتلكات المشتركة بين الزوجين في حالة الطلاق المؤصلة أساسا من اجتهاد أحد أعمدة الفقه المالكي بالمغرب ابن عرضون المشهورة بفتوى الكدّ والسعاية، نرى بأن العلماء (أعضاء اللجنة) أسهموا في تقوية المشروعية الدينية والتحكيمية للمؤسسة الملكية، عندما ترجموا رغبتها السياسية في تطوير قانون مدونة الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع قطعيات الشريعة الإسلامية.
كما أبانت لحظة ميلاد مدونة الأسرة سنة 2004 عن استحالة الاستغناء عن الوظيفة الفقهية للعلماء في إرساء التوافق المطلوب بين مجال الشريعة وحقل القانون في بنية الدولة، على اعتبار أنَّ حُسْن تدبير وتنزيل العلاقة بينهما يعدّ من أهم التسويات التاريخية المنشودة من قبل فئات واسعة من الشعب المغربي لإرساء مصالحتها بالسياسة، وتحسين رؤيتها للدولة الوطنية الحديثة.
وفي خضم تداعيات إعلان المستشار الملكي محمد معتصم من خلال رسالة ملكية عن رفع المغرب لتحفظاته عن الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمناسبة الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من دجنبر من سنة 2008 بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حينئذ، وما واكب ذلك من نقاش أيديولوجي وقانوني في أوساط الجمعيات النسائية والحقوقية حول مدى شمول هذا القرار لبعض الأحكام الشرعية في قضايا الأسرة والإرث. أصدر المجلس العلمي الأعلى بلاغا في الموضوع يوم 17 دجنبر 2008 أكد فيه حرص مؤسسة العلماء بقيادة الملك محمد السادس على التمسك بإسلامية المملكة، فورد في البلاغ “إن المجلس العلمي الأعلى بعد الاطلاع على مختلف الآراء التي راجت حول رفع المملكة المغربية لتحفُّظات بشأن الاتفاقيات الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، يؤكد أن هذا الإجراء الواضح لم يثر عند العلماء ولا يجوز أن يثير لدى المجتمع أي تساؤل حول تمسك المغرب بثوابته الدينية وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم والتي لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية. وضمانة المغاربة في التمسك بهذه الثوابت، هو أمير المؤمنين الذي يقود البلاد نحو كل أنواع التطور المفيد المنفتح، هو لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا “[8]، واعتبر المجلس العلمي الأعلى أن قرار رفع التحفظات جاء فقط لملائمة مضامين مدونة الأسرة مع القوانين الدولية في الموضوع”[9].
ويتضح من خلال تتبع مسار مواقف مؤسسة العلماء من القضية النسائية، بأنها حريصة على مقاربتها ضمن قطعيات الشريعة وفي سياق تفهّم الالتزامات الدولية للحكم، الذي يستثمر في هذا المجال لإعطاء صورة حداثية عنه في الخارج في محاولة لتجاوز الإخفاقات البنيوية في مجال الديمقراطية السياسية.
علماء المؤسسات و”الإسلام المغربي”
من بين أهم الواجهات التي تصدَّت لها المؤسسة الرسمية للعلماء في سعيها لتقديم السند الإيديولوجي للنظام المغربي، نجد اندفاعها الشديد في مواجهة ما تراه السلطة السياسية خروجا عن الإجماع الوطني في قضايا الدين والسياسة، وتهديدا لخصوصية “الإسلام المغربي”.
ومن ثم يقوم العلماء الرسميون باعتبارهم مؤتمنين من قبل مؤسسة إمارة المؤمنين للحفاظ على مرتكزات “الإسلام الشرعي” في بعده السياسي القائم على ترسيخ مفاهيم الطاعة لولي الأمر، البيعة، والإمامة العظمى، وكذا توظيف الخطاب الديني لتسفيه أي رأي تراه السلطة معارضا للثوابت الدينية والسياسية.
وفي هذا السياق وظف المجلس العلمي الأعلى لغة الجدل السياسي والتجريح الشخصي إبّان تفاعله مع المستجدات والمواقف المفاجئة لنمط سيره البطيء والتقليدي، وترجم ذلك في بياناته سواء ضد فتوى الشيخ يوسف القرضاوي حول جواز اقتراض المغاربة من البنوك من أجل السكن، أو في ردّه على الشيخ المغراوي في قضية زواج الفتاة الصغيرة سنة 2008[10].
وبلا شك، فللمجلس العلمي الأعلى حقّ في الرد على المواقف الفكرية والسياسية المخالفة للعقل الفقهي والسياسي الرسمي، لكن من الأجدر به أن يتحلى بالجرأة لأخذ زمام المبادرة في مجال الاجتهاد حول النوازل المستجدة، وأن يتفاعل مع الأصوات المعارضة والأفكار المزعجة بالحجة والحوار.
علماء المؤسسات والإصلاح الدستوري
كما كان متوقعاً؛ انخرط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية بقوة في دعم دستور 2011، رغم إقصائهم الواضح عن العضوية في اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع الوثيقة الدستورية.
وقد تزامن هذا الإقصاء السياسي مع الغياب التام للعلماء المستقلين في حقل الدعوة عن التفاعل الإيجابي مع الحراك السياسي لشباب 20 فبراير، نظرا لتجذر الثقافة السياسية المحافظة في صفوف العلماء، الذين يرى معظمهم بأن النضال السياسي من أجل التغيير والديمقراطية لا يعدو أن يكون وسيلةً غيرَ مشروعةٍ لزرع بذور الفتنة وزعزعة الاستقرار، ضِمْن نظرة مستوحاة من شعار شهير لديهم يعلِنُ أنَّ “الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها”.
ومن ثم، تأسست مقولات علماء الدولة في دعم دستور 2011 على أساس ديني فقهي، وأن ذلك من لوازم الطاعة لأمير المؤمنين، ومن مقتضيات البيعة الشرعية المنعقدة له، كما اعتبَرت مؤسسة المجلس العلمي الأعلى أن من واجبها الشرعي الانخراط “في مشاريع الإصلاحات الكبرى التي يخوضها جلالة الملك محمد السادس، وأن تَتَعَبّأ وتُعبئ الناس وراء أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، في كل عمل إصلاحي يكتمل به بناء الصرح الديمقراطي بما فيه ورش الإصلاح الدستوري وما يقتضيه من مواكبة”[11]. وارتكزت معظم مبررات علماء مؤسسة إمارة المؤمنين في تأييدهم حينئذ لمشروع الدستور على معيار محافظته على الهوية الدينية للبلاد، فورد في بيانهم بأن “العلماء يباركون كل ما جاء في مشروع الدستور وخاصة المضامين التالية: التأكيد على أن الإسلام دين الدولة – الحفاظ على ثوابت الأمة وخصائص الهوية المغربية – سمو الإسلام على المواثيق الدولية – إمارة المؤمنين بصفتها حامية للملة والدين – حضور مؤسسة العلماء في الدستور – المساواة بما يتلائم مع ثوابت الأمة – صيانة الأسرة والتنشئة على الثوابت والقيم – تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام – إشراك الشباب في المشاريع الإنمائية وفي النهوض بالاقتصاد – ثوابت الأمة لا يمكن أن تكون محلا للتعديل[12].
وتدْعِيمًا لهذا البيان؛ عَمّمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الجمعة 24 يونيو 2011 خطبة موحَّدَة تُلِيَت في جميع مساجد المملكة، تم فيها توظيف الخطاب الديني بقوة للتأكيد على ضرورة تصويت المواطنين بــ”نعم” على مشروع الدستور، باعتبار ذلك تأدية لشهادة مطلوبة شرعا، وواجب وطني يستوجبه حب الوطن والتعلق به، والتفاني في النهوض به”[13].
وقد جدّدَت قضية الدعوة بالتصويت بــ”نَعم” على مشروع دستور 2011 باعتباره واجبا شرعيا، طرح إشكالية موقع ووظيفة الخطاب الديني وفتاوى المجلس العلمي الأعلى في بنية الدولة، وعلاقتهما بمتطلبات بناء الدولة الديمقراطية بالبلاد، إذ تبين في الكثير من الوقائع السياسية أن الخطاب الديني الرسمي كان في معظمه في تناقض فكري منهجي عميق مع قيم الديمقراطية والتعددية السياسية، من خلال تمسُّكِه بمبرّرات ومفاهيم، مِن قبيل: “خصوصية النظام المغربي” و”الإجماع الوطني” في قضايا سياسية نِسبية تحتمل الأخذ والرد مثل المسألة الدستورية.
خاتمة
لقد أدَّى منهج استتباع مؤسسة العلماء لرهانات النظام السياسي بشكل مطلَقٍ إلى الإضرارِ بمصداقيتها وسُمعتها لدى الجمهور، وكانت له نتائج وخيمة على تأثير النموذج المغربي في التدين والفقه والفكر الإسلامي على فئات واسعة من الشباب، أمْسَت ضحية لضعف الاحتضان الراشد للعلماء، مما جعلها عرضة لتأثير التيارات الإلحادية والتكفيرية الشاذة عن طبائع المجتمع المغربي، مثل ما شهدناه مع حركة “مالي” اللادينية، أو في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المشهور بـ”داعش”، الذي شكل الشباب السلفي المغربي قاعدته الأوسع بعد السعوديين والتونسيين والأردنيين.
المراجع
[1] حوار للكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف مع مجلة مدارك العدد السادس، أكتوبر 2006، ص: 26.[2] عبد الإله بلقزيز: "الإسلام والسياسة، دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال السياسي"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 1، ص :200.
[3] التوفيق أحمد: "مهمة العلماء في سياق الاختيار الديمقراطي"، انظر النص الكامل للمحاضرة في الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.edhh.org.
[4] Bormans,Maurice.Statut personnel et famille au Maghreb de 1940 à nos jours Ed.Mouton,Paris,1977.p :558 .
[5] سليم حميمنات: "السياسة الدينية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 1984-2002"، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق أكدال- الرباط، ص: 267.
[6] سليم حميمنات: "السياسة الدينية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 1984-2002"، مرجع سابق، ص: 271.
[7] تقرير اللجنة العلمية حول ما يسمى بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مديرية الشؤون الإسلامية، وثيقة غير منشورة، ماي 1989، ص: 6.
[8] بلاغ المجلس العلمي الأعلى بشأن ما راج حول رفع المملكة لتحفظاتها الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بتوقيع الكاتب العام للمجلس الأعلى محمد يسف، بتاريخ 17 دجنبر 2008، منشور بالموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى على الرابط التالي: www.almajlis-alilmi.org.ma/ar/defails.aspx
[9] بلاغ المجلس العلمي الأعلى بشأن ما راج حول رفع المملكة لتحفظاتها الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مرجع سابق.
[10] انظر: جريدة الوطن الآن الأسبوعية عدد 503، من 24 يناير إلى 31 سنة 2013.
[11] بيان المجلس العلمي الأعلى حول مباركة مشروع الدستور المنشور بجريدة الحياة الأسبوعية عدد 147، 30 يونيو /6 يوليوز2011.
[12] بيان المجلس العلمي الأعلى حول مباركة مشروع الدستور المنشور بجريدة الحياة الأسبوعية، مرجع سابق.
[13] بيان المجلس العلمي الأعلى حول مباركة مشروع الدستور المنشور بجريدة الحياة الأسبوعية، مرجع سابق.