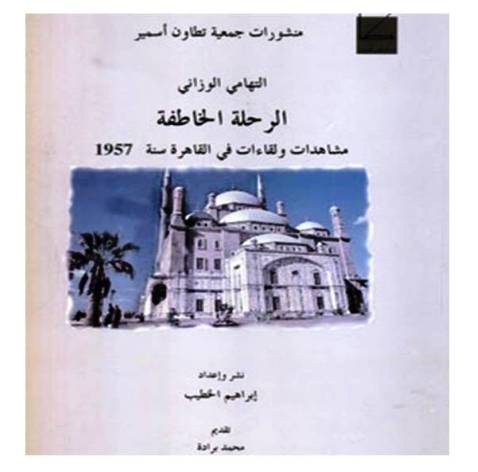
المحتويات
تمهيد
الرحلة التي بين أيدينا “الرحلة الخاطفة؛ مشاهدات ولقاءات في القاهرة سنة 1957” يمكننا أن نصنفها ضمن “أدب الرحلة” بكلّ تأكيد، إلا أنها ليست تجاه “الآخر” الأوربي، وإنما “الآخر” المسلم المنتمي لنفس الدائرة الحضارية الإسلامية[1]، ذلك الآخر الذي يتقاسم معه مغربي منتصف القرن العشرين آمال بناء دولة وطنية حديثة ومستقلّة بذاتها، وتربط بينها وبين محيطها الإقليمي روابط الإسلام والعروبة: أيديولوجية وثقافة.
قبل الشروع في كشف الستار عن هذه السردية الأدبية التي تكتنز ما تكتنز من معلومات تاريخية؛ نشير على مستوى التقني –لكنه مؤثر على المضمون- أن ما وصل إلى يد المحقّق ابراهيم الخطيب من المخطوط كان ينقص منه 79 ورقة (158 صفحة)، مما دفعه إلى إعادة “تركيب النص بنيويا نظرا لوضعية المخطوط الذي كان مبتورا في الأصل”، أمر آخر دعا إلى إعادة التركيب هذه، عدم انضباط الكاتب –صاحب الرحلة- حُيال مبدأ التقديم والتأخير جاعلا من الرحلة نصاً “سائبا”، ولا أبلغ في هذه الحيثية من عبارة صاحب الرحلة التي وصفت هذا التأليف ب”مرقعة المتصوف”[2].
صاحب الرحلة وسياقها التاريخي
ولد التهامي الوزاني بمدينة تطوان 6 صفر عام 1321ه، وكان منشؤه بنفس المدينة، تراوح تكوينه في الفقه والعلوم الشرعية ومبادئ اللغة العربية بين تطوان وقبيلة “واد-راس” مسقط رأس أجداده، اشتغل وكيلا لجمعية الطالب المغربية بتطوان ثم رئيسا لها وكاتبا مساعدا ثم كاتبا عاما للجمعية الخيرية الإسلامية، كما ترأس تحرير جريدتي “الحياة” و”الريف”، ودرّس بعدد من المؤسسات التعليمية الحرّة في عهد الاستعمار الإسباني، وعُيّن نقيبا للشرفاء الوزانيين بالشمال ثم أخيرا تنصّب عمادة كليّة أصول الدين المتفرّعة عن جامعة القرويين.
قام برحلتين إلى الحجاز أدى فيهما فريضة الحج الأولى عام 1376ه/1957م (وهي التي تخلّلتها زيارة القاهرة المدوّنة) والثانية عام 1379ه/1960م.
ألّف الرجل في مجالات مختلفة منها:
- مجال التاريخ: تاريخ المغرب (مطبوع في 3 أجزاء)، وآل نقسيس بتطوان، والمقاومة المسلحة والحركة الوطنية في شمال المغرب، التاريخ العام للطفولة.
- مجال الأدب: الزاوية، سليل الثقلين، رحلة إلى جبل العَلَمْ، والباقة النظرة، بل أبدع أيضا في ترجمة عدد من المؤلفات الإسبانية كمرويكوس، ضون كي خوطي دي لا مانشا.
توفي يوم 15 ذي القعدة عام 1392ه بمسقط رأسه[3].
بدأت رحلة التهامي قادما من تطوان إلى القاهرة عبر مدريد وروما، يوم 18 يونيو وانتهت يوم 7 غشت 1957م، وهي زيارته الأولى لدول المشرق العربي التي لم تطأها رجليه طيلة 54 عاما أي منذ ولادته، بمجرد وصوله إلى “أم الواحات” حصل على تأشيرة للإقامة فيها شهرين، كانت زيارته لمصر في الأصل دعوة من سفير المغرب بمصر وإبن مدينته عبد الخالق الطريس، الذي سهر على ترتيب أسباب إقامته، كما رافق رحالتنا في صولاته وجولاته بالقاهرة طالب مغربي مقيم بالقاهرة محمد مولاطو (1935-2002).
لم ينقل التهامي الوزاني من تفاصيل إقامته بالقاهرة إلاّ أهمها، منتخبا بحصافة أندر الانطباعات التي تسعف في عملية بناء صورة الشرق، حسب محمد برادة لم يكن صاحب الرحلة في القاهرة “مجرد سائح تجتذبه الغرابة وتأسره معالم حضارة عتيقة، بل كان مع كلّ ملاحظة يبديها، مثقفا مندمجا، عضويا، يشعر بالوشائج التي تربطه إلى مصر، وشساعة المسافة التي تفصله عنها” (ص 12).
وصف العمران ومظاهر التحضّر
لا تخلو رحلة من وصف أنواع المعمار وخصائصه، والنص الرحلي الذي بين أيدينا ليس باستثناء، حين يصف القاهرة أو “أم الواحات” بداية من موقعها في المجال إذ تبدو كنقطة صغيرة خصبة وسط الصحراء (ص 64)، وانتهاء بوصف المعمار وفقا لما سمّاه الباحث مخلص الصغير ب“الوصف المقارن”، حين يلجأ الرحالة إلى مقارنة المشهد الذي رحل إليه بمشهد أليف انطلق منه، من قبيل مقارنة مدينة نزل بها الراحل، لأول مرة، بمدينته الأليفة[4] أو بمدن أخرى يألفها فنجده يقارن سعة وبساطة القاهرة مع باقي الحواضر المغربية قائلا: “لو جمعت مدن فاس، ومراكش والدار البيضاء، وجعلت المدن الثلاث مدينة واحدة، لكانت هذه المدينة المثلثة قريبة الشبه من القاهرة” (ص 15).
لم تقتصر المقارنة العُمرانية على الحجم بل تخطّتها إلى استقراء معانيها الاجتماعية والاقتصادية وما تحيل إليه من انتشار ظاهرة الفقر بمصر منتصف القرن العشرين، واصفا تلك البيوت التي يظهر من حالها أن مالكيها ضعاف الحال بالبيوت المتهدمة ونصف متهدمة” فما خلتني إلا في الأحياء الفقيرة في مراكش” (ص 50).
يستطيع القارئ أن يتصوّر معمار القاهرة سنة 1957، بشكل واضح من خلال ما نقله الرحالة المغربي، فتتجلى سمات هذه المدينة في حضور الإرث المعماري الفرعوني سابقا، وفي عراقة المعالم التي خلّفها الفاطميين والمماليك (ص 35)، وفي الجناب الآخر يسطع شعاع العصرنة مجسّدة في العمارات وناطحات السحاب “التي كان أجملها وأضخمها من ملك السعوديين أو الكويتيين” (ص 41).
تحضر باقي معالم القاهرة في متن الرحلة بشكل متفرّق وفي سياقات مختلفة كالأزهر الشريف الذي طابق مهمّته في مصر بمهمّة القرويين بفاس، ورأى في المشهد الحسيني تلك المعلمة التي تمثّل العاطفة الإسلامية فيما يمثّل الأزهر العقلية الإسلامية “ومن زار الحي بعقله لعقله كان عليه أن يبلل عقله بمرطب عاطفي، ومن زاره بعاطفته لعاطفته، لم يستنكف أن يُفرغ هذه العاطفة في قالب المنطق الذي يفيض منهمرا من جنبات القرويين والأزهر” (ص 16)، ووسم القلعة ومسجدها وضريحها بمفخرة من مفاخر الدنيا، فضلا عن زيارته لمسجد السيدة نفيسة (ص 75).
المجتمع والاقتصاد
تكتمل صورة المجتمع المصري بشكل فسيفسائي بين دفتيّ “الرحالة الخاطفة”، مكونات هذا المجتمع لها ميزات التقطتها حصافة الزائر، إذ خلص مما رأى واكتشف أن هبة النيل دولة تزخر بالكفاءات “فما احتاجت مصر رجلا إلا وجدت عشرة لتتخيّر من بينهم أفضلهم” (ص 42)، ولعلّ من المفارقة أن تكون هذه الحسنة التي تعدّ ثروة وأساس لإقامة دولة رائدة واقتصاد قويّ غير مستثمرة ومفرّط فيها، وهو ما يفسّر ملاحظته لما لا يحصى من المتسكعين العاطلين عن العمل في شوارع مصر (ص 21)، ملاحظة تمدنا بمعلومة مزدوجة، ففي الوقت الذي تؤكد عجز حكومة الثورة في مصر عن توفير الشغل للكفاءات العاطلة أو المعطّلة؛ نستشفّ أن هذا الاستغراب “المغربي” ينمّ عن خِفّة هذه الظاهرة في المغرب بحيث لم تتحوّل إلى مشكلة كبيرة بالحجم الذي توجد عليه في مصر على الأقل في أواخر الخمسينيات.
ثقافيا عرّج زائر قاهرة 1957م، على ملامح لطيفة في هذا الجانب، مصوّرا رقيّ المستوى الثقافي للمصريين، فرجل الشارع في القاهرة “أرقى ثقافة من رجل الشارع في كثير من عواصم الغرب”، لكنّ هذا المدح لم يكن مانعا لتنبّه الملاحظ لإشكالية خطيرة عانى منها الإنسان المصري والعربي بشكل عام ولايزال، ألا وهي سؤال العمل، أو الهوة بين الفكر والممارسة، فصرّح بأن هذا المصري”لا يعتني بالناحية التطبيقية من ثقافته أما الرجل الأوربي فإنّه إذا قرأ شيئا عمل به وبادر إلى تطبيقه (…) فعامة الغربيين عمليون أكثر منهم نظريين، والمصري واسع أفق الثقافة ضيق دائرة العمل” (ص 29)، هذا التحليل الفكري يستدعي منا الوقوف معه لنتلافى معطى الفكر كعنصر من عناصر النص الرحلي منتصف القرن العشرين، بحيث تجاوز هذا النوع من الكتابة تقديم المعلومات الكميّة عن الأمكنة، ووصف الظواهر، إلى التعمّق في الإشكاليات الملاحظة على مستوى المجتمع، والدولة التي يقوم بزيارتها، ومن ثمّ تحليلها ومحاولة فهم أسبابها.
داخل دائرة الثقافة وفي باب الفنّ تحديدا، يكشف التهامي الوزاني معرفته العميقة لمصر، وإن كانت هذه زيارته الأولى لمصر، خصوصا في المجال الفكري والفني، إذ كان من أشهر أعيان تطوان ولعًا بالسينما، فلم يفته التلميح لولع وشغف المصريين بالفن سواء السينما أو الموسيقى، سائقا للقارئ مثالا عن هذا الحسّ الفني العام، من خلال الضجّة التي أحدثتها أغنية “يا امّ القمر ع الباب” وما أثارته من نقاش بين الفنانين والأزهريين والتجار والأدباء والعوام (ص 26).
أيضا من الإشارات الهامّة في هذه الرحلة وقفات التهامي الوزاني عند مَعلمة ضريح الحسين بالقاهرة وما يمثّله للمجتمع المصري، فضلا عن العادات والطقوس المعمول بها في هذا المكان ذا النزعة الروحية، وحين كان الواصف شخصيّة تعلّقت بالروحانيات بل بالطرقية منذ صغرها؛ طغى على الوصف ملمح التفلسف والعبارات الصوفية، ويبدو الوصف بهذه الشاكلة في أجلى كماليته حين يصف جوانب المشهد الحسيني وزائريه “العارفين بالله” فيقول:
“ومنهم رجال بأبدانهم وآخرون بأرواحهم، وهم يحدقون بالمشهد –الحسيني- والبعض منهم داخل المسجد والبعض الآخرون خارجه ومنهم الراكعون والثالون، ومنهم عدد كبير من سائقي السيارات وبائعي الأطعمة، وطبقات الشعب من أهل المحبة والشهود” (ص 46).
قاهرة ما بعد ثورة يوليوز 1952م، توزّع مستقرّ فئاتها وتجمعهم حسب توطين صاحب الرحلة بشكل لطيف كالتالي: “العلماء العصريون مركزون في الجامعة، وعلماء العلوم التقليدية مركزون في الأزهر الشريف، والسالكون من الأولياء مركزون في سيدنا الحسين، وأهل الجذب وأصحاب الأحوال مركزون في السيدة زينب، وضباط الجيش مركزون في النادي الحربي..” (ص 47)، إنها خريطة جامعة للفئات الحيّة بالمجتمع القاهري، العناصر التي تصنع صورته وتمنحه بصمته المميّزة.
عموما، استطاع الرحّالة أن يسجّل أبرز ما اختص به المجتمع المصري في هذه المرحلة، بشكل مركّز وفي مواضع متفرّقة من أبواب الرحلة، مُبديا سروره من كرم وفرادة هذا المجتمع “وزائر مصر يلقى من التكريم والتقدير ما لا يلقاه في أي بلد آخر، وما تكاد تتعرّف إلى مصري حتى تجد فيه كلّ أنواع التقدير مالا يلقاه في أي بلد آخر” (ص 76).
معطيات اقتصادية هي الأخرى تتخلل فقرات الرحلة، منها الانتشار الكثيف للمشروبات والمأكولات الباردة نظرا لمناخ القاهرة، كبيع المرطبات وانتشار المعاصر، وكثرة المعصدات (بيع المثلجات) والمقاهي، ناهيك عن المطاعم التي يفوق عددها الحصر (ص 21)، وأثار انتباهه أكشاك الوجبات الجاهزة التي تفتقدها مدينته الأم الصغيرة –تطوان– التي لم يكن حينها قد ارتقى مستوى العيش فيها إلى وتيرة القاهرة المدينة العملاقة، في خضمّ سرده للملاحظات “السوسيواقتصادية” لفتَ إلى أثمنة المنتجات المنخفضة في مصر بالمقارنة مع المغرب على سبيل المثال ثمن قزازة (كوكاكولا) في مصر يساوي نصف ثمنها في المغرب. أيضا من التفاصيل المذكورة في هذا السياق استخدام الدواليب والعجلات لنقل البضائع والأشخاص (ص 25)، كما استرعت انتباه السارد مهنة نادرة وغير موجودة بالمغرب، هي “حافظ النعال بأبواب المساجد” وتقتصر مهمة هذا الأخير في العسّ على نعال وأحذية المصلين حين أدائهم الشاعرة مقابل بقشيش (ص 50).
مصر بعد ثورة الضباط الأحرار بعين التهامي الوزاني
كيف وجد زائر القاهرة القادم من المغرب الأقصى مصر بعد ثورة الضباط الأحرار (23 يوليو 1952م)؟ وهو الآتي من بلد حصل لتوّه على الاستقلال، ويتطلّع مع غيره من الذين عايشوا أيام الاستعمار إلى وطن حرّ ودولة حديثة قويّة ويتأمّل وحدة عربية-إسلامية يسودها التعاون لتحقيق ما كان ينظّر إليه أيام كانت المنطقة تحت وطأة الاستعمار بأشكاله المختلفة (حماية-انتداب-استعمار عسكري).
أول ما يُلحظ في وصف الزائر لمصر هذه الحقبة –أواخر الخمسينيات- التفاؤل، والاستبشار ب”العهد الجديد” حيث خلص مما رأى وسمع أن حالة مصر تحسّنت شيئا ما عن حالتها قبل الثورة (ص 22)، ويبرز –التفاؤل- في حديثه عن الإصلاحات على مستوى البنية التحتية أيام الجمهورية، بداية بالمجمع عادّا إياه من “الإصلاحات الهامة في عهد الثورة (…) ولعمري إن هذه المؤسسة لمما يحق لحكومة الثورة أن تفخر بها” (ص 17-19)، وانتهاء بالكورنيش، ودائرة التحرير، وأطلق على هذه المعالم “الثالوث” العظيم في مظاهره، وفي تأدية واجبه.
لم تكن إصلاحات البنية التحتية هي التغيير الوحيد الذي جاءت به حكومة الثورة في نظر التهامي الوزاني، بل هناك إصلاحات اقتصادية وسياسية في غاية الأهمية، فأما الأولى فظهرت في القيود التي وضعتها حكومة عبد الناصر على حركات وسكنات واتصالات التجار الأجانب “من الجهة المعادية”، وفي المقابل اتخذ المصريون قرارا إداريا حاسما كان له أثر كبير في المستقبل على الإدارة والاقتصاد، وهو تعريب المعاملات الإدارية والاقتصادية، وعبّر التهامي الوزاني عن ذلك بلسان الشاهد على العصر “وقد تعرّب كل شيء في مصر، حتى البنوك والمصالح الكبرى” (ص 41-42).
وأما الثانية –الإصلاحات السياسية والتدابير العسكرية- طبع إيرادها في نصّ الرحلة الميول إلى تحليل الظرفية السياسية، وما واكبها من تحولات على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيبرز الوجه الآخر لصاحب التأليف الذي يمتلك الخبرة السياسية المُرَاكَمَةِ سنوات النضال الوطني، فالتقط مما التقط من المعطيات مسألة الرفع من منسوب التجنيد والتسابق نحو التسلح، وأرجع سبب ذلك إلى الصراع مع “إسرائيل”، ونتيجة للعدوان الثلاثي على مصر عقب قرار تأميم قناة السويس: “كما ينبغي أن نعلم أن مؤسسة الجيش القديمة اختلّ معظمها أثناء مقاومة العدوان الثلاثي (…) وجهد الحكومة في تعويض تلك الخسائر عن طريق التجنيد وجلب السلاح من الاتحاد السوفياتي” (ص 55-56).
ولمّا كان الظرف السياسي شديد التوتر والخطورة أفرز مواقف عربيّة متباينة على الصعيد الرسمي، فتوجهت -بتعبير الواصف- العراق “شطر الغربيين العراق”، وبقيت لبنان “واقفة موقف الحائر المتذبذب” وكذلك كان الأردن “قبل أن تسلم قيادها للغرب” ولم يبق في صف مصر إلاّ سوريا (ص 42).
لكنّ التحمّس لبعض المواقف السياسية جعل المعاين للوضع السياسي عن قرب يهوي في فخّ السياق التاريخي، فجرفه إلى السطحيّة أو المثالية آن وصفه للمؤازرة السوفياتية لمصر ب”السمو الخلقي” الذي لم تعتد الأمم العربية والإسلامية من الدول القوية أن تكون على مثله (ص 57)، ولأن التهامي الوزاني كان منغمسا في أتون الظرفيّة مُغِيِّبا أو غير واعٍ بالصراع بين محوري الغرب والشرق، والاصطفافات الدولية الناتجة عنه، فكان التأويل أو الحكم القيمي الذي خلص إليه تجسيد لوطأة اللحظة التاريخية التي تسوق الإنسان بشكل عام إلى تجاهل الحسابات الواقعية المبنية على المصالح وما تتطلبه من التريث وأخذ الأمور بتعقيداتها، لصالح خفّة التفسير الذي يتماشى مع التفاعل اللحظي المتأثّر بذهنية الظرفية.
مقابل صورة الإصلاحات والتغيير الذي رسمه الرحالة عن حكومة الثورة قدّم الجانب الآخر لسياساتها الداخلية وإن بشكل مضمر، وذلك بالتعرّض للمحاكمات العسكرية التي استهدفت بعض من الفاعلين داخل فئة طلبة الجامعات المصرية، بعد أن اضطرب شأن هذه الأخيرة ذات مرة، “فحكمت الثورة على المهيجين منهم –وهم الأغلبية- بأن يساقوا إلى معسكرات الجيش، وأن تطبّق عليهم الأحكام التي تطبق على الجنود” (ص 27-28)، كما تحدث عن بطش الحكومة بفئة من الإخوان المسلمين اتهمت بالدعوة إلى العنف (ص 62).
إجمالا كانت قراءة الرحالة المعاصر لحالة مصر بعد ثورة الضباط الأحرار أميل إلى الإيجابية منها إلى السلبية، فعدّ جمال عبد الناصر ممثلا لروح الشعب المصري (ص 41)، وقدّم مبررا يبدو أشبه بقاعدة تاريخية تمرّ منها غالبية البلدان بعد قيام ثورة أو حركة تغييرية جذريّة، قائلا:”وإن الآصار التي خلّفتها لنا الأجيال المتعاقبة، لا يمكن أن تمحوها الثورة في خمسة أعوام” (ص 22)، وقد كانت هذه العبارة دقيقة وملخّصة لما كانت عليه مصر بعد ثورة الضباط.
حوار بين رموز النضال الوطني المغربي حول قضايا المغرب المستقل
ورد في هذه المحطة من الرحلة نقاشات وآراء ثرّة حول مغرب ما بعد الاستقلال، تضيء جوانب من التاريخ الاجتماعي والسياسي، وتحمل انطباعات وتطلعات ثلاثة من أهم رجالات الحركة الوطنية هم: محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي كان يقيم في القاهرة بشكل اضطراري منذ أواخر الأربعينيات، وعبد الخالق الطريس سفير المغرب في الجمهورية المصرية، وزائر القاهرة التهامي الوزاني.
تركّز حوار الثلاثة الذي دام ساعتين حول مسائل: وضعية المرأة المغربية بُعيد الاستقلال في علاقتها مع مفهوم الحرية، وانساق الحديث نحو مدارسة أوضاع المغرب السياسية بُعيد الاستقلال بحكم مكانة الشخصيات ودورها الاعتباري في تحرّر المغرب وحصوله على الاستقلال، كما وردت في طيّات الحديث معلومات عن عزم الخطابي على العودة إلى المغرب.
يستهلّ زائر القاهرة حديثه عن هذا اللقاء باعتراف إنساني مفعم بروح الوطنية التوافقي، معترفا بمساهمات زعيم المقاومة الريفية في سيرورة النضال الوطني المغربي مع الاحتفاظ لنفسه بحق الاختلاف الذي لا يفسد للود والتقدير قضيّة:
“لبن عبد الكريم شيعة وخصوم، وهو البطل سواء عند أنصاره أو خصومه (…) ولقد زرناه حين زرناه لنرى البطولة، وليس من اللازم أن نقدم لكل بطل قربانا من مبادئنا ولا أن ننسى معه شخصيتنا، بل الأمر على العكس” (ص 30).
أثار الوضع الجديد للمرأة المغربية بعد التحولات الاجتماعية التي حدثت أثناء الحماية وبُعيد الاستقلال نقاشا عميقا بين الحاضرين، حيث رأى الخطابي أن تطور الحالة الاجتماعية يتجه اتجاه التفرنج الجامح بما فيه الانحلال والاستهتار، وعدّ سفور المرأة في المدينة مؤشرا على ذلك، مبديا معارضته لهذا السلوك (ص 30)، ثم يعرض ناقل الحديث رأي عبد الخالق الطريس الذي يبدو مستفيضا، فالطريس يقارب ظاهرة سفور المرأة في المدينة من منظور أوسع، معتبرا أن”ما يعده رجال الأمس مجاوزة للحدود، لا يرى فيها الشبان إلا حقا طبيعيا يجب أن تتمتع به المرأة” لأن السياق الاجتماعي الذي طفحت فيه الظاهرة إلى الواجهة معقد، تشتبك فيه تأثيرات الاستعمار مع موجة التحرّر التي انطلقت في العالم الغربي وعمّت مناطق نفوذه، ناهيك عن أزمة الثقة في الثقافة المحليّة التي خلّفها التواجد الاستعماري، إذ بدت الركائز -الثقافية والاقتصادية والتقنية والسياسية- التي تأسست عليها الدول المستعمِرة نموذجا لتحقيق النهضة أو التقدم والمدلولات التاريخية لهذين الاصطلاحين في سياق ما بعد الاستقلال، لعلّ ذلك ما أُضمر في عبارة السفير المغربي لوصف هذا التحوّل ب”ثورة نفسية لا يمكن مقاومتها”، وعليه يكون من الأنجع –في رأي الطريس– أمام هذه الثورة النفسية “ترك بعض المنافذ مفتوحة لصرف فيضان الثورة” (ص 30-31)، ولكن الدولة لا ينبغي أن تبقى مكتوفة اليدين أمام هذا الاختراق الثقافي الحاد، لذلك كان من رأيه أن واجب الدولة المغربية يكمن في إعداد “أمة لنشر حقائق الإسلام التي يكون لها الأثر في ترقية المستوى الخلقي والاجتماعي لمسلمي المغرب” (ص 31).
ما كان هذا حوار من هذا المستوى وفي خضم حيثيات الاستقلال أن يمرّ على الحالة السياسية للمغرب مرور الكرام، إذ صرّح محمد بن عبد الكريم الخطابي للحاضرين بموقفه تجاه تواجد الجيش الفرنسي بالمغرب، وقال بأن الأخير لا يعتبر مستقلا إلا بانسحاب القوات العسكرية والأطر الإدارية الأجنبية منه، “فما دام الجيش الفرنسي مقيما بالبلاد، والمديرون الفرنسيون متولين للوظائف الحيوية، ولغة الدواوين أجنبية، فمن واجب المغرب أن يبقى في حالة حرب مع الفرنسيين” (ص 32)، لابد أن يفهم موقفه هذا في سياق دعم سعي الجزائر للتحرّر، وقبل ذلك التحرّر الفعلي والكامل للوطن (المغرب الأقصى).
كان قائد المقاومة الريفية يدفع في اتجاه التحرّر الكامل لبلاد المغارب، رافضا اجتزاء “الصحراء المتممة للمغرب” وخلق دولة جديدة تحت اسم موريطانيا (ص 32)، وفي هذا الإطار كان يتحسّر وهو يراقب طغيان الحزبية على الوطنية، فالأولى –الحزبية- ترمز إلى الهيئات السياسية التي قبلت بالطريقة التي تمّ بها منح الاستقلال للمغرب، فيما الثانية –الوطنية- ترمز إلى المقاومة متمثلة عينيا في قوات جيش التحرير، مرددا: “ستعلم الأحزاب المغربية أنها كانت مخطئة حين انحنت أمام الاستعمار، مع أن الشعب كان وما يزال يحمل من روح الثورة ما يكفيه لمجابهة رواسبه وبقاياه” (ص 33)، ولعلّه عتاب غير مباشر للحاضرين الذين كانوا رموزا للطيف السياسي الذي ارتأى التفاوض والطريق الدبلوماسي لتحقيق الاستقلال.
استهلّ الطريس تجاوبه مع ما جاء على لسان بن عبد الكريم الخطابي بتعبير توافقي يجمع بين رفض الاستعمار ويدعو إلى سلوك الطريق السياسي للتخلص منه: “لو طال الاستعمار بشمال إفريقيا أكثر مما طال لانقرض المغاربة وخلفهم جبل من متشردي الأوربيين المتفرنسين” (ص 33)، واضعا في الاعتبار قوة الرأي العام الدولي؛ ما ينمّ عن ارتقاء مستوى الفكر السياسي عند الرجل وتطوره منذ أواسط الأربعينيات، رابطا بين حفظ مصالح فرنسا في المغرب والرأي العام الدولي الذي يتحوّل بتحوّل وضعية مصالح المستعمر السابق في المغرب.
في نهاية هذا اللقاء عبّر محمد بن عبد الكريم الخطابي عن إرادة العودة إلى الوطن، وطلب من السفير التوسط لدى الملك محمد الخامس ليتم ذلك: “كم بودي أن أعود إلى بلادي ومسقط رأسي، وكنت آليت على نفسي ألا أعود إلى المغرب إلا بعد أن يتمّ استقلاله أرجو أن يكون رجوعي إلى المغرب قريبا بواسطتكم يا سعادة السفير (…) وأن تعملوا مع صاحب الجلالة حتى أرجع إلى وطني”، لكن للأسف لم يتم هذا الأمر وبقي هذا المقاوم مقيما في القاهرة حتى توفي ودفن بها (ص 34-35).
في تجاوز القطرية.. الوشائج الجامعة بين العرب والمسلمين
يمثّل التهامي الوزاني في نظرته لمصر وشعبها امتداد لروح التآخي والتكامل النابع من رابطة الدين (الإسلام) واللغة (العربية)، لم تتقطّع هذه الصلة بتقطيع المجال العربي والإسلامي إلى دول قطرية عقب الاستقلال، واستطاع الوطنيون أن يمازجوا ويوافقوا بين الروح الوطنية والانتماء إلى أمة العرب والمسلمين، فلم تكن قوميّة مجرّدة من الدين ولا انتماء ديني مخلّص من الروابط الثقافية الجامعة بين العرب. عطفا على ما سبق نجد زائر مصر يبيّن كيف أن شعب الأخيرة ربما هو أقرب إليه من حيث التفاهم عن بعض “الجماعات” في أرض الوطن (ص 24).
يتطرّق الرحالة في هذا الباب إلى فكرة مهمّة ما تزال متداولة إلى حد الساعة خصوصا في مجال التنظير الجيوسياسي، وهي مركزية مصر في العالم العربي، إذ هو الآخر اعتبر في أواخر الخمسينيات أن “العرب يتتبعون حركاتها [مصر] وسكناتها، حتى لو جحدت ذلك الألسن” (ص 29)، وبالتالي فإن “كل شيء يفيد مصر، فإنه فائدة للعرب كلهم، وللمسلمين في سائر أطراف الدنيا” (ص 18). بطبيعة الحال كان هذا السياق مدعاة للتصريح بضرورة التعاون بين البلدان العربية والإسلامية، وتذكير بما أسماه واجب المغاربة “نحو هذا الشرق البئيس الذي يصل به الفقر حدا تعجز الحكومات عن مقاومته” (ص 34 و35) ، وهذه الدعوة وإن كانت محمودة وتحمل قيما نبيلة إلاّ أن سياقها يتضمن دلائل التناقض الذي يشوبها، فوصفه للشرق بأنه بئيس مرفقا بدعوة لإعانته؛ يعني بالضرورة أن المغرب أفضل وأحسن حالا من جهة المال والاقتصاد!
الحقيقة أن ما ذكره من استقبال مصر للطلبة المغاربة الذين يأتون إما بغرض الدراسة أو فرارا من نير الاستعمار، وتشييد الجامعة العربية مقرا لطلبة الشمال الإفريقي وتقديم مساعدات مالية لبعضهم (ص 67 و68)، كان بسبب غياب قدرة الدولة المغربية على التكفل بهؤلاء الطلبة، ولاشك أنه كان يشكل دَينا معنويا ورمزيا على المغرب أن يردّه حين تحسّنت الظروف، وإلا يصعب فهم دعوة التهامي الوزاني في غير هذا الإطار حيث تسود الرغبة في تعاون هذه الدول وتكاملها بالنظر إلى الوشائج التي سبق ذكرها.
تكتمل نظرتنا للطريقة التي فهم بها الرحالة معادلة العلاقة بين المغاربة والمصريين، حين أدرك أن ليس كلّ ما في القاهرة يشبه ما يوجد في المغرب، وتظهر هذه الاختلافات في التفاصيل الصغيرة والطريفة في نفس الآن، وندع له مساحة التعبير عن الفكرة:
“وأدركنا خطأنا عندما حسبنا أن القاهرة بلدنا، وأن كل شيء فيها مفهوم لدينا ما دامت عربية مسلمة، ونسينا الفوارق الإقليمية. وإن كنا أخطأنا في تناول شراب حسبناه حلو فإذا به حرّ، فلن يكون هذا هو الخطأ الأخير” (ص 67).
الخاتمة
للرحلة المعاصرة هوية تميّزها عما قبلها من الرحلات، وقد عكس متن “الرحلة الخاطفة” خصائص هذه الهوية من قبيل السرد المستبطن للتحليل وغلبة العقلانية على الانطباع، ناهيك عن تقليص مساحات الوصف لصالح إبداء الرأي، نتيجة للتقدم التقني الذي أتاح للبشرية نقل المشاهد الطبيعية والعمرانية بكيفية تعفي البيان من هذه الوظيفة ليتفرّغ لما هو أهمّ.
مناسبة تدوين أحداث ومشاهدات رحلته إلى القاهرة سنة 1957م، أتاحت للتهامي الوزاني فرصة مواتية ليقدم رؤيته للشرق، وليبيّن مواقفه من الأحداث التي شهدها ذلك العقد، كما سنحت له تضمين بعض القصص والقضايا المتعلقة بالحياة الاجتماعية خلال عهد الحماية الإسبانية، إذ خرج عن سياق الرحلة وعاد يحكي باستفاضة عن عهد الباشا محمد أشعاش[5]، وما خاضه مع الأخير من تجاذبات حول قضية السينما، مظهرا حيثيات اللقاءات الأولى مع السينما والمسرح، وكيف أمسى هذا الضيف الغريب/الجديد فضاء للترويح عن النفس بالنسبة للمغاربة نساء ورجالا.
القاهرة سنة 1957م، بعين التهامي الوزاني بدت منطلقة نحو عهد جديد بعد الثورة، محافظة على هويتها الإسلامية وقوميتها العربية، وفي حاجة إلى التئام العرب سياسيا، ويبدو أنّ أسرار القاهرة أعيت وصف الرحالة، ضاقت القراطيس عن احتواء ما رآه في المدينة.
“وأنّى لي أن أصف القاهرة متظاهرا بأني أدركت أسرارها” (ص 71).
المراجع
[1] مصطفى الغاشي، الرحلة المغربية والشرق العثماني؛ محاولة في بناء الصورة، الانتشار العربي، الطبعة الأولى، 2015، ص 19.[2] التهامي الوزاني، الرحلة الخاطفة؛ مشاهدات ولقاءات في القاهرة سنة 1957، تحقيق إبراهيم الخطيب، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الطبعة الأولى، 2014، ص 13.
[3] محمد بن الفاطمي، إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلّة من علماء المغرب المعاصرين، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1992، ص 77-79.
[4] مخلص الصغير، "التهامي الوزاني والرحلة من المغرب إلى مصر"، العرب، 27/07/2014، https://alarab.co.uk/
[5] أنظر: مادة محمد أشعاش، معلمة المغرب، ج2، ص، 463.





















