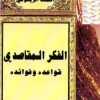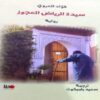المحتويات
مقدمة
تعد مدينة آسفي من أقدم الحواضر المغربية التي ارتبطت مسيرتها بالتاريخ العام للمغرب. فقد تعاقبت عليها حضارات متعددة منذ العصور القديمة، حيث عرفت مرور الفينيقيين ثم القرطاجيين، وظلت في تواصل تجاري مع الرومان. قبل أن تعرف حضورا برتغاليا ترك بصماته في معالمها. ومع بروز الدولة السعدية وما تلاها من العهد العلوي، دخلت المدينة مرحلة جديدة اتسمت باندماجها في المشروع السياسي والاقتصادي للمغرب.
لقد شكل موقعها على الساحل الأطلسي عامل جذب للتجار والمستوطنين، وجعلها عرضة لأطماع القوى الخارجية، فكانت على الدوام ساحة للتفاعل بين الداخل المغربي والعالم الخارجي. ومن خلال هذا المسار التاريخي الطويل، برزت آسفي كمدينة لها دور استراتيجي في الدفاع عن السواحل المغربية، وفي الوقت نفسه كجسر للتبادل التجاري والثقافي عبر العصور.
آسفي.. التسمية والنشأة
تعد آسفي من أقدم مدن المغرب وأكثرها عراقة، ولذلك اختلف المؤرخون والباحثون حول أصل تسميتها. فبعضهم يرجع الاسم إلى الأصل الفينيقي “أسفا” الذي يعني الميناء أو المصب، انسجاما مع موقعها على الساحل الأطلسي وصلتها المبكرة بالملاحة والتجارة.
ويرى آخرون أن التسمية أمازيغية الجذور، مشتقة من كلمة “أسفّو” التي تفيد المجرى أو الوادي. بينما تداولت الذاكرة الشعبية تفسيرا عربيا ربط الاسم بكلمة “الأسف”، استنادا إلى قصة منسوبة لأحد الوافدين الذي قال: “آسَفي على ما أصابني”، فغلبت العبارة على المكان.
وقد أطلق البرتغاليون خلال احتلالهم للمدينة في القرن السادس عشر الميلادي اسم “Safim”، وهو تحوير للاسم القديم. وهكذا ظل أصل التسمية موضوع تعدد في القراءات، غير أن الأرجح أنه يرتبط بدور المدينة التاريخي كميناء ومصب منذ العصور السحيقة.
آسفي.. المسار التاريخي:
تعاقبت على مدينة آسفي حضارات متعددة تركت بصماتها في مسارها التاريخي؛ بدءا من مرور الفينيقيين والقرطاجيين، إلى العصور الإسلامية، فالمرابطين والموحدين، ثم الاحتلال البرتغالي والعهد السعدي، فالدولة العلوية، وصولا إلى مرحلة الحماية والاستعمار الفرنسي وما تلاه من تحولات بعد الاستقلال.
آسفي في العصر الفينيقي:
لقد شكلت آسفي محطة ساحلية بارزة منذ العصور القديمة، حيث اتخذها الفينيقيون والقرطاجيون موطئ قدم على الساحل الأطلسي، وأقاموا بها مراكز تجارية ساعدتهم على الانفتاح على الداخل المغربي وربط شمال إفريقيا بالطرق البحرية المتوسطية والأطلسية.[1]
ولم يكن اختيارهم لآسفي اعتباطيا، بل بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومينائها الطبيعي الذي وفر لهم ملاذا آمنا للسفن، ونقطة انطلاق لتبادل المعادن والمنتجات البحرية. وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن المدينة كانت تؤدي دور الوسيط بين الموارد الداخلية للمغرب وبين الشبكات التجارية العابرة للبحر، مما جعلها إحدى أهم المحطات في التاريخ البحري القديم.[2]
وهكذا، تبرز مكانة آسفي منذ البدايات الأولى كمركز للتبادل والتواصل، قبل أن تتطور لاحقا إلى مدينة ذات حضور سياسي واقتصادي بارز عبر العصور.
المرحلة الإسلامية المبكرة لمدينة آسفي:
بعد الفتح الإسلامي للمغرب، عرفت آسفي استقرار المسلمين ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي، وهو ما منحها بعدًا حضاريًا جديدًا ضمن شبكة الحواضر الساحلية المغربية. وفي القرن الثالث عشر تحولت إلى رباط؛ أي مركز ديني وعسكري محصن، جعل منها نقطة تماس بين البحر والداخل المغربي، ومجالا لعبور التجار والرحالة.
وقد ساعد موقعها البحري على تعزيز مكانتها كمحطة للتبادل مع الأندلس، خاصة في السلع التي اشتهر بها المغرب كالمعادن والزيوت والجلود، مما رسخ دورها التجاري والحضاري عبر العصور.[3]
آسفي في الفترة المرابطية والموحدية والمرينية:
مع صعود المرابطين ثم الموحدين، برزت مدينة آسفي كأحد الموانئ الأطلسية ذات الأهمية الإستراتيجية، حيث جرى تحصينها بأسوار وبناء مرافق دفاعية لحماية الميناء من الأخطار البحرية. وقد تحولت خلال هذه الفترة إلى رباط محصن وإلى محطة تجارية تربط المغرب بالأندلس وإفريقيا جنوب الصحراء، مما ساعد على نموها العمراني واتساع عمرانها. وقد أكد محمد المنوني أن التحولات العمرانية التي شهدتها المدن الساحلية، ومنها آسفي، في العصرين المرابطي والموحدي ارتبطت مباشرة بازدهار التجارة البحرية.[4]
وقد بدأت مدينة آسفي تعرف حركية متزايدة ابتداء من القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، حيث أولى الموحدون عناية خاصة بها، فقاموا بتشييد سور يحيط بالمدينة. ويرجح أن يكون الخليفة يعقوب المنصور هو الذي تولى هذا العمل، نظرا لاشتهاره بإنشاء التحصينات وتخليد الآثار في مختلف أرجاء الدولة. وقد بقيت بعض بقايا هذا السور شاخصة إلى بداية القرن العشرين، كما يشهد على ذلك المؤرخ الكانوني.[5]
وفي العصر المريني حظيت مدينة آسفي باهتمام ملحوظ، إذ شيدت فيها مدرسة ومارستان، وأقيمت دور فسيحة محصنة وقصور تعكس مظاهر العمران والتمدن. وقد دفع هذا الازدهار المؤرخ ابن خلدون إلى أن يصفها في القرن الثامن الهجري بـ”حاضرة البحر المحيط”، وهو وصف يبرز المكانة التي بلغتها المدينة في اتساع عمرانها ورقي حضارتها. ولم يقتصر نشاطها آنذاك على التجارة والعمران فحسب، بل شمل أيضا الفلاحة وبعض الحرف التقليدية، وفي مقدمتها صناعة النسيج وحياكة الصوف.
قال في وصفها ابن الخطيب: “لطف خفي وجناب حفي ووعد وفي ودين ظاهره مالكي وباطنه حنفي الدماثة والجمال والصبر والاحتمال والزهد والمال والجمال والسذاجة والجلال قليلة الإخوان صابرة على الاختزان وافية المكيال والميزان رافعة اللواء بصحة الهواء بلد موصوف برفيع ثياب الصوف وبه تربة الشيخ أبي محمد صالح وهو خاتمة المراحل المسورات من ذلك الساحل، لكن ماءه قليل وعزيزه لعادية من يواليه من الأعراب ذليل”.[6]
لقد عاشت مدينة آسفي فترة من الرفاهية والازدهار في عهد الموحدين، ثم واصلت هذا المسار خلال العصر المريني. غير أن أواخر الدولة المرينية شهدت ضعفا متزايدا، إذ استبد الوزراء الوطاسيون بمقاليد الحكم، وفقد المغرب آنذاك كثيرا من هيبته وقوته. وقد فتح هذا الوهن الداخلي الباب أمام الأطماع الخارجية، فجعل عددا من مدن المغرب عرضة للغزو، لتسقط المدينة بسهولة في أيدي البرتغاليين الذين استغلوا الوضع، وفرضوا سيطرتهم على بعض الموانئ والمراكز الكبرى، وكانت مدينة آسفي من بين الحواضر التي خضعت لقبضتهم.
آسفي بين الاحتلال البرتغالي والعصر السعدي:
شهدت مدينة آسفي تحولات عميقة مطلع القرن السادس عشر، حيث ذكرت المصادر التاريخية أنها سقطت في قبضة البرتغاليين سنة 1508م في ظل ضعف الدولة الوطاسية. وقد جعل المحتلون من الميناء قاعدة تجارية وعسكرية، وأقاموا به حصنا ما تزال معالمه بارزة فيما يعرف اليوم بـ”قصر البحر”.
وقد حمل الاحتلال البرتغالي معه صورا من القسوة والاستبداد، تركت جروحا غائرة في ذاكرة أهلها. فقد ارتبطت هذه المرحلة بممارسات مهينة للكرامة الإنسانية، من تخريب للمعالم الدينية والعلمية، إلى امتهان لحرمات الناس وحرية الأفراد. ويصف الكانوني تلك الحقبة بقوله: “لما بسط البرتغاليون نفوذهم على آسفي، عاملوها أسوء معاملة وأذاقوا من بها ألوان النكال والعذاب مما يخجل منه جبين الإنسانية، فخربوا المعاهد الدينية والعلمية، ومنها ما جعلوه محلاً للقاذورات كالمسجد الكبير، وعبثوا بالمحارم واستحلوا التجارة في الأحرار فكانوا يبيعونهم جهارا وسفكوا الدماء ونهبوا المال وخربوا الدور”.[7]
واستمر الوجود البرتغالي بالمدينة إلى حدود سنة 1541م، (33 سنة) حين بسط السعديون سيطرتهم عليها في إطار مشروعهم الكبير لتحرير الموانئ الأطلسية، بعد انتصارهم في معركة تحرير أغادير (Santa Cruz) في العام نفسه. وبذلك دخلت آسفي مرحلة جديدة في ظل الدولة السعدية، التي أعادت إليها دورها التجاري والبحري، وربطتها أكثر بمشروع الدولة المركزي في الجنوب والشمال.
آسفي في العصر العلوي:
حظيت مدينة آسفي بمكانة معتبرة في ظل الدولة العلوية، إذ تميزت هذه المرحلة التاريخية بمرحلة ازدهار عمراني وديني وعلمي، ساهم في ترسيخ حضور المدينة بين الحواضر المغربية الكبرى. ولم يكن هذا الازدهار وليد الصدفة، بل جاء ثمرة اهتمام الدولة ورجالاتها، الذين أولوا للمدينة عناية شاملة شملت مختلف المرافق، من معاهد ومساجد وأبراج وأوقاف. وقد سجل المؤرخ محمد الكانوني وصفا دقيقا لهذا التطور، حيث يقول: “اتسعت عمارة آسفي في الدولة العلوية خلد الله ملكها وتناولتها عدة إصلاحات وزيادات وشيدت به معاهد دينية وعلمية وعمرانية وخصوصا صدر القرن الثالث عشر الهجري في رئاسة القائد عبد الرحمن بن ناصر العبدي المتوفى سنة 1214هـ فإنه اعتنى به عناية كبرى من جميع مناحي حياته وخلد به الآثار الجليلة من مساجد وأبراج وأوقاف وغير ذلك”.[8]
آسفي في عهد الحماية والاستعمار الفرنسي:
بعد فرض الحماية الفرنسية سنة 1912م (بموجب معاهدة فاس في 30 مارس 1912م)، دخلت مدينة آسفي مرحلة تحول عميق في بنيتها الاقتصادية والعمرانية. فقد منحت شركة Compagnie Marocaine (التي تأسست عام 1902م) بموجب معاهدة ألخيسراس (1906م) مهمة بناء ميناء حديث في آسفي، إلى جانب ميناء الدار البيضاء. وتظهر الدراسات الجيومورفولوجية أن أعمال التوسعة المرفئية في الخليج – والتي بدأت في حوالي عام 1906 – أثرت بشكل كبير في التطور البنيوي لآسفي وأدّت إلى تغيّرات في قيعان الخليج ورواسبه.[9]
بفضل هذا المشروع، تحول الميناء إلى ركيزة أساسية في تصدير منتجات المغرب، وعلى رأسها الفوسفاط الذي ازداد الطلب العالمي عليه بعد اكتشاف مناجم خريبكة، بالإضافة إلى منتجات الخزف والصيد البحري.
وتشير دراسات حديثة إلى أن الموانئ الأطلسية، ومنها ميناء آسفي، قد أُعيد تنظيمها بشكل يضمن ربطها المباشر بالأسواق الأوروبية، وهو ما جعلها جزء من بنية اقتصادية استعمارية تقوم على التبعية والتصدير.
ولم يقتصر تأثير الحماية على الجانب الاقتصادي، بل شمل أيضا المجال العمراني والاجتماعي. فقد توسعت الأحياء السكنية الجديدة حول الميناء لاستيعاب اليد العاملة والموظفين الفرنسيين، كما أدخلت أنماط معمارية حديثة غيرت ملامح المدينة التقليدية. وتوضح بعض الدراسات أن هذا “التحديث” المرفئي والعمراني كان في جوهره استجابة لحاجيات الاستعمار أكثر من كونه مشروعًا تنمويًا للمدينة وسكانها.[10]
وهكذا؛ شكلت فترة الحماية الفرنسية منعطفا بارزا في تاريخ آسفي؛ فقد أعادت رسم معالمها الاقتصادية والعمرانية، لكنها في الوقت نفسه كرست ارتباطها بالاقتصاد الاستعماري، وهو ما جعل آثارها تستمر حتى ما بعد الاستقلال.
آسفي بعد استقلال المغرب:
بعد استقلال المغرب سنة 1956، واصلت مدينة آسفي أداء دورها كأحد أبرز موانئ الصيد البحري، خصوصا في صيد سمك السردين، إذ أصبحت من أهم المراكز الوطنية التي تزوّد السوق المحلي والدولي بهذه الثروة البحرية. وقد أظهرت الدراسات العلمية التي أنجزها باحثون في علوم المحيطات أن مصايد السردين على الساحل الأطلسي لآسفي تتميز بدينامية بيولوجية غنية، ما يجعلها أحد الأعمدة الرئيسة للصيد البحري بالمغرب.[11]
وقد كشفت دراسة ميدانية أنجزت في الفترة ما بين 2018 و2019 حول النمو البيولوجي للسردين (Sardina pilchardus) والأنشوفة (Engraulis encrasicolus) بسواحل آسفي، أن المنطقة تتميز بمخزون سمكي متجدد وذي خصائص مستقرة تدعم استدامة نشاط الصيد. وقد اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تحليل العينات السمكية من حيث العمر، والنمو، والتكاثر، وأظهرت النتائج أن المصايد المحلية تعد من بين الأكثر إنتاجية على الساحل الأطلسي المغربي، مما يعزز مكانة آسفي كمركز وطني رائد في قطاع الصيد البحري.[12]
إلى جانب ذلك؛ تطورت صناعات الخزف والفخار بشكل ملحوظ، وباتت المدينة تعرف بـ”عاصمة الخزف“، بعدما شهد حي “تل الفخّار” (Colline des Potiers) نهضة حقيقية منذ أواخر القرن التاسع عشر؛ حيث يعد هذا الحي اليوم أحد أبرز الأحواض الحرفية التي لا تزال تحتفظ بطابعها التقليدي الراسخ.
وعلى الصعيد العمراني، توسعت آسفي سكانيا ومعماريا بشكل متسارع منذ الاستقلال، فبرزت أحياء جديدة ومناطق صناعية، غير أن هذا النمو لم يكن متوازنا دائما، إذ رافقته تحديات تنموية في مجالات البنية التحتية، السكن، والتخطيط الحضري. ومع ذلك، ظلت روح المدينة الحضارية متأصلة في موروثها البحري والحرفي؛ فهي ما تزال تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز موانئ الصيد بالمغرب، خصوصا في مجال السردين، إلى جانب استمرار شهرتها كعاصمة للخزف والفخار.
واليوم، نرى مدينة آسفي وهي تجمع بين العراقة والتحديث؛ فهي من جهة مرآة لذاكرة حضارية عريقة تمتد من الفينيقيين إلى الدولة العلوية، ومن جهة أخرى فضاء معاصر يسعى إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب الحديث. غير أن هذه الهوية المزدوجة تكشف أيضا عن واقع متناقض؛ فالمدينة تحمل إرثا غنيا، لكنها ما زالت تصارع لإيجاد موقع أكثر رسوخا في خريطة التنمية الوطنية.
خاتمة
منذ أن وطئت أقدام الفينيقيين السواحل الأطلسية، كانت آسفي نافذة على البحر وملتقى للتجارة والتبادل، ثم واصلت دورها في العصور الإسلامية الأولى حيث برزت كميناء يربط المغرب بالأندلس.
وفي عصر المرابطين والموحدين ازدادت أهميتها الاستراتيجية، قبل أن تعرف محنة الاحتلال البرتغالي الذي لم يدم طويلا، لتستعيدها الدولة السعدية وتواصل حضورها في ظل الدولة العلوية التي ربطت مصيرها بمسار المغرب السياسي والاقتصادي.
وفي عهد الحماية الفرنسية، أعيد تشكيل عمرانها ومينائها لتصبح مركزا للتصدير البحري والصناعي، بينما بعد الاستقلال ظلت آسفي مرتبطة بالبحر عبر صيد السردين، وبالحضارة عبر الخزف والفخار الذي منحها لقب “عاصمة الخزف المغربي“.
واليوم؛ وبين تحديات التنمية وآمال التحديث، تبقى آسفي مدينة تجمع بين أصالة الماضي وحركية الحاضر، شاهدة على تاريخ طويل صنعته الأمواج، وخلدته أيدي الحرفيين والأجيال المتعاقبة.
المراجع
[1] راجع موقع الموسوعة البريطانية: https://www.britannica.com/place/Morocco[2] راجع موقع:https://www.shermanstravel.com/ports/safi-morocco
[3] راجع موقع الموسوعة البريطانية:https://www.britannica.com/place/Safi
[4] راجع كتاب: محمد المنوني، مظاهر يقظة المغرب الحديث، الناشر شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط2، سنة 1405هـ/1985م.
[5] محمد بن أحمد العبدي الكانوني، آسفي وما إليه قديما وحديثا، (دون معلومات حول الناشر)، ص79.
[6] محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب السلماني الغرناطي، ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب، الجزء الثاني، تحقيق محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي،القاهرة، 1980م، ص309.
[7] محمد بن أحمد العبدي الكانوني، آسفي وما إليه قديما وحديثا، مرجع سابق، ص81.
[8] محمد بن أحمد العبدي الكانوني، آسفي وما إليه قديما وحديثا، مرجع سابق، ص85.
[9] راجع:Minoubi, Abdenaim, Mohammed Bouchkara, Khalid El Khalidi, Mohamed Chaibi, Mohamed Ayt Ougougdal, and Bendahhou Zourarah. “Impact of the Port Structure in the Spatio-Temporal Evolution of the Sedimentary and Bathymetric Characteristics of a Moroccan Atlantic Bay, Study Case Bay of Safi City.” International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVI-4/W3-2021 (January 2022).
[10] راجع:Minoubi, Abdenaim, Mohammed Bouchkara, Khalid El Khalidi, Mohamed Chaibi, Mohamed Ayt Ougougdal, and Bendahhou Zourarah. “Impact of the Port Structure in the Spatio-Temporal Evolution of the Sedimentary and Bathymetric Characteristics of a Moroccan Atlantic Bay, Study Case Bay of Safi City.” International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVI-4/W3-2021 (January 2022).
[11] kifani et al., Changements à long terme dans l’exploitation des sardines au Maroc Atlantique central (1920–1990), Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération, 1992, p. 15.
[12] Abdelouahab, M., et al. Age, Growth and Reproduction of Sardina pilchardus and Engraulis encrasicolus off Safi, Morocco (2018–2019), Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries, Vol. 28, No. 4, 2024, pp. 419–433..