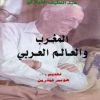المحتويات
توطئة
عَرَف المغرب بعد الإستقلال بِعَقدين مِن الزّمنِ ظهورَ فاعلين دينيين جدداً ضمْنَ مكوّنات النخبة الدينية والسياسية المغربية. ومِن أهم هؤلاء الفاعلين الدّينيين المؤثرين بفعلهم الديني–السياسي في النّسق السياسي المغربي نجد: الإسلاميينَ بمختلف توجّهاتهم التنظيمية، والسّلفيين الذين تحوّلوا إلى رقم أساسي في المعادلة الدينية الوطنية، فضلاً عن الحضور المتنامي للقيادات النّسائية الإسلامية وللمثقَّفِين الدينيين في إثارة النقاش العمومي حول الإشكالات والتّحديات والقضايا المرتبطة بالهوية والسياسة في المجتمع المغربي المعاصر. ويمكن تحديد مكوِّنات النّخبة الدّينية المغربية الحديثة في أربع فئات وهي كالآتي:
زعماء التّنظيمات والتّيارات الإسلامية
يَتَكوّن التيار الإسلامي المغربي مِن تنظيمات متعدِّدةٍ وتيارات وشخصيات مختلفة، يجمعها العمل الدّيني أي “الدّعوة” بمعناها القرآني والنبوي، وتُفَرِّق بينها القراءات الفكرية للإسلام وتاريخه، والتّقديرات السياسية للواقع المغربي. ومِن ثَمّ يتوّزّعُ الزعماء الإسلاميون المغاربة إلى فئاتٍ ضِمْن النخبة الدينية المغربية الحديثة:
-
مسؤولو وأعضاء الحركات ذات الطّابع السياسي-الحركي:
نقصِد بذلك قيادات التّنظيمات الإسلامية المعروفة بممارستِها للعمل السّياسي بطريقة علنية وواضحة في النّسق السياسي المغربي، المتميِّز تنظيمُها وخطابُها السياسي بحضور مُلْفِت للمرجعية الدينية، يَتَفاوتُ منسوبها وتوظيفها من تنظيم لآخر. وتَضُمّ هاته التنظيمات الإسلامية الحركية كُلًّا مِن حركة التوحيد والإصلاح، وجماعة العدل والإحسان، والحركة مِن أجل الأمة، والبَديل الحضاري.
ورغم تبنِّيهم للمرجعية الإسلامية المشتركة؛ إلّا أنّ الإسلاميين المغاربة يختلِف فهمهم للدّين، وقراءتهم له، كما يتمايَز سلوكهم السياسي بين منخرِطٍ في مسلسل الاندماج السياسي وِفْقَ أسلوب واستراتيجية تقوم على التوافقات والتنازلات والعمل من داخل المؤسسات، تمثِّله حركة التوحيد والإصلاح وشريكها السياسي حزب العدالة والتنمية،[1] وبَين تَوَجُّهٍ له مواقف سياسية معارضة للنظام وتوجهاته في الدين والسياسة تمثِّله جماعة العدل والإحسان.[2]
-
مُرشدو جماعة الدعوة والتبليغ:
وَهُم سائر القيادات الدعوية المحلية لهذه الجماعة ذات الامتداد الدولي، التي تأسّس فرعها في المغرب سنة 1964 على يد الشيخ محمد الحمداوي، الذي ظَلّ مرشدها إلى حين وفاته سنة 1987، ليخلُفَه االشيخ البشير اليونسي (تــ 2023) الأستاذ والداعية الشهير بمدينة القصر الكبير، التي تعد بالإضافة إلى مدينة الدار البيضاء حيث مركز الجماعة الوطني (مسجد النور) أهَمَّ المعاقل الرئيسية للجماعة.[3]
ويَتَمَيَّز الفعل الدعوي لجماعة الدّعوة والتبليغ في الحقل الدّيني بتركيزه على الوعظ وتبليغ الدعوة إلى الأفراد، سواء مِن خلال الدروس الدينية في “مراكزها الدعوية”، أو من خلال التطوع “للخروج في سبيل الله” كما تسميه أدبياتها، وتمتلك الجماعة شبكة واسعة مِن المرشدين[4] في العديد من المدن والقرى المغربية، مَهَمّتهم الأساسية السهر على تنزيل الفعل الديني للتبْلِيغِيِّينَ القائمِ على الاهتمام بالصلاح الديني للفرد، مع الابتعاد الرسمي عن كل ما لَه علاقة بالعمل السياسي.
-
شيوخ التيار السلفي بالمغرب:
يُعَدّ التيار السلفي (بِشِقّيْه: التقليدي-العلمي والحركي) مِن أبرز الفاعلين الدينيين المؤثِّرين في المجتمع المغربي المعاصر ضِمن عناصر ومكوِّنات النخبة الدينية المغربية الحديثة.
وتهتمُّ السلفية التقليدية – العلمية بالمغرب بتحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي، وتدريس العلوم الشرعية عبر شبكة واسعة مِن “دور القرآن” التي تَعَرّضت لحملة إغلاق تكادُ تكونُ شامِلةً مِن قِبَلِ السّلطات الإدارية سنة 2008، على خلفية رأيٍ فِقْهِيٍ للشّيخ محمد المغراوي رئيس “جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة” بمراكش حول موضوع “تزويج البنت الصّغيرة”.[5] إلى أن تم افتتاحها على إثر حراك 20 فبراير ضمن سياق سياسي لتحجيم تأثير الحركة الشبابية. كما أدى هذا التيار فيما بعد ضريبة دعمه الانتخابي لحزب العدالة والتنمية من خلال تشديد الرقابة الإدارية والقانونية على دور القرآن وخاصة في مدينة مراكش.
كما يَعرف الحقل الدّيني بصفة خاصة، والنسق السياسي عموماً، وجودَ تَوَجّهٍ سلفي ذا طبيعة حركية يتزعّمُه إعلاميا وفكريا مجموعة من الشيوخ، مما زاد من منسوب التّسَيُّس فيه، مع تصاعد للاهتمام والمشاركة في تفاصيل قضايا الشأن العام مع التركيز على الاهتمام بالقَضايا الإسلامية والعربية (فلسطين، العراق، سوريا..)، وبالملف الحقوقي المتعلِّق بالمعتقَلِين السلفيين وبالقضايا المرتبطة بالهوية مثل مدونة الأسرة واللغة العربية وسياسة المهرجانات.
القيادات النِّسائية الإسلامية؛ الـمهام والإسهام
لا يمكن البتَّةَ إنكار الأدوار الدّينية والإسهامات السياسية التي أضحَت تقوم بها القيادات النسائية الإسلامية في النسق السياسي المغربي، فعلى اختلاف انتمائهن التنظيمي؛ تسهم “النّسائيات” الإسلاميات بفعالية في الفعل الجمعوي والاجتماعي والتأطير الدّيني للمرأة المغربية، الذي يتجلى في برامج قطاعاتِهنَّ النسوية المستنِدة على خبرة عقودٍ مِن الزمن في تأسيس وتطوير العمل النسائي الحركي الإسلامي، حتى أمْسى اليومَ يَتَبَلْوَرُ في وجود المئات مِن المبادرات والجمعيات عبر التراب الوطني، تشتغل في احتكاك مباشِر مع النّساء في المدن والقرى، وهو ما يُفَسِّر الحضورَ الـمُلْفِتَ للنّساءِ في الأنشطة والتظاهرات المنظمَة مِن قبل الإسلاميين المغاربة.
العالمات والمرشدِات (الواعظات)
برزت المرأة العالمة والواعظة بشكل ملحوظ في السّنوات الأخيرة ضِمْنَ مكوِّنات النّخبة الدّينية المغربية، خاصة الرسمية منها، وذلك بَعد عقود من الهيمنة الذكورية على مفاصِل التأطير الدّيني للمغاربة؛ فبِمُوازاة للحضور السّياسي والنضالي للناشطات الإسلاميات في الحقل الديني والسياسي؛ تحرِص نساء الحقل الدّيني الرسمي على البروز الإعلامي والعلمي بِصِفَـتِهِنَّ عالمات تُسهمْن في العطاء الفكري والديني في المجال العام، مثل المشاركة في تأطير الدّروس الحسنية[6] والتدريس في الشُّعَب والمسالك الشرعية بمؤسسات التعليم الجامعي، وبالكتابة في مجلة المجلس العلمي الأعلى، وفي العمل الميداني باللجانِ النسائية للمجالس العلمية، ومِن خلال الإسهام في التّنشيط والتوعية الدينية بإذاعة وقناة محمد السادس للقرآن الكريم[7]. كما نجد حضور لفئة المرشدات والواعظات اللّواتي يَعْمَلن في مجال محاربة الأمية الدّينية والأبجدية للنّساء في المساجد[8] ويُسهمنَ ميدانيا في التّرسيخ نموذج “الإسلام الرسمي” المهتَم بتكوين المواطنة المغربية المتشبثَة بالمقدّسات الوطنية الرسمية، في مَنأى عن التأطير الدعوي للنساء الإسلاميات الممتزِج بالرّهانات الدعوية والتنظيمية وحتى الانتخابية.
المثقفون الدّينيون
بالرّغم مِن محدوديةِ تأثير المفكِّر والمثقّف (ة) في المجتمع المغربي بسبب ضعف الطّلب على القراءة العميقة للإصدارات المعرفية التي تُنتجها الشخصيات العالمة والأكاديمية، ولوجودِ نِسَب مهمة من الأمية الأبجدية، وللظروف الاجتماعية والاقتصادية الصّعبة التي تمسّ فئات عريضة من المواطنين؛ فإنَّ المثقّفَ الدّينيَّ[9] المغربي يَبقى له حضورٌ أوسعُ مِن المثقّف الحداثي أو العلماني في عملية الإنتاج الثّقافي والتأثير المجتمعي، خاصة في أوساط الطّلبة والشّباب والمثقّفين الوظيفيين مِن المعلمين والأساتذة والإداريين.
و يَتَمَيّزُ المسار التّكويني والمعرفي للمثقّفِينَ الدِّينين المغاربة بنهْج أغلبِهم استراتيجية عصامية في تحصيل المعرفة الدّينية، وذلك عبر تحويلهم للعُدّة الفكرية الدُّنيوية المكتَسَبَة؛ إلى كفاية فِقهية،[10] وغالبا ما تَلْقَى الإنتاجات الفكرية للمثقّف الدّيني اعتراضاتٍ مِن قِبَلِ العلماءِ التّقليديين بِدَعْوى “عِلمية”، تَقوم على عدم تحصيل المثقّف الديني للعلم الشّرعي بطريقة متسلْسِلة عن الشّيوخ-الأساتذة في المؤسسات العلمية المختَصة كالقرويين والمعاهد الدّينية العتيقة، الأمر الذي حَدا بوزير الأوقاف والشّؤون الإسلامية أحمد التوفيق إلى تصنيفهم أي المثقفين الدينيين، ضِمْن فئات “المتكلِّمين في الدين”، الذين أَوْرَدَهُم في خطاب له في صورة إيجابية ضِمْن الصِّنْفِ الرّابع مِن أَهْلِ الكَلام في الدّين وهُم “الباحثون في مختلِف علوم الدين”، وحَثّ الوزيرُ العلماءَ على معاملتهم وِفق قواعد العِلم والبحث الأكاديمي، في حين صَنَّفَ غيرَ المرِضِيِّ عنهم مِن المثقّفِينَ الدّينينَ في فئة “الهواة المحسوبين على الفكر أو التّاريخ أو الإعلام”.[11]
هذا؛ وتَشْمَل نخبة المثقَّفِينَ الدَّينين بالمغربِ مفكرينَ إسلاميينَ حركيين وآخرين مُستَقِلّين، يجمع بينهم الاهتمام المعرفي المشترك في التّأليف حول الدّين وقضاياه بلغة أكاديمية معاصرة. وبقراءة عامة لمجمل الأعمال الفكرية والاهتمامات الثقافية للمثقفين الدينيين المغاربة، نستشف ارتباطها بشكل مجمل بإشكالات القراءة التجديدية في تفسير القرآن الكريم، وتطوير الاجتهاد الفقهي وأسئلة النهضة والتغيير، مع حضور نقد عميق للقراءات السطحية والسلفية للنصوص الإسلامية، ومن أهم المثقفين الدينيين في المغرب الراهن نذكر؛ الراحل محمد عابد الجابري، والفيلسوف طه عبد الرحمان، والفقيه القانوني أحمد الخمليشي، والدكتور سعيد شبار، و الدكتور محمد رفيع، والباحث في الفلسفة الطيب بوعزة، والدكاترة: أحمد بوعود، وامحمد جبرون، وخالد الصمدي، وأحمد الفراك، وعبد الله الجباري، ومحمد التهامي الحراق …
خاتمة
كما أثْرَت رموز وقيادات التيارات والتشكيلات الدينية الحديثة الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية بالمغرب طيلة العقود المنصرمة، وما تزال قائمة بوظائفها وإسهاماتها، محافِظة على خصائصها، مع ما بينها من اختلاف في الموقف السياسي والتقدير العلمي والتأويل للدين، ومِن أبرز أعضاء ورموز النخبة الدينية الحركية التي بصمت بآثارها التاريخ السياسي الراهن ؛ نذكر الأستاذ عبد السلام ياسين، والدكتور أحمد الريسوني، والأستاذ محمد عبادي، والدكتور سعد الدين العثماني، والأستاذ فتح الله أرسلان، والأستاذ عبد الإله بنكيران، والمحامي المصطفى الرميد، والوزير الراحل عبد الله بها، والأستاذ محمد المراوني، والأستاذ المصطفى المعتصم. وفي التيار السلفي نذكر: الشيخ محمد المغراوي، والشيخ محمد بوخبزة، والشيوخ عمر الحدوشي، والحسن الكتاني، ومحمد الفيزازي. وفي صفوف القيادات النسائية سواء الحركية أو الرسمية، نذكر الأستاذة؛ ندية ياسين، والباحثة مريم يفوت، والأستاذة آمان جرعود، والوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي، والراحلة سمية بن خلدون، والدكتورة جميلة المصلي، والأكاديمية أسماء المرابط، والدكتورة رجاء ناجي مكاوي، والعالِمة فاطمة القباج، وعدد وافر من الـكاتبات والباحثات الفاعلات في الشأن الديني المعاصر.
المراجع
[1] انظر: (مقتدر) رشيد: "الإسلاميون والسلطة ورهانات العمل السياسي، مساهَمة في رصد مسار الإدماج السياسي للإسلاميين بالمغرب"، رسالة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق – الدار البيضاء 2008 – 2009.[2] (حاجي) عزيزة:"النخبة الإسلامية بالمغرب"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد: 46، شتنبر – أكتوبر 2002، ص: 29 – 30.
[3] (منظور) عبد الرحمن الشعيري: "الحقل الديني بالمغرب، قراءة سوسيوثقافية للفعل الحركي الإسلامي"، مجلة وجهة نظر، عدد: 39 شتاء 2009، ص: 41.
[4] انظر(الطوزي) محمد:"الملكية والإسلام السياسي بالمغرب"، ترجمة محمد حاتمي، خالد شكراوي، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء،منشورات الفنك 2001، ص: 260.
[5] تقرير: "الحالة الدينية في المغرب 2007 – 2008"، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، ص: 64.
[6] (مكاوي) رجاء ناجي:" كونية نظام الأسرة في عالم متعدّد الخصوصيات"، درس حسنيأمام الملك محمد السادس، بتاريخ 10رمضان 1424 الموافق لـ 5 نوفمبر 2003.
[7] حوار مع العالمة فاطمة القباج عضو المجلس العلمي الأعلى، مجلة عطاء الخاصة بالعالمات المرشدات، إصدارات المجلس العلمي الأعلى، العدد الأول، ذو القعدة 1423 / غشت 2011، ص: 35.
[8] انظر: (الحداد)حنان:"نِساء المجالس؛ تجربة مُشْرِقة"، مجلة عطاء، العدد الأول، ص: 40 -47.
[9] انظر: (المرشد) عباس:"المحتوى المعرفي لمقولة المثقف الديني"، مجلة الوعي المعاصر، العدد الرابع والخامس، السنة الأولى، شتاء 2010، ص: 102 – 109.
[10] M.Tozy, le Prince, le clerc et l’état : la restructuration du champ religieux au maroc.en ouvrage de G. Kepel et Y. Richard (sous div), intellectuel et militants de l’islam contemporain, ed. Du seuil.1990. Paris.p :79.
[11] (التوفيق)أحمد: "الكلام في الدين، أسسه وتجلياته"، درس حسني،بتاريخ 16 غشت 2010، سلسلة الدروس الحسنية، الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية www.habous.gov.ma.