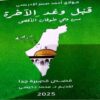المحتويات
مقدمة
حَكَمَت الجغرافيا والجيولوجيا أن يكون المغاربة مُجاورين (للأندلس) لأسبانيا، منذ أن انفصلت القارة الإفريقية عن أوروبا خلال العصر الطباشيري العُلوي، وتحديدا في الفترة الزمنية المعروفة بالكامْبانيان، منذ حوالي 83 مليون سنة مَضَت. في هذه الفترة الزمنية، حدث الإنفصال بين القارتين وبدأ تَشكُّل المحيط الأطلسي ثم المضيق الفاصل بينهما. ومنذ تلك الفترة السحيقة والعلاقات بين البلدين، اتَّسَمَتْ/وتَتَّسِمُ بالتقارب و التلاقح والوِدِّ تارة و بالنفور والتوَتر والحرب تارة أخرى.
الأندلس.. الإسم عبر التاريخ
الأندلس عند الاغريق و الرومان
قبل الحديث عن«الأندلس» لابد من الإشارة إلى أصل كلمة «إسبانيا». فالرأي الأول يجعلها مُشتقة من «هِيسْبَانَا» باللغة البونيقية والتي تعني «أرض الأرانب»، أما الرأي الثاني فيُشير إلى أن الإسم مُشتق من الكلمة الباسكية «إِزْبانَا» وتعني «الحافة» أو «الحدود». كما سموها كذلك إيبيريا (iberia) نسبة إلى نهر “إيبرو” (Ebro)، في حين أطلقوا على الجنوب اسم طارطيسوس (Tartessose)، في إشارة إلى مملكة قديمة قرب نهر “الوادي الكبير” (Gaudalquivir) في منطقة الأندلس الحالية.
أما الرومان الذين وصلوا إلى الأندلس و احتلوها، فقد أطلقوا عليها “هيسبانيا” (Hispania)، وقسموها إلى هيسبانيا عليا و أخرى سفلى. من هنا يمكن استخلاص، انه لا الإغريق و لا الرومان استعملوا اسم “الأندلس”.
يرى الجغرافي «دانڤيل» (j. B D’anville) أن الاسم مأخوذ من «ڤاندلوسيا» (Vandalucia)، أي أرض الوندال، وهم شعوب جرمانية دخلت الجزيرة في القرن 5 الميلادي، بعد انهيار النظام الروماني. ويجدر بنا ذكر رأي المستشرق دوزي الذي جاء فيه: “أن هذا الإسم كان يطلق على مقاطعة “بتيكه” وقد جعله العرب عاما لجميع اسبانيا، والراجح أن لفظ أندلس مشتقة من لفظة أندلش (بالشين)”.
الأندلس عند المسلمين
منذ أن وصل الأمازيغ و العرب إلى الأندلس، قامت هناك حضارة دامت 8 قرون، وعَرفَت أَوْجَ تَقدُّمِها في جميع الميادين خصوصا في العصر الوسيط مع الدولتين المرابطية و الموحدية. ورغم سقوط الأندلس بذلك الشكل التراجيدي (هناك من يذهب إلى أن إخلاءَها كان بقرار سياسي، في حين يرى المرحوم عبد الكبير الخطيبي، أن الأندلس كان ولابد أن تسقُط لأنها كانت كِيانا غير منسجم)، لازِلنا نحن هنا في المغرب الأقصى نُحِس دائما، أنه لازال لنا شَيء هناك في الأندلس.
يُطلِق المؤرخون و الجغرافيون العرب كلمة «الأندلس» على “شبه جزيرة إيبيريا” المكونة من إسبانيا والبرتغال الحاليتين، وغالبا ما يَغفَل الباحثون ذِكر البرتغال أو «البَرْطْقِيز» و«البرتقال» كما سماها المؤرخون القدامى، على أقصى الطرف الغربي لإيبيريا. فالأندلس عند العرب هي من بحر الزُّقاف (بوغاز جبل طارق) إلى جبال البرانس. أما الإسبان فكانوا لا يعرفون هذا الاسم قبل وصول الأمازيغ والعرب.
يشير ابن خلدون في كتابه العبر إلى ما يلي: “وأما الأندلس فهي منسوبة إلى أمة من أمم الافرنج، تسمى الوندال، كانوا قد ملكوها بعد الروم، فنُسبت إليهم ،فقيل: أرض الوندال، وعُربت فقيل الأندلس”. ويضيف ابن خلدون كذلك تعريفا دقيقا، حيث يرى أنها سُميت الأندلس باسم «قندلس» أو «ڤندلس»، وهو غالبا يقصد «الڤندال» أي «الوندال»[1].
وذكر «ياقوت الحموي»، وهو الذي أخذ عن “ابن حوقل”، في معجمه[2] كلمة الأندُلُس (بضم الدال و اللام). وقد: “استعمِل حذفهما (الألف و اللام)، وهي كلمة عجمية لم تستعملها العرب في القديم، وإنما عرفتها العرب في الإسلام (…) في الشعر وقال، بأندلس وأندَلُسَا بناء مستنكر، وفُتِحَت الدال أو ضُمَّت». ويضيف: «فهي جزيرة ذات ثلاثة أركان مثل شكل المثبت قد أحاط بها البحران المحيط والمتوسط، وهو خليج خارج من البحر الداخل في المحيط”.[3]
في حين كتب «ابن حوقل»، صاحب كتاب «صورة الأرض» والذي زار الأندلس سنة 337هجرية/948 ميلادية، ما يلي: «فأما الأندلس فهي من نفائس جزائر البحر هو من الجلالة في القدر بما حوتْه و اشتملت عليه بحال، سآتي بأكثرها (…) وطولها شهر في عرض نيف وعشرين يوماً، وفيها غامر وأكثرها عامر مأهول، ويغلب عليها المياه الجارية والشجر و القمر والأزهار العذبة”.[4]
غير أن “أبو عبد الله الحِميَري” في كتابه «الروض المعطار» قسَّم صفة جزيرة الأندلس إلى أن: «هذه الجزيرة في آخر الإقليم الرابع إلى المغرب، وهذا قول الرازي، […] معظم الأندلس في الإقليم الخامس و جانب منها في الرابع، كاشبيلية ومالقة وقرطبة وغرناطة وألمرية ومرسية.
يشار إلى أن إسم الأندلس ينطق في اللغة اليونانية بصيغة (إشبانيا) بالشين. بينما في الجغرافيا الحديثة تُطلَق على ولايات الأندلس الواقعة في جنوب اسبانيا، بين نهر الوادي الكبير والبحر و بين ولاية مرسية وإشبيلية. و يضيف: «والأندلس آخر المعمور في المغرب لأنها متصلة ببحر اقيانس الأعظم الذي لا عمارة وراءه، ويقال: أن أول من احتل الأندلس بنو طوبال بن يافت بن نوح، سكنوا الأندلس في أول الزمان وملوكهم مائة وخمسون ملكا».[5]
ويرى “المقري التلمساني” في كتابه “نفح الطيب” أن الأندلس سُميت بهذا الاسم نسبة إلى سكانها الأعاجم قديما ويسمون «أندلوش»، بالشين. و يضيف: قال ابن سعيد “أنها سميت بأندلس طوبال بن يافت بن نوح لأنه نزلنا، كما أن أخاه سبت بن يافت نزل الندوة المقابلة لها”.[6]
كما يذهب “ابن الأثير” أن النصارى يسمون الأندلس «إشبانة» باسم «إشبانس» أحد ملوكها. كما يصف “أبو عبيد الله البكري” جزيرة الأندلس قائلا: «إن اسمها في القديم «إباريه Iberia» ثم سُميت بعد ذلك «باطِقَة Baetica» والكلمة مشتقة من «وادي بيطي» وهو نهر قرطبة. وهناك تسمية أخرى قديمة هي «إشباري Herperia»، من «إشبرش» وهو الكوكب الأحمر.
أما الأمير شكيب أرسلان فيذهب إلى: “أنها مشتقة من اسم “الفاندالس” وهم جيل من الناس كانوا يسكنون بين نهر “الأودر Oder” ونهر “الڤيستول Vistule” في شرق ألمانيا، ويقال أنهم من أصل جرماني (…) وقد زحفوا من الشمال إلى الجنوب حتى بلغوا بوغاز جبل طارق و ذلك سنة 411قبل المسيح”. و يضيف أرسلان في صفحة أخرى رأي القلقشندي صاحب كتاب “صبح الأعشى (ج5)” جاء فيه: “فقيل ملكتهُ (الأندلس) أمة بعد الطوفان يقال لها الأندلش بالشين المعجمة، فسمي بهم، ثم عُرِّب بالسين المهملة، فقيل خرج من رومة ثلاثة طوالع في زمن الروم يقال لأحدهم “القلندش” بالقاف في أوله وبالشين المعجمة في آخره”.[7]
خاتمة
في ضوء ما سبق، يتضح أن مسألة تسمية الأندلس ليست مجرد قضية لغوية أو اصطلاحية، بل هي إشكالية تاريخية وثقافية تعكس تداخل الشعوب والحضارات التي تعاقبت على شبه الجزيرة الإيبيرية. وكل ذلك راجع إلى اختلاف التسمية، فالتفسيرات المتعددة لأصل التسمية – بين من يُرجعها إلى الوندال (Vandali)، ومن يربطها بأصول إغريقية أو رومانية، أو حتى عربية – تكشف عن عمق التفاعل الحضاري في تلك المنطقة، وعن تعدد القراءات الممكنة للموروث التاريخي.
ومهما يكن من اختلاف فإن دلالات الاسم في المصادر العربية والإسلامية يُبرز كيف تحوّلت الأندلس من مجرد تسمية جغرافية إلى رمز حضاري وثقافي يعكس أوج الإزدهار العلمي والفكري للعرب والمسلمين في الغرب الإسلامي. ومن ثَمّ، فإن دراسة أصل تسمية الأندلس لا تنفصل عن دراسة تاريخها العام، إذ تمثّل مدخلًا أساسيا لفهم الهوية التاريخية لتلك البلاد ومكانتها في مسار الحضارة الإنسانية.
المراجع
[1] ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، الجزء 6، الطبعة الأولى ، بيروت 1981.[2] ياقوت الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، الجزء1، دار صادر- بيروت،1977، ص 262.
[3] ياقوت الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، مرجع سابق، ص 262.
[4] ابن حوقل، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، ص104.
[5] أبو عبيد الله الحميري، الروض المعطار (قسم صفة الأندلس)، دار الجيل بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1988، ص 1.
[6] المقري التلمساني، نفح الطيب، ج1، دار صادر بيروت-لبنان الطبعة الأولى، 1900، ص 67.
[7] الأمير شكيب ارسلان، الحلل السندسية في الأخبار و الآثار السندسية، الجزء الأول، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان، ، ص 32 و34.