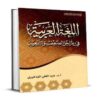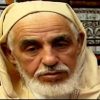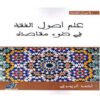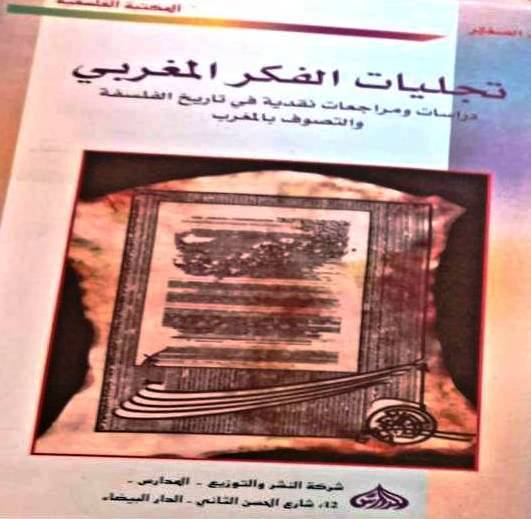
المحتويات
توطئة
يمكن اعتبار التأريخ للفكر المغربي وتقويمه، وملاحقة مده وجزره، والبحث في بداياته، هي السمة البارزة التي تميز أعمال عبد المجيد الصغيّر. فبالرغم من تخصصه الفلسفي الدقيق الذي ينحاز لكل ما هو كوني وعالمي، فإنه قد اختار أن يتخصص في البحث في تاريخ الفكر بالمغرب، والتنقيب في مراحل نشأته وتشكله، وإعادة تقويم مضمون هذا الفكر في بيئته انطلاقا من سياقه والظروف التي أنتج فيها. وقد لاحظ أن هذا الفكر يعاني نقصا كبيرا، وفقرا واضحا، نظرا لقلة المصادر من جهة، ولصعوبة الاهتداء إليها من جهة أخرى.
وقد شكلت بحوثه المتنوعة حول الفكر المغربي معالم ومصادر لا غنى عنها لمن يقصد هذا المجال، سواء تعلق الأمر بالأصول أو علم الكلام أو التصوف أو الفلسفة. ومقصدها الأساس يتجاوز الترف الفكري، والفضول العلمي، إلى بيان ما تميز به الفكر المغربي مقارنة له بنظيره في المشرق، ورصد خصوصياته، والبحث عن مصادر القوة فيه ومصادر الضعف.
فهل من سبيل لكتابة تاريخ الفكر المغربي؟ سؤال يوحي بذاته أن تاريخ هذا الفكر لم يكتب بعد، رغم مرور سنوات على الاستقلال وعلى إنشاء أول جامعة مغربية، مع أن “الوعي” بالاستقلال مرهون بالوعي بالتاريخ وبخصوصية.
من ثم أصبح من مسؤولية الباحث المغربي قبل غيره سد هذا الخصاص والمبادرة بترميم وربط حلقات الفكر الإسلامي بالمغرب، ورصد بعض تجلياته الكبرى، وتلك مرحلة أساسية في سبيل توفير “تراکم” معرفي يسمح بإعادة طرح الأسئلة وفتح باب الثقافي والحوار، وذلك هو السبيل الإعادة تشكيل الفكر المغربي اليوم وغدا، هذا ما يحاول كتاب عبد المجيد الصغير، ضمن مشروع متكامل، الإجابة عنه.
مضمون الكتاب
كتاب “تجليات الفكر المغربي.. دراسات ومراجعات نقدية في تاريخ الفلسفة والتصوف بالمغرب” للدكتور عبد المجيد الصغير، صدر سنة 2000 عن مطبعة النجاح الجديدة، شركة النشر والتوزيع المدارس، ويقع في 269 صفحة. وحاول فيه الكاتب تتبع النقص الحاصل في تاريخ الفكر بالمغرب، وفي تغطية فتراته الأخيرة إبان عصور “الانحطاط”، ومراحل التراجع. كما يشكو من نفس الغموض والنقص إذا ما حاولنا التساؤل عن طبيعة هذا الفكر في مرحلة “البدايات”، وفترات “التشكل” الأولى التي ابتدأت معالمها المتميزة بعد دخول الإسلام بقليل… فإذا وقع الإجماع اليوم على قيمة المذهب المالكي ودوره الفعال في الغرب الإسلامي ومساهمته في بلورة المواقف الجماعية والفردية في هذه المنطقة، فإن التساؤل يظل قائماً ويفرض نفسه حول «بدايات” استقرار ذلك المذهب بأرض المغرب، وتظل التأويلات مطروحة حول العوامل والأسباب التي ساهمت في ترسيخه وتجذره هناك. ومثل ما تظل هذه التساؤلات قائمة بخصوص المذهب المالكي كأحد مقومات الذهنية المغربية، فإن نفس التساؤلات والهموم الفكرية التي تفرض نفسها على الباحث بخصوص المقومين الآخرين في الفكر المغربي، ألا وهما الكلام الأشعري والتصوف الطرقي. فكل من المالكية والأشعرية والتصوف ساهموا مجتمعين بأكبر قسط في تشكيل وترسيخ ثوابت الفكر المغربي وتحديد خصائصه، كما أثروا كبير الأثر في تحديد المواقف الفكرية والعملية للمغاربة عبر مختلف المراحل التاريخية… ومع كل هذا التجذر لتلك الأصول المذهبية الفكرية والعملية، فإن الغموض لازال يلف مرحلة بدايات تلك الاتجاهات بأرض المغرب!.
وإذا كان أغلب الباحثين المشارقة قليلي الاعتناء برصد تطور الفكر الإسلامي بالمغرب، حيث اكتفوا بتسجيل ما يهم “مشرقهم” من ذلك الفكر دون الانتباه إلى “التجربة المغربية” وخصوصيتها داخل الفكر الإسلامي، فإن على عاتق الباحث المغربي اليوم تقع مسؤولية سد ذلك الإغفال الذي وقع فيه أمثال صاحب “فجر الإسلام” و”ضحى الإسلام”. (مقدمة الكتاب، ص: 6)
وقد تضمن الكتاب بعد التقديم، قسمين، القسم الأول: في الفكر الفلسفي، وبه المحاور التالية: حول المضمون الثقافي الغرب الإسلامي، نقد القاضي ابن العربي لتصوف الغزالي، في وحدة المفهوم العادة بين ابن خلدون والغزالي، دراسة تطبيقية لنقد مفهوم القطيعة في الفكر الإسلامي، مواقف “رشدية” لتقي الدين بن تيمية، ملاحظات حول مشكلة الحرية في التراث الإسلامي، نقد مفهوم الحرية عند عبد الله العروي، الغرب الإسلامي وخصوصية الطرح لإشكالية “سلطة رجل العلم”. وعنون القسم الثاني بـ: في الفكر الصوفي، وجاءت محاوره على الشكل التالي: التصوف المغربي والتصوف الأندلسي.. أي علاقة؟ مساهمة التصوف المغربي في مقاومة النفوذ العثماني والأجنبي بالجزائر، حول مخطط صوفي مغربي لتحرير الجزائر 1849م، الفكر السلفي والفكر الطرقي قطيعة أم اتصال؟.
خاتمة
لقد اجتهد المؤلف في “ترميم” تاريخ الفكر الإسلامي بالمغرب انطلاقاً من الدراسات والأبحاث الجزئية في مختلف التخصصات، التاريخية والفلسفية والاجتماعية والأدبية، وذلك بقصد توفير نوع من “التراكم المعرفي” الذي من شأنه أن يسمح في الأخير بإعادة قراءة وتفسير وتأويل ذلك الفكر وتحديد مساره الطويل …
تلك هي الغاية التي يود من أجلها المساهمة بهذه الأبحاث والدراسات التي يضمها هذا، الكتاب، وهي دراسات تتوزع على قسمين يعكسان معا انشغالات الفكر المغربي ويرمزان إلى حرصه القديم على المزاوجة بين النظر والعمل، وشغفه “بتنزيل العلم” على الواقع وتحويله إلى تطبيق وممارسة… كما أنها دراسات وأبحاث وإن تكن متنوعة الموضوع والإشكال، إلا أنها أعمال يكمل بعضها بعضا، ويساهم كل منها في طرح أسئلة واقتراح أجوبة عنها وفي ربط حلقات الزمن المغربي واستشراف وحدته المتواصلة.