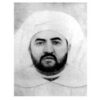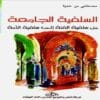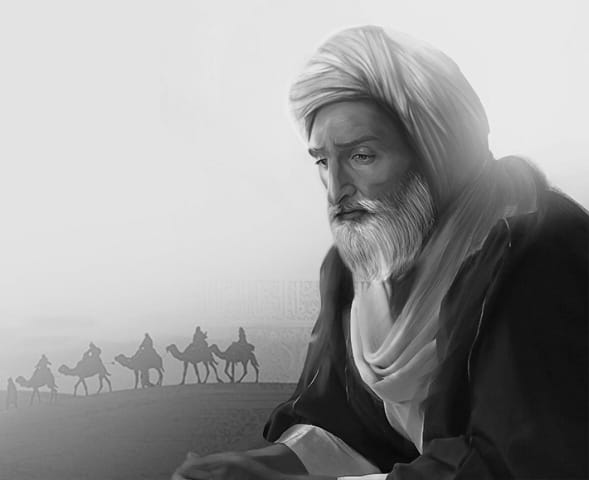
المحتويات
مقدمة
أبو محمد صالح الماكَري أو الماجري، أحد أبرز متصوفة المغرب خلال فترة الدولة الموحدية، والذي عايش فترة حكم تسعة من خلفائها، بداية بعبد المؤمن بن علي (تـ. 558هـ/1162م) وانتهاء بعبد الواحد الراشد (تـ. 640هـ/1242م). ويعتبر من مؤسسي إحدى الطوائف الصوفية المشهورة في تاريخ المغرب، وهي الطائفة الماجرية، أو طائفة الحجاج، التي أسست ركب الحاج المغربي. فقد كان له الفضل في مواجهة إحدى “الفتن” التي عرفها المغرب في زمانه، وهي الفتنة التي تسبب فيها رأي أو فتوى يرى أصحابها أن الحج ساقط عن أهل المغرب، بسبب انعدام الأمن وبعد المسافة، وأن الجهاد أفضل في حقهم. حيث صار من بين أركان طريقته حث المريدين على أداء فريضة الحج والقيام بسنة الزيارة.[1] كما لعب دورا محوريا في ازدهار وإشعاع التصوف بالمغرب انطلاقا من رباطه بمدينة آسفي.
النسب والنشأة
هو أبو محمد صالح بن ينصارن بن الحاج يحيى الماكَري الدكالي، وينتسب إلى أسرة بني نصر الماكَريين، التي استقرت بمدينة آسفي منذ أواسط القرن الخامس (11م). ومع أن أصل أسرته أمازيغي إلا أن بعض المصادر حاولت إضفاء صبغة النسب العربي القرشي عليها، وهي أسرة شهيرة من الناحية العلمية والصوفية.[2] وقد ذكر المؤرخ أحمد التوفيق في كتاب “التشوف إلى رجال التصوف” أن كلمة “ينصارن” أو “إينصارن” بنطق الصاد زايا مخفمة، معناه الغيث، أما كلمة الماجْري بجيم مصرية نسبة إلى بني ماَكْرْ من دكالة وهم بلسان “البربر“: إيماكَرن ومعناه الأكابر أو الأسياد[3]، مما يفيد بتمتع أسرة بني ماجر بمكانة وجاه كبيرين بمنطقة دكالة، وهي من البيوتات المشهورة بالعلم والعلماء.
ولد بمدينة بآسفي عام 550هـ/1150-1151م، وقد صادف ذلك بدايات عهد الدولة الموحدية وتولي الخليفة عبد المؤمن بن علي قيادة الدولة. وهي نفس الفترة التي برز خلالها عدد كبير من العلماء والمتصوفة المشهورين من أمثال: ابن حرزهم الفاسي (تـ. 559هـ/1163م)، وأبو يعزى يلنور (تـ. 561هـ/1165م)، وأبو عمر السلالجي (تـ. 574هـ/1178م)، وأبو القاسم السهيلي المراكشي (تـ. 581هـ/1185م)، وأبو عبد الله الحجري السبتي (تـ. 591هـ/1194م)، وأبو مدين الغوث (تـ. 594هـ/1197م)، وأبو الوليد بن رشد الحفيد (تـ. 595هـ/1198م)، وأبو العباس السبتي (تـ. 610هـ/1204م)، وعبد السلام بن مشيش (تـ. 626هـ/1229م)، وأبو العباس العزفي (تـ. 633هـ/1235م)، وأبو الحسن الشاذلي (تـ. 656هـ/1256م).[4]
كانت البدايات الأولى للطفل صالح الماكَري مع التعليم، على عادة الأطفال المغاربة في تلك الفترة، بدراسة مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم، وبعض المتون في اللغة والأدب والحديث والفقه، وأصول الدين، في كتاتيب ومساجد مدينة آسفي. وفي بداية شبابه بدأ بتلقي العلم على يد قطب التصوف أبي عبد الله أمغار في رباط شاكر وذلك على الرغم من بعد المسافة بين آسفي ورباط شاكر. ومن أجل مزيد من طلب العلم سافر إلى الإسكندرية في القطر المصري. وفي الديار المصرية استقر لمدة عشرين سنة وتزوج فيها وأنجب أربعة أشقاء هم: محمد وأحمد وعبد الله ويحيى. ثم تزوج مرة ثانية بعد وفاة زوجته فرزق بعيسى وعبد العزيز.[5]
رحلته في الصوف
كانت التربية الدينية التي تلقاها في سنواته عمره الأولى بآسفي الأساس الأول الذي بنى عليه تكوينه فيما بعد بالديار المصرية، بحيث عمق ذلك هناك بالمزيد من دراسة العلوم الشرعية والفقه والتصوف والتفسير والحديث[6]. كما سمحت له إقامته بمدينة الإسكندرية المصرية، باعتبارها من أكبر معاقل العلوم الدينية والأدبية في العالم الإسلامي، من ملازمة عدد من المتصوفة وأخذ عنهم؛ كابن عوف، وأبو عمران موسى بن هارون السفطوري الماجري، والفقيه ابن عيسى المعيطي، وأبو ظاهر إسماعيل بن مكي بن عوف الزهري، أبو محمد عبد الله الجزولي. كما التقى ببجاية بالمتصوف الكبير أبي مدين شعيب الذي كان أكبر شيوخه في التصوف. كما رحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، قبل الانتقال إلى العراق والشام، فالتقى خلال ذلك بعدد من أقطاب التصوف كشهاب الدين السهرودي. وقد مكنته هذه الرحلة المشرقية من رصد منهج أقطاب العلم والتصوف والممارسة الصوفية.[7]
وكما كانت رحلة الذهاب إلى المشرق مليئة التجارب واللقاءات بأقطاب العلم والصوفية، فإن رحلة عودته من المشرق كانت أيضا رحلة تصوف وعرفان. فقد أقام لفترة في تونس، واتصل خلالها بعدد من شيوخ العلم والتصوف من أمثال: أبي يوسف بن يعقوب بن ثابت، وأبي محمد عبد العزيز المهدي، ومن المحتمل أيضا أن يكون قد التقى بأبي الحسن الشاذلي. كما كان ذلك مناسبة سمحت له بإلقاء دروس الوعظ والتربية الصوفية على بعض الطلبة، فازدادت شهرته واخترقت الآفاق لما تحصل لديه من علوم الظاهر والباطن.[8]
تأسيس طائفة الحجاج وركب الحاج المغربي
وبعد تحصيل ما تيسر له علوم عصره خاصة في التصوف، أسس أبو محمد صالح الماكَري طائفته الصوفية المعروفة بالطائفة الماجرية أو الطائفة الدكالية أو طائفة الحجاج، التي قدر لها أن تستقطب عددا مقدرا من الأتباع خاصة في المغرب الأقصى والمغرب الأوسط، وفي جل مراكز مصر، وفي مكة والمدينة المنورة، ومدن العراق وبعض مدن الشام وإفريقية. ومما اشتهرت به هذه الطائفة تأسيس ركب الحاج المغربي، من خلال تأسيس الركب الصالحي. وقد كان هذا الركب ينطلق من مدينة آسفي إلى الحجاز، فأسس عددا من الرباطات لينزلها الحاج المغربي في ذهابه وإيابه من آسفي للحجاز، وبث أصحابه في هذه المراكز بما فيها مصر والشام. وكان من نتائج تأسيس الركب الصالحي أن تيسر الحج أمام الحجاج المغاربة، واتسع نطاق الركب المغربي حيث نشأت على مر الزمن خمسة ركاب لحاج المغرب بما فيها من ركب الدولة الذي تقرر تنظيمه نتيجة للركب الصالحي. والركاب الخمسة هي: الركب السجلماسي، الركب الفاسي، الركب المراكشي، الركب الشنقيطي، الركب البحري.[9]
وفاته
كانت وفاة المتصوف أبو محمد صالح المااكَري (الماجري) بمدينة آسفي في 25 ذي الحجة 631هـ/1234م، ودفن بمقر الرباط الذي أسسه، والذي يضم ضريحه ومسجده. وبفضل تكوينه وشغفه العلمي، وخاصة في مجالي التوحيد والتصوف، فقد كانت له عناية خاصة باستنساخ بعض كتب التصوف، كما هو الشأن مع المؤلفات الآتية:
- “المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى” للغزالي
- “بداية الهداية” للغزالي.
- الرسالة القشيرية.
- الرسالة الجبرانية.
- “فرائض الصلاة” للصقلي
كما ألف كتابا في التصوف سماه “تلقين المريدين”.[10]
المراجع
[1] المنوني محمد بن عبد الهادي، معطيات مدرسة أبي محمد صالح نموذج: تأسيس ركب الحاج المغربي، مجلة دعوة الحق، العدد 271،[2] مجموعة مؤلفين، معلمة المغرب، ج 16، منشورات الدمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ومطابع سلا، 2002، ص 5474.
[3] التادلي يوسف بن يحيى (ابن الزيات)، التصوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحيق أحمد التوفيق، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الهامش رقم 37، ط1، الرباط، 1984، ص 41.
[4] الماجري أحمد بن إبراهيم، المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح، تحقيق عبد السلام السعيدي، ج 1، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية –المغرب، ط1، 2013، ص 53-54.
[5] مجموعة مؤلفين، معلمة المغرب، ج 16، مرجع سابق، ص 5474.
[6] الماجري أحمد بن إبراهيم، المنهاج الواضح..، مرجع سابق، ص 56.
[7] مجموعة مؤلفين، معلمة المغرب، ج 16، مرجع سابق، ص 5474.
[8] الماجري أحمد بن إبراهيم، المنهاج الواضح..، مرجع سابق، ص 60-61./ مجموعة مؤلفين، معلمة المغرب، ج 16، مرجع سابق، ص 5474.
[9] المنوني محمد، من حديث الركب المغربي، مطبعة المخزن، تطوان، 1953، ص 7-9.
[10] الماجري أحمد بن إبراهيم، المنهاج الواضح..، مرجع سابق، ص 61-62.