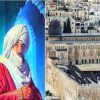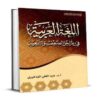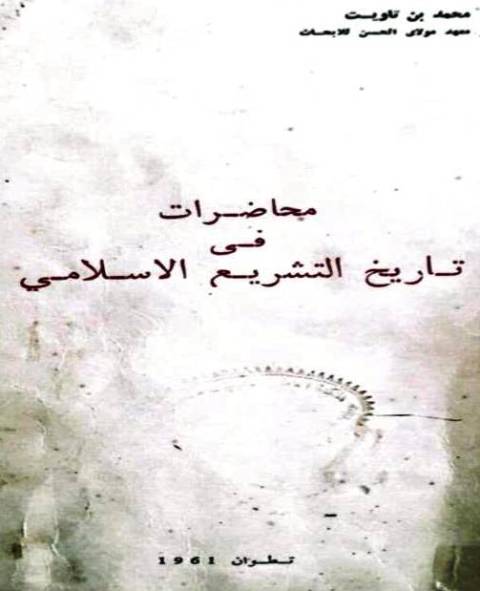
المحتويات
توطئة
من نوادر الكتب التي وقفتُ عليها، والتي طالما بحثتُ عنها عند إخطاري بوجوده ضمن مؤلفات أستاذنا محمد بن تاويت المطبوعة، كتاب: “محاضرات في تاريخ التشريع الإسلامي“. الكتاب مطبوع بتطوان سنة 1961، ويسعدني أن أقدم نظرة تعريفية بمضمون الكتاب، وقبلها نبذة عن شخصية صاحبه.
تقديم محمد بن تاويت التطواني
هو محمد بن محمد بن عمر بن عبد السلام ابن تاويت التطواني: عالم أديب، اشتهر بالبحث والتأليف والترجمة في الأدب والتاريخ والتشريع الإسلامي والفلسفة والمنطق والتصوف..
ولد بتطوان عام 1336هـ الموافق لسنة 1917م، ودرس على يد والده القرآن الكريم والمتون الأولية، ثم تابع طلب العلم في مساجد تطوان وزواياها، فتتلمذ على يد مجموعة من رجالات العلم بتطوان نذكر منهم: الفقيه عبد الكريم بن محمد الدليرو، ومحمد بن عبد السلام الريسوني، وعبد الله موراريش، ومحمد الكحاك، ومحمد الفرطاخ، ومحمد القاسمي، وعبد الرحمن بن روحو، ومحمد أقلعي، ومحمد اعمير، وغيرهم…
في عام 1929م التحق بالقرويين بحاضرة العلم فاس، فجلس في حلقات دروسها عند كل من الشيوخ الأجلاء: الطائع ابن الحاج، ومحمد ابن الحاج، ومحمد بن عبد الرحمن العراقي، والعباس بناني، ومحمد الزرهوني، ومحمد العلمي، وأبو الشتا الصنهاجي، ومحمد السايح، ومحمد بن عبد المجيد أقصبي، وعبد الرحمن ابن القرشي، والحسن بن عمر مزور، وعبد الرحمن بن الصديق الغريسي، وعبد الرحمن بن عثمان الشامي، وغيرهم، آخذا عنهم العلوم الشرعية واللغوية.
ولما أعلنت الحرب الإسبانية سنة 1936م عاد مضطرا إلى تطوان، فعيَّنه صديقه ورفيق دربه عبد الخالق الطريس كاتبا له في وزارة الأحباس بالحكومة الخليفية، هذا إلى جانب مزاولته لمهنة التدريس بالمدرستين القرآنية والحسنية.. وقد ألقى خلال تلك الفترة مجموعة من المحاضرات بنادي حركة الوحدة المغربية في تاريخ التشريع الإسلامي وفق ما جاء في مقدمة الكتاب المذكور.
ثم التحق مترجمنا بالبعثة الحسنية عام 1938م المتوجهة إلى القاهرة بقصد استكمال طلب العلم، فانتظم طالبا بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة فؤاد الأول، التي نال منها شهادة الإجازة، وبعدها دبلوم الدراسات العليا في اللغات الشرقية، ومن أساتذته آنذاك: طه حسين، ومصطفى السقا، وأمين الخولي، وأحمد لطفي السيد، وأحمد أمين وأحمد ضيف، وغيرهم…
في عام 1949م عاد إلى وطنه دون أن يستكمل الحصول على شهادة الدكتوراه، فعمل في معهد فرانكو، ثم أستاذا للبلاغة بالمعهد العالي للتعليم الديني، ثم مديرا له، ثم مفتشا لمختلف مستويات التعليم بالمنطقة الخليفية.
وبعد استقلال المغرب عام 1956م عُيِّن مديراً لمعهد مولاي الحسن للأبحاث بتطوان خلفا لعبد الله كنون، عمل خلالها على إصدار “مجلة تطوان“، حيث كان يرأس تحريرها ويكتب فيها مقالاته القيمة غالبا في التاريخ والأدب المغربي القديم والحديث.
كما عمل أستاذا بعد ذلك بعدد من المدارس والمعاهد كالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، ومحاضرا بآداب الرباط وفاس ووجدة وتطوان، وبكلية أصول الدين بتطوان كذلك…
لمؤلفنا ترجمات لأعمال عديدة عن الإسبانية والإنجليزية والفارسية والتركية وغيرها؛ من بينها “رباعيات الخيّام”، ونذكر من أعماله المنشورة: تاريخ سبتة، الوافي بالأدب العربي بالمغرب الأقصى، تاريخ البلاغة العربية، الاستشراق والإسلام، ابن عبد ربه، ابن زيدون، الوصف في شعر ذي الرمة، أبو دهبل الجمحي وشعره، تاريخ دولة الرستميين أصحاب تاهرت، محاضرات في تاريخ التشريع الإسلامي (موضوع هذا التقديم)، ومن إسهاماته في التحقيق: دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وديوان الأمير سليمان الموحدي.. كما نشر مجموع أبحاثه ضمن عدة منابر: الأمة، رسالة المغرب، العلم، الأنوار، الأنيس، دعوة الحق، المناهل، وغيرها.
وقد نال الأستاذ محمد بنتاويت التطواني جائزة عيد العرش الأدبية مرتين المرة الأولى عام 1951، والثانية عام 1952.
توفي – رحمه الله- سنة 1993م تاركا كنزا باذخا للخزانة العربية، واسما لن يمحى من ذاكرة مدينة تطوان. وقد أقيمت عنه ندوات ولقاءات تأبينية منها: “أيام دراسية حول العلامة محمد بن تاويت التطواني”-تطوان– أبريل 1993، تضمنت دراسات عدة عن المترجم له، وقصائد وكلمات وشهادات. كما أقيم يوم دراسي حول: “المكتبة النقدية النسائية في المغرب: التراث الأدبي واللغوي لمحمد بن تاويت التطواني دراسة تحليلية نقدية، أسماء الريسوني نموذجا”، قدمت فيه قراءات في كتابها الصادر ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان وملتقى الدراسات المغربية والأندلسية، وقد عرضت فيه مداخلات حول العمل الأكاديمي لمترجمنا، كما سبق لدار الشعر بتطوان أن نظمت حفل تقديم وتوقيع هذا الكتاب تزامنا مع الذكرى المئوية لميلاد محمد بن تاويت التطواني، وقدمت جمعية قدماء تلاميذ ثانوية القاضي عياض بتطوان، سنة 1998 كتابا يؤرخ للأيام الدراسية التي نظمتها حول العلامة محمد بن تاويت التطواني.
تقديم الكتاب
أول ما يلفت انتباه القارئ للكتاب ما جاء في تصدير المؤلف بقوله: “أظن أني كنت أول من حاضر بالمغرب في موضوع تاريخ التشريع الإسلامي، فلقد ألقيت سنة 1937 ثلاث محاضرات في الموضوع، وذلك ببعض نوادي تطوان“.
ولعل الأمر يرجع إلى أن هذه المادة كانت غير منتبه لأهميتها في سلسلة دروس المعاهد الدينية آنذاك، وكان التطرق إليها في محاضراته بأحد نوادي تطوان الثقافية أمرا ينبي عن الجدة والسبق العلمي الذي نبغ فيه مترجمنا. ولهذا وجدناه يذكر بعد ذلك كيف طور هذه المحاضرات الثلاث لتصبح مشروعا علميا بعد إنشاء الجامعة المغربية كما يقول: “ثم دُعيت – بعد عشرين سنة- إلى إلقاء محاضرات في الموضوع المذكور، بكلية الحقوق التي كانت قد أنشئت بتطوان سنة 1957، حينما نشأت الجامعة المغربية نفسها، وأسست لها كليات تابعة لها في كبريات مدن المغرب، كانت تطوان من بينها…”.
وقد أثنى محمد بن تاويت على المكانة الفريدة التي كانت عليها كلية الحقوق بتطوان وطلبتها النجباء، قبل أن تجتمع في كلية الرباط بقوله: “الواقع أن هذه الكلية أدت رسالتها – على قصر عمرها- كاملة غير منقوصة، إذ كانت نسبة نجاح طلابها في الامتحان هي الأولى.
ولما اقتصر على كلية الحقوق بالرباط، وانتقل طلاب باقي الكليات من نوعها إليها، تابعوا دراستهم بها، كان من طلاب كلية الحقوق بتطوان أول فائز في امتحان شهادة الليسانس لأول فوج تخرج من كلية الحقوق بالجامعة المغربية..
هذه حقيقة نذكرها للتاريخ، وللتاريخ وحده لا غير…”.
ويسترسل حديث أستاذنا عن مادة التشريع الإسلامي وكيف تحوَّلت إلى محاضرات ألقيت على الطلبة بقوله: “إن هذه المحاضرات التي كنا قد ألقيناها على طلبتنا منذ ثلاث سنوات، ورأينا أن نضعها بين يدي الطالب المغربي هي وحدها التي احتوت على ما قرر للسنة الأولى بكلية الحقوق من موضوع تاريخ التشريع الإسلامي، ثم إنها بالإضافة إلى ذلك قد تناولت بعض الزيادات التي رأيناها ضرورية في هذا الباب. وأملنا أن نكون قد فعلنا شيئا يحمد لنا، فنشكر الله عليه، وإلا فلسنا أول من حاد بهم السبيل، وعلى الله قصد السبيل، وهو ولينا ونعم النصير”.
وقد وضع هذا الكتاب على شكل كشكول اشتمل على أربعين محاضرة تغطي كل واحدة منها بين الصفحتين والثلاث والأربع، بحسب محتوى مضمونها. واللافت للانتباه في الكتاب هو طريقته في تحقيب فترات التشريع الإسلامي والتي قسَّمها إلى ستة مراحل، جاءت على الشكل التالي:
- المرحلة الأولى: التشريع في العهد النبوي، ووصفه بأنه: “هو الأصل”.
- المرحلة الثانية:في عهد الخلفاء الراشدين “أو عهد كبار الصحابة”.
- المرحلة الثالثة: بعدهم إلى أوائل القرن الثاني الهجري “وهو عهد صغار الصحابة والتابعين”
- المرحلة الرابعة: منه إلى أوائل القرن الرابع وهو “الذي صار فيه الفقه علما من العلوم ونبغ فيه الفقهاء، وأسست فيه المذاهب الفقهية المتعددة، وصار لكل مذهب أتباع”.
- المرحلة الخامسة: منه إلى فترة غزو المغول للعالم الإسلامي ابتداء من عام 656هـ، وهو الوقت الذي “دخلت فيه المسائل الفقهية في دور الجدل الحاد لتحقيق مسائل كل مذهب”، وفيه ظهر: التأليف في مؤلفاته الكبار التي تطفح بالمسائل الفقهية الكثيرة..”.
- المرحلة السادسة: من ذلك التاريخ وإلى العصر الحاضر، وتنعت هذه المرحلة السادسة بالزمن: “الذي انسد فيه آخر باب للاجتهاد وتقلص الفقه في مسائله التقليدية، ولم تعد له أية حركة إلا النقول الجامدة”.
ومؤلفنا يذكر في كل محاضرة مجموعة من العناوين الأخرى التي لها ما يبررها زيادة في التوضيح والبيان، ونجد من بين العناوين التي تشي بالكثير مما وقف عليه المؤلف من عناصر هذه المادة وتحقيق المراد منها بالنسبة للطلبة والدارسين: تدوين الكتب في الأحكام، انتشار التقليد وانقطاع الاجتهاد، اعتكاف العلماء على كتب المذاهب وشيوع التعصبات المذهبية، ظهور الحركة الإصلاحية ومحاربة الجمود في الشرق.
كما يعمد في كل مرحلة من مراحل تاريخ التشريع الإسلامي أن يورد ممثلا أو أكثر لهذا الدور أو ذاك من العلماء الذين أبانوا عن قدراتهم الاجتهادية، وقد ختم المرحلة الأخيرة الخاصة بظهور الحركة الإصلاحية بالتعريف ببعض أعلامها من أمثال: جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا.
وفي خاتمة الكتاب أشار المؤلِّف إلى أن محتواه يطابق ما تتطلبه مادة التشريع الإسلامي تحت العنوان التالي: “منهاج التشريع الإسلامي في السنة الأولى من كلية الحقوق”، وذلك بقوله: “اكتفينا بهذا المنهاج الذي وضعه رجال الجامعة لموضوع تاريخ التشريع كفهرس لمحاضراتنا، وحيث أنا قد أضفنا إلى ما ذكر في المنهاج، بعض المسائل أو العناوين، فقد وضعنا ذلك داخل قوسين..”.
خاتمة
أملي أن يكون هذا التقديم قد قدم نبذة موجزة عن محتويات هذا الكتاب الذي يمكن اعتباره باكورة مادة التشريع الإسلامي في الجامعة المغربية، قدَّمها أحد قيدومي هذه الجامعة وابن الحاضرة الشمالية مدينة تطوان العالمة، الأستاذ والعلامة محمد بن تاويت رحمة الله عليه.