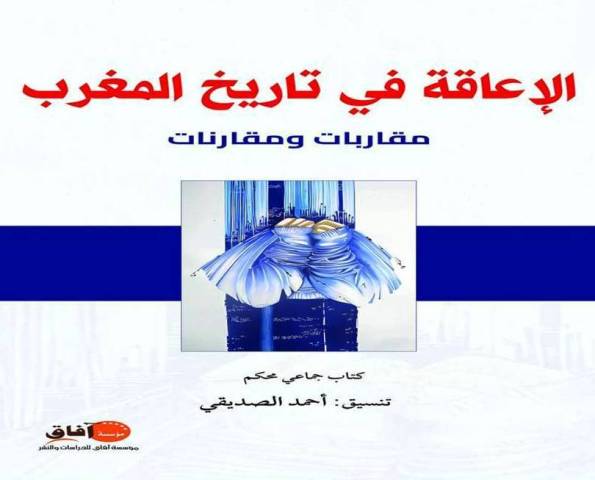
المحتويات
توطئة
تاريخ الإعاقة في المغرب يمتد إلى العصور الوسطى، حيث كانت تُعامل من منظور ديني واجتماعي، مع وجود خدمات مثل “البيمارستانات” للعلاج. وتنوعت أسباب الإعاقة بين خِلْقية (كالوراثة) ومكتسبة (كالأمراض وحوادث السير). وقد كتب الفقيه الونشريسي، وبين في متنه، أحكاما تُغَطّي الكثير من المعطيات والقضايا المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتطوّر العقل الجمعي، وبذهنية الغرب الإسلامي في علاقتهما بأوضاع “أهل الأعذار” (المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة)، وحقوقهم خلال فترة مهمة من تاريخ المغرب. وهي الفترة الممتدة ما بين القرن الثالث والتاسع الهجريين/ والتاسع والخامس عشر الميلاديين. واشتملت كتابات الفقيه على معلومات بالغة الأهمية مقارنة مع ما أُلِّف في المجال الفقهي طوال فترة العصر الوسيط. وفي الفترة المعاصرة، أصبح الدستور المغربي لعام 2011 ينص صراحةً على حظر التمييز بسبب الإعاقة. بخلاف ما كانت عليه في العصور السابقة، حيث كانت النظرة للإعاقة تمتزج بين التعاليم الدينية والخصوصيات الاجتماعية. وقدمت خدمات الرعاية العلاجات اللازمة مثل “البيمارستانات” التي توفر الرعاية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وتزايد الاهتمام بدراسة الإعاقة في التاريخ المغربي، من خلال مبادرات مثل الكتاب الجماعي “الإعاقة في تاريخ المغرب: مقاربات ومقارنات”، الذي قام بتنسيق أعماله الدكتور أحمد الصديقي. ويقع الكتاب في 416 صفحة، طبعته الأولى 2025م، وتم طبعة بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب. وقد ضم مساهمات علمية لنخبة من الباحثين الأكاديميين بخلفيات ابستمولوجية متعددة ومن مواقع جامعية مغربية ودولية مختلفة.
مضامين الكتاب
ليس من غايات هذا الكتاب الوقوف، وبتفصيل، على مفهوم الإعاقة ولا التفصيل في المدارس التي اهتمت بهاته الفئة من ذوي الحاجات الخاصة، أو الأشخاص في وضعية إعاقة، وإن كانت المقدمة قد أشارت إلى أن مفهوم الإعاقة على المستوى العضوي/الفيزيائي ظل يؤشر على ضعف قدرة الفرد على إنجاز المهام أو الوظائف الطبيعية، مما يقلل من قدراته على أداء أدواره الاجتماعية. بينما ينزاح المدلول على المستويين الاجتماعي والثقافي إلى ظواهر مجتمعية ترتبط بالتوقعات والأسامي التي يلصقها المجتمع بالأشخاص في وضعية إعاقة، أكثر منها حالات عضوية أو فيزيولوجية ذات الصلة بالعجز والقصور التي يوجد الإنسان فيها قهرا ودون إرادة أو رغبة منه. وهو ما يجعل المجتمع مسؤول عن وضع ونحت معايير للحكم على الأسوياء وغير الأسوياء، وفق سياقات ثقافية واجتماعية تنزع – في الغالب- نحو ترسيخ تمايزات وتفاوتات بين أعضاء المجتمع. (الكتاب، ص: 15)
يهدف هذا الكتاب إلى تصحيح أنماط السلوك القائمة حول الموضوع، وتجاوز التراكم الحاصل في المواقف والتمثلات السلبية تجاه الإعاقة، وذلك بالعودة إلى النماذج التاريخية المشرقة في ماضي المغرب. فضلا عما تستلزمه المقاربة الحقوقية اليوم من ضرورة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى جميع المرافق والخدمات المتوفرة. وتحفيز الاستثمار في البرامج والأنظمة التي تخدم هذه الفئة، وتحسين جودة البيانات وقدرات الموارد البشرية في هذا الباب. وتوفير التمويل الكافي لدعم وتحسين وتنويع مداخيل ذوي الإعاقة، وإشراكهم في القرارات التي تحكم مصيرهم. كل ذلك وفق خطط عمل واستراتيجيات وطنية -إضافية- لمكافحة مسببات الإعاقة. لاسيما مع التزايد المهول في نسب انتشارها، بفعل ارتفاع معدل الشيخوخة ضمن الفئات المعوزة، وزيادة الأمراض المزمنة، وكثرة التصادمات والحوادث المرورية، وما يفرزه العنف المجتمعي وما تخلفه الكوارث الطبيعية من ضحايا. وهذا يفرض زيادة في الوعي العام والمعرفة بقضايا الإعاقة ويستلزم تحفيز الأبحاث ودعم الدراسات حول الموضوع. (الكتاب، ص: 16)
دأبت الكتابة التاريخية على ربط فاعلية الأحداث بالأسوياء، سواء تعلق الأمر بالمجتمع أو الدولة. غير أن التجديد الذي لحق آليات اشتغال المؤرخ أجبرت الباحث على إعادة النظر إلى الفاعلين وأدوارهم في تاريخ المغرب، ومنهم الأشخاص في وضعية إعاقة الذين لم يحظوا بما يكفي من الاهتمام، اللهم بعض الدراسات التي ركز بعضها على تصنيفهم ضمن المهمشين.
والواقع أن تدقيق النظر في مفهوم الإعاقة ودراسة الشروط الاجتماعية والإنتاجية والفكرية والسياسية التي واكبتها، من شأنه أن يؤسس للمفهوم وتحولاته. كما أن تناول المواقف التي اتخذها المجتمع إزاء الإعاقة ودور السياسات الاجتماعية والقيم الدينية والثقافية والنظم الإدارية في حياة الأشخاص في وضعية إعاقة، ووضعياتهم في التراتب الاجتماعي، كلها قضايا ومقاربات تجعل من الإعاقة في المغرب موضوعا راهنيا ومعترف به اجتماعيا وعلميا. خاصة وأن تخصصات علمية عديدة تتقاطع وتتكامل للإحاطة بمختلف جوانبه. (الكتاب، ص: 15)
وتضمن الكتاب الجماعي بعد المقدمة محاور خمسة كالآتي:
- المحور الأول: الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة إشكالية التاريخ. ويضم الأبحاث الآتية: الإعاقة بالغرب الإسلامي بين المعالجة التاريخية وسؤال المقاربة المصدرية، لـ د. محمد البركة. الإعاقة والمعوقون بالأندلس والمغرب الوسيط: من التاريخ الاجتماعي إلى تاريخ المجتمع، لـ د. سعيد بنحمادة. الرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة بالأندلس والمغرب الوسيط: مقاربة سوسيو تاريخية، لـ د. أحمد الصديقي.
- المحور الثاني: محطات من تاريخ الإعاقة. ويضم الأبحاث الآتية: مصير الأطفال في وضعية إعاقة في الفترة الرومانية، لـ د. عبد المجيد أمريغ وذ. حسن رياض. الحالة الذهبية والفنية في منعطف الانتقال الوطاسي بين هواجس الألفية ومدلهمات العصر، لـ ذ. محمد حمداني. التطور التاريخي لنظرة المجتمعات لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة وطرق التكفل بهم، لـ د. محمد الصافي.
- المحور الثالث: مواقف وتمثلات حول الإعاقة. ويضم الأبحاث الآتية: الإعاقة في كتب النوازل: إشارات وإشكالات، لـ د. محمد المرتضي. الفقهاء والإعاقة بالمغرب الأقصى الوسيط من خلال مصنفات النوازل: تمثلات ومواقف، لـ ذ. محمد حساني. المتصوفة والإعاقة بالمغرب الأقصى الوسيط من خلال المتن المناقبي: مواقف وقيم، لـ ذ. إبراهيم أكرضان. الجذام والمجتمع بالغرب الإسلامي من خلال النوازل الفقهية، لـ د. عثمان سال و د. أنوزلا مجيد.
- المحور الرابع : المؤسسات وقضايا الإعاقة. ويضم الأبحاث الآتية: الإعاقة في الغرب الإسلامي بين نظرة المجتمع وضوابط الشرع (ق 2-10هـ/ 8-16م)، لـ د. علي عشي. الأشخاص في وضعية إعاقة بين المرجعية الفقهية النوازلية ومنظور الزوايا الصوفية خلال العهدين السعدي والعلوي، لـ د. حسن المحرزي.
- المحور الخامس: الإعاقة والعائد الاجتماعي/الاقتصادي نماذج تاريخية. ويضم الأبحاث الآتية: إسهامات ذوي إعاقة في الحياة العلمية بالمغرب والأندلس إبان العصر الوسيط من خلال كتب التراجم، لـ د. عبد الهادي البياض. مساهمة ذوي الإعاقة في تنشيط الحركة التجارية بالمغرب الوسيط: الدليل السجلماسي نموذجا، لـ د. محمد أمراني علوي. المجتمع والإعاقة: نماذج من تاريخ المغرب الأقصى خلال العصر الوسيط، لـ د. سلیمان بیكضاض.
خاتمة
لا يدعي الكتاب أنه سيجيب عن كل أسئلة الإعاقة في تاريخ المغرب، ولكنه يساهم – وهذا هو الأساس- في مقاربتها وحلحلتها لتعبيد الطريق وتوضيح الكثير من الجوانب المتعلقة بتاريخ الموضوع. وإضافة لبنة إلى ما هو موجود من الدراسات القليلة في هذا المجال البحثي البكر. ويضع بين يدي القارئ الكريم مادة علمية دسمة كمدخل لدراسة هذه الفئة ولفت الانتباه إليها، والسعي إلى مقاربة موضوع الإعاقة وفق رؤية تجمع بين عدد من المفاهيم والمعارف والمناهج والقضايا. وتمتح من معارف متعددة، تجعلنا تنتقل من التاريخ الاجتماعي إلى تاريخ المجتمع، ومن دراسة العوام إلى النبش في تاريخ عموم الناس. وتجاوز التاريخ الحدثي والظرفي إلى البنيوي، عبر مقاربة مفهوم الإعاقة والإعمال المنهجي للمصادر، لتفكيك عمق التمثلات والمواقف التي راكمتها التحولات الاجتماعية والذهنية في تاريخ المغرب حول موضوع الإعاقة، بأبعادها السوسيولوجية والنفسية وسياقاتها السياسية والاجتماعية. فضلا عن تحولاتها اليوم، التي تستدعي مقاربة الموضوع وفق رؤية سوسيولوجية. (الكتاب، ص: 16)





















