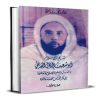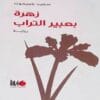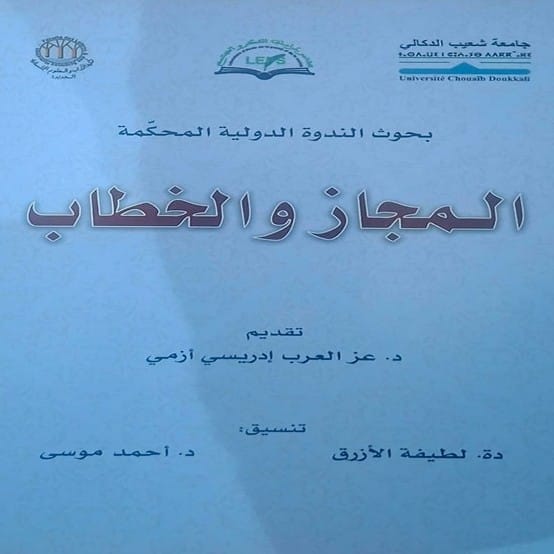
المحتويات
توطئة
المجاز هو استخدام الكلمة في غير معناها الأصلي لبيان المعنى بشكل أوضح أو أعمق، مع وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. والخطاب هو عملية التواصل اللغوي، والذي قد يستخدم فيه المجاز لأسلوبه البلاغي وجمالياته، ويدخل في تقسيمات أساليب الخطاب المختلفة. وقد عرف الباحثون الخطاب بأنه أسلوب لغوي يُستخدم فيه المجاز لغايات بلاغية وفنية، مثل إضفاء الجمال وتكثيف المعنى. وقد يكون الخطاب حقيقيًا أو مجازيًا، حيث أن استخدام المجاز هو ما يمنح الخطاب طابعًا جماليًا وفنيًا.
ولا تخفى أهمية المجاز في اللغة، كما لا يخفى أثره في الخطاب بشتى أجناسه وأشكاله لهذا حظي بالكثير من العناية في الدراسات اللغوية والنقدية، قديما وحديثا. وكان وما يزال مثار مناقشات وموضوع تساؤلات، لاسيما أنه يتجاوز حدود الملفوظ من القول، فهو عماد التعبير في أنواع الخطاب غير اللفظي (الصورة الثابتة، الخطاب الموسيقي، التعبير الجسدي). بل إن المجاز بمختلف أنواعه البلاغية (المجاز المرسل، الاستعارة الكناية…) ليست مجرد أدوات نستعين بها في التعبير وفي بناء الخطاب، من أجل صنع أثر جمالي أو إقناعي ما؛ فالمجاز بالمعنى البلاغي العام للكلمة، هو سبيلنا إلى فهم العالم ورؤية مكانتنا ووجودنا فيه وبه.
وتأتي أهمية هذا الكتاب الجماعي ليجلي بعض إشكالات العلاقة بين المجاز والخطاب، وهو كتاب جماعي قدم له الدكتور عزيز العرب إدريسي أزمي ، ونسق أعماله الدكتورة لطيفة الأزرق، والدكتور أحمد موسى، وصدر عن مختبر دراسات الفكر والمجتمع وجامعة شعيب الدكالي، ضمن بحوث الندوة الدولية المحكمة الجزء الأول، ويقع في 310 صفحة.
مضامين الكتاب
بما أن المجاز يسري في جميع الخطابات، ويُدرس تبعا لمناهج مختلفة، فقد قسم الكتاب الدراسات الواردة في هذا المؤلف إلى ثلاثة محاور؛ أما المحور الأول، فيختص بالمجاز في الخطاب الحجاجي، وقد حظي فيه المتن القرآني بدراستين، أولاها بعنوان “مشاهد من حجاجية المجاز المرسل في الخطاب القرآني” تضمنت تحليلا للوظيفة الحجاجية التي يضطلع بها المجاز المرسل في بعض آي القرآن الكريم. وثانيتهما وسمت بعنوان “التأويل المعرفي للاستعارة في الخطاب الأخلاقي القرآني”، حلل فيها الباحث نماذج من استعارات الرحمة في القرآن، انطلاقا من مباحث الاستعارة التصورية. واتجهت الدراسة الثالثة في هذا المحور نحو الخطاب السياسي، للبحث في الاستعارة الحربية في خطاب الدعاية الانتخابية للأحزاب المغربية، وبين الباحث أن هذه الاستعارة التي تمتح مجالها المصدر من حقل الحرب، تجسد الصراع السياسي تجسيدا قويا. (الكتاب، ص: 5).
أما المحور الثانى، فقد اتجه نحو البحث في سيمياء المجاز، واتكأ فيه الدارسون على متون متنوعة، تراوحت بين الخطاب الروائي والمسرحي والإعلامي. ففي البحث الموسوم بعنوان “بناء المعنى في رواية قاعة الانتظار بين الاستعارة التصورية والتجسيد السيميائي”، حلل الدارس مساهمة الجسد سيمائيا وحرفيا في بناء المعنى. وحظي الإعلام التلفزي بدراسة عنوانها: “استعارة الجدال حرب في برنامج الاتجاه المعاكس، من خلال التواشج بين المنظور المعرفي للاستعارة والمنهج الكيفي في تحليل الخطاب”.
أما المحور الثالث، فقد اختص بالمجاز بين البلاغة واللسانيات واغتنى بتنوع متون التحليل فيه. ففي الدراسة الموسومة بعنوان “مجاز الحيوان والإنسان في رسالة الصاهل والشاحج للمعري” توصل الباحث إلى أن المجاز على لسان الحيوان، وسيلة لتعرية الأوضاع الاجتماعية والسياسية المزرية لأهل الشام. وفي مجال اللسانيات، فحص الدارس في البحث الموسوم بعنوان “الاستعارة والصدق، مقاربة منطقية” الخصائص المنطقية للاستعارة، انطلاقا من القضايا الإستعارية التي تكون إما كاذبة حرفيا وصادقة استعاريا، وإما صادقة حرفيا وصادقة استعاريا أيضا. وفي مجال الشعر تجلى المجاز عبر موضوع بعنوان: “الصورة الشعرية والمواضع في شعر حسان بن ثابت”، درس فيه الباحث قصيدة من شعر الدعوة الإسلامية، وحلل فيها المواضع التي يعود إليها الشاعر حين تشكيل صوره الشعرية، مميزا بين المواضع التي تعارف عليها الشعراء السابقون منذ القدم، وبين المواضع الجديدة التي متح منها الشاعر صوره، وهي المواضع المستمدة من آي القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولم يخل هذا الكتاب من البحث في علاقة المجاز بالترجمة، وفي هذا الاتجاه يصب البحث الموسوم بعنوان “ترجمة فيليب غريا: الإدماج التصوري والاستعارة المسترسلة “، وفيه يبين فليب غريا أن سيرورة الإدماج تستدعي آلية بناء معنى خاص جدا، وأن الإدماج يمكن من وصف كاف لاستغلال الاستعارات الممتدة، التي غالبا ما تكون مبتكرة مختلفة بذلك، عن الاستعارات الوضعية المبتذلة في الاستعارة التصورية. وفي موضوع الترجمة أيضا، وردت دراسة بعنوان “ترجمة المجاز في النص التراثي العربية حكاية الجاحظ “عبد الله بن سوار والذباب “، بين فيها الباحث أن مترجم الحكاية من العربية إلى الفرنسية قد أفرط في الانزياح عن خصوصيات المجاز في النص الأصلي، وهذا شأنه أن يفقد النص المترجم الأثر الذي أحدثه المجاز الأصلي في الحكاية، والذي توخى فيه الجاحظ الوضوح وتقريب معاني السخرية من المتلقي. (مقدمة الكتاب، ص: 6\7)
وجاءت محاور الكتاب التفصيلية على الشكل التالي:
- المحور الأول: المجاز في الخطاب الحجاجي، وتضمن ما يلي: مشاهد من حجاجية المجاز المرسل في الخطاب القرآني، لـ ذ. مصطفى أحمد قنبر. التأويل المعرفي للاستعارة في الخطاب الأخلاقي القرآني.. استعارات الرحمة نموذجا، لـ ذ. عثمان حدون. الاستعارة الحربية في خطاب الدعاية الانتخابية للأحزاب المغربية، لـ ذ. نور الدين الطويليع.
- المحور الثاني: في سيمياء المجاز، وتضمن ما يلي: بناء المعنى في رواية قاعة الانتظار بين الاستعارة التصورية والتجسيد السيميائي، لـ ذ.محمد الإدريسي. الصورة الشعرية والمواضع في: “شعر حسان بن ثابت”، لـ ذ. اسماعيل والضحى. استعارة الجدال حرب في برنامج الاتجاه المعاكس، لـ ذ.رشيد أخساي .الاستعارة في الخطاب السينمائي المغربي الفيلم المغربي (ZERO) أنموذجا،لـ ذ. لحسن بوشال. المجاز في اللقطة الإشهارية، دراسة سيميائية في الدراما الرمضانية، لـ ذ.عاطف الكرجي. الاستعارة في الصورة الرقمية: تجلياتها ووظائفها، لـ ذ.عمر أكداش .
- المحور الثالث: المجاز بين البلاغة واللسانيات، وتضمن ما يلي: من مجاز الإنسان إلى مجاز الحيوان في رسالة الصاهل والشاحج “لأبي العلاء المعري”، لـ ذ. جواد ختام. الاستعارة والصدق مقاربة منطقية، لـ ذ. مولاي مروان العلوي .ترجمة مقال فيليب كريا المعنون بـ الادماج التصوري والاستعارة الممتدة، لـ ذ. سميرة حلاوي. ترجمة المجاز في النص التراثي العربي حكاية الجاحظ، لـ ذ. عبد الله قبس.