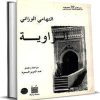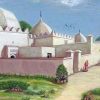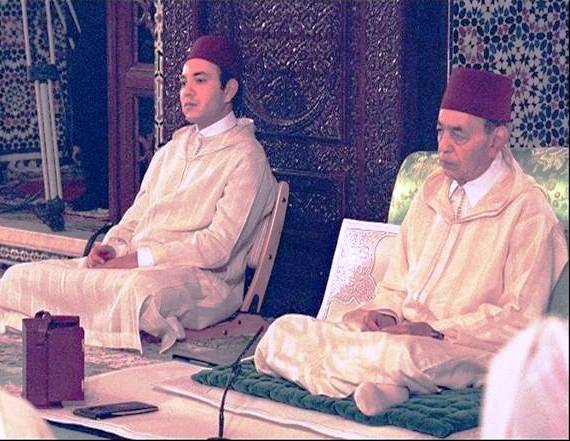
المحتويات
توطئة
شَكَّلت النخبة الدينية منذ عهْدِ الدولة الإدريسية فئةً محورية واستراتيجية في البناء الهرمي للدولة، وفي تنظيم وتمثيل المجتمع، وقد شملت النخبة الدينية بمكانتها الاعتبارية المهمة؛ العلماءَ والصلحاءَ وشيوخ الزوايا الصّوفية الذين عرفوا في الوجدان العام للمغاربة بالأولياء، فضلا عن الأمراء والسلاطين المستمِدِينَ مشروعيتهم في الحكم مِن الاستناد إلى الدين وبالانتماء للنّسب النبوي الشّريف.
وَضَمّت النخبة الدينية المغربية عبْرَ تاريخها القضاةَ الذين كان يتمّ اختيارهم من فئات العلماء في الحواضر الكبرى أو من الفقهاء في البوادي والقرى، ثم الأحبار باعتبارهم ممثِّلين لليهود المغاربة أمام الدولة السلطانية، ومسؤولين على تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية.[1]
تأريخ لأهَمِّ فئة في التاريخ
تفيدنا القراءة التاريخية أنّ النخبة الدينية الإسلامية بجميع مكوناتها -وبالأخص العلماء والصلحاء وشيوخ الزوايا-كانت لها أدوار محورية في التّعبير عن تطلّعات المجتمع المغربي السياسية والثقافية والاجتماعية، كما قامت بتلكم الأدوار بسلوكها الأخلاقي وإنتاجها العلمي، ومِن خلال امتلاكها لناصية تفسير النصوص الشرعية الإسلامية، وبإسهامها الوفير في الحفاظ على الوحدة العقدية والمذهبية للمغاربة، وتوطيدها لقيم التكافل الاجتماعي خاصة في أوقات الأزمات والمجاعات[2]، وبمشاركتها في المجال السياسي عن طريق آليتيْ البيعة والنصيحة، الأمر الذي جعل مِن النخبة الدينية دوما فاعلا مهما فبي التاريخ الديني والسياسي للمغرب الأقصى ضِمْن أهْلِ الحلّ والعَقد المساهمين في صنْع قرارات المخزن مباشرة، و المؤثّرين في توجيهها وتنفيذها، أو معارضين لها أحيانا إذا دَعَت إلى ذلك الظروف السياسية.
وبتميزها بالرأسمال الرمزي القائم على المكانة الدينية والشرف والعلم؛ كانت النخبة الدينية ولا تزال مِن أهمّ مكونات النخبة المغربية المؤثّرة في توجهات المجتمع المغربي، والحاضرة موضوعا وإشكالا في أجندة ورهانات الدولة. فقد كانت النخبة الدينية على سبيل الذّكر، مِن أبرز مكونات النخبة السياسية والاجتماعية في مغرب القرن التاسع عشر الميلادي، والتي كانت تشمل الفئات التالية: الشرفاء -العلماء -الأولياء والصلحاء والشيوخ- قواد الجيش والقبائل ومَن على شاكلتهم مِن الأرستقراطيين والعسكريين مركزيا ومحليا وكذا كبار التجار وأرباب الحرف.[3]
ثمّ كانَ أن تَعَرّضت النخبة الدينية بعد الاستقلال وتَطَوّر بناء الدولة الوطنية بالمغربِ لتحوّلات عميقة في بنية مكوّناتها، مَسّت أيضا مركزها الاجتماعي والسياسي الذي عَرَف مخاضًا عسيرا أعاق استمراريتها في ريادة المجتمع، وأضعفَ تأثيرها في قرارات السلطة السياسية.
وقد أسهم في هذا التّحول الذي مَسّ بناء النخبة الدينية المغربية؛ بروز نخب سياسية ونقابية وإدارية عصرية تتكوّن مِن خريجي المعاهد الحديثة والمدارس العمومية، أضْحَواْ منافسين للنخبة الدينية في مسار تمثيل المجتمع وتوجيهه، وفي تزويد الدّولة بالأطر اللازمة لتسيير دواليب المؤسسات والإدارة العمومية، وقد كان مِن تداعيات هذه التّحولات السياسية والاجتماعية والإدارية على بنية النخبة الدينية التقليدية؛ هو فقدانها لإحدى مكوناتها الرئيسية المتمثِّلة في القضاة، الذين أصبحوا يشكِّلون نخبة إدارية متفرّدة بنظامها التكويني والقضائي المستمَد مِن الترسانة القانونية الحديثة.
النّخبة الدينية المغربية التقليدية
تَشمل النخبة الدينية إلى جانب مُكَوِّن العلماء، الملك/أمير المؤمنين، الذي هو زعيم النخبة الدينية الرسمية، وأوّل العلماء[4] بمقتضى المشروعية الدينية والتاريخية المستمَدَّة من عقد البَيعة والنّسب النبوي الشريف. كما يُعَدّ بحسب الفقه الدستوري الرسمي مصدرا للقيم الدّينية[5] المطلوب الانضباط والامتثال لها في الحقل السياسي والديني، ولا يَزال الملك/أمير المؤمنين رغم كل التحولات السياسية هو رئيس السلطة الدينية والمدنية في الدّولة.[6]
يقوم الملك/أمير المؤمنين باعتباره فاعلاً مركزياً ضمن النخبة الدينية، وحائزاً للسلطة الروحية الملزمة في النّسَق السياسي المغربي؛ بمجموعةٍ مِن الوظائف التي تَعكس تـَمَثُّلَهُ المستمِر للزعامة الدينية، ومن أبرزها تلكم الوظائف على سبيل الاختصار:
- رئاسة المجلس العلمي الأعلى والإشراف العام على هيئة الإفتاء؛
- التعيين في الوظائف الدينية العليا (وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المجلس العلمي الأعلى، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء)؛
- الحضور الشّخصي في المناسبات ذات الطابع الديني (حضور صلاة الجمعة، إحياء ليلة القدر والمولد، ترؤس الدّروس الحسنية، القيام بشعائر ذبح الأضحية وتدشين المساجد.)؛
- رئاسة اللجنة الملكية للحَج، والدعوة للاستسقاء في فترات الجفاف؛
- التّشريع والتنظيم الحصري في الحقل الدّيني؛
- إرسال ممثّليه من الديوان الملكي لحضور المواسم وزيارة الأضرحة وإيصال الرسائل للزعامات الدينية في العالمين العربي والمسيحي؛
- السهر على التجديد السنوي لمراسيم وطقوس البيعة؛
- التحكيم في النزاعات السياسية والقضايا المجتمعية الكبرى (مدونة الأسرة نموذجا)؛
- بَعث رسائل التهنئة لرؤساء وملوك وأمراء الدول الإسلامية، في المناسبات الدّينية.[7]
المكوّنات الأساسية في البنية الدينية التقليدية
بعد شخص الملك/أمير المؤمنين وفئة العلماء، يمكن الحديث عن أهَمّ مكوّنات أو عناصر النخبة الدينية التقليدية في التاريخ الحديث والمعاصر للمغرب، مجمِلينَ إياها في:
- مستشارو الملك في الشّؤون الدينية: فَمِن بين عناصر الفريق الاستشاري للملكِ نجد حضور صِفَة مستشار الملك في الشّؤون الدينية داخل البلاط الملكي، باعتباره مساعدا ووسيطا له مع وزارة الأوقاف والعلماء، وباقي مكوّنات النخبة الدينية، كما يقوم المستشار الديني بتمثيل الملك في المناسبات الدينية والعلمية التراثية داخل المغرب وخارجه.
وقد اشتهرت في عهد الملك الحسن الثاني شخصيتان رئيسيتان في تقلُّد مهمة مستشار الملك في الشؤون الدينية وهما السيدان أحمد بنسودة وعباس الجراري. ويَقوم مستشار الملك في الشؤون الدينية باعتباره عضوا في النخبة الدينية التقليدية الرسمية بتبليغ تعليمات وتوجيهات الملك/أمير المؤمنين لمختلف مكوّنات النخبة الدينية المؤسساتية، مثلَ: الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، مدير دار الحديث الحسنية وغيرهم. كما يُساهم التّكوينُ الديني واللغوي والتاريخي للمستشار الدّيني في انضمامه لـ”الأنتلجنسيا التقليدية داخل القصر”، المختَصّة في تدبيج الخطب الملكية ذات الطّابع الأكاديمي والتاريخي، وفي الحضور نيابةً عن الملك في تمثيل المغرب في المحافل العلمية المهتمة بالتراث العربي والإسلامي.
- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: هو أبرز شخصية ضِمْن أعضاء النخبة الدينية الرسمية بعد أمير المؤمنين، لما يمتلِكه مِن ثِقْل سياسي وقانوني في توجيه السياسة الدّينية الوطنية وِفْقًا للتّوجهات العامة للمؤسَّسة الملكية في هذا المجال.
- شيوخ الزوايا: يرتبط شيوخ الزوايا بالتصوف المغربي الذي تَعود جذوره العميقة إلى بداية مرحلة الفتح الإسلامي. وبتطوّره التلقائي في البيئة المغربية؛ شَكَّلَ التصوف استمراراً لظاهرة الزّهد التي عرفها التاريخ الإسلامي، والتي اصطَبغت في تاريخ المغرب الأقصى بوجود نخبة شيوخ الزوايا الذين عُرِفُوا في المخيال الشّعبي المغربي برجال الله والأولياء والصالحين.
وَيَتَمَتّع الصّلحاء باعتبارهم مكوّناً متميزاً ضِمْن النخبة الدّينية المغربية بمشروعيةٍ روحية واجتماعيةٍ عميقةٍ وقويةٍ[8] جَعَلَتْهُم يتبوّؤون مكانةً سامقة في التوجيه التربوي للمجتمع المغربي، كما أدّت بهم هذه الزعامة في فترات ضعف السلطة المركزية إلى التطلع للحُكم، كما حصل في القرن السابع عشر ميلادي مع الزاوية الدّلائية،[9] والزّاوية الكتانية بقيادة شيخها محمد عبد الكبير الكتاني في معارضته الصارمة للسلطان عبد الحفيظ مطْلَع القرن العشرين. وإذا كان شيوخ الزوايا (الصلحاء) قد ساهموا في صَوْغِ المعادلة السياسية المفرِزَة للسّلطة الحاكمة عن طريق حضورهم البارز الفاعل إلى جانب العلماء في دعم السلطان أو خلْعه من خلال توظيف آلية البيعة، أو بتوفير الدعم المجتمعي للسلطان خاصة في القبائل؛ فإنهم لم يَعد لهم في المغرب الراهن نفس المركز الاجتماعي-السياسي المؤثِّر بعُمْقٍ في بنية المجتمع والدولة[10] نظرا لتَطوّر وحداثة الدولة وبُروز الحركة الوطنية المغربية ذات الميول السلفية بدءً، ثم الوطنية فيما بعد، بقدْر ما أصبَحوا فاعلين دينيين تابِعين بشكْلٍ مطلق للمؤسّسة الملكية، ومساهمين في ترسيخ مشروعيتها الدّينية ذات المنزع الشرفاوي (نسبة للشرف).
- الشّرفاء: ترتكز شرعية السلطة بالمغرب بشكل بارز على أرضية الشرف والانتماء للبيت النبوي، فبالرغم من غياب محدِّد الانتماء الشريف كشرط متفَقّ عليه لتولي الحكم في النظرية السُّنية؛ إلّا أنّنا نجد له حضورا كبيرا في عملية تولية الملْك في التجربة المغربية، وفي الدّعاء للسلطان في خطَب الجمعة، وفي ذكرى المولد الشريف وفي غيرها من المناسبات الدينية التي يُذَكر فيها الخطاب الديني الرسمي بعراقة وجود الشرفاء ومنهم الحكام العلويين بأرض المغرب.
وإذا كان التاريخ السياسي والدّيني قد حفِظَ للشرفاء تأثيرهُم في المجتمع المغربي ودواليب الدّولة السلطانية المخزنية، بما جعَلَهم ضِمْن النخبة الدينية المسانِدة للسلطان الشّريف سياسيا ودينيا، والمستفيدَة مِن امتيازاته في شكْل هدايا عمومية أو خصوصية أو بإعفائهم من تأدية الضرائب[11]؛ فإنهم منذ بداية العقد الأول مِن القرن الواحد والعشرين، لم يَعُد لهم نفْس التأثير الديني والسياسي في مؤسّسات المجتمع والدولة، بقدْر ما أَضْحَواْ يمثِّلُون العمقَ التّاريخي للنظام السياسي المغربي، الذي يقابِل سَنَدَهُم الرّمزي بالدّعم المادي لمراسم الشّرفاء وأضرحتهم.
- الفقهاء والخطباء: هُم أكثر أعضاء النّخبة الدينية تغلغلا في أوساط المجتمع المغربي، بحيثُ يُعَدُّونَ بِعشرات الآلاف،[12] ويَسْهَرون على أداء وظيفتهم الدينية في مختلف مساجد وزوايا المملكة مِن خلال إمامة المصلِّين، وتحفيظ القرآن الكريم، وإلقاء خطب الجمعة، ومشاركة الناس في مناسباتهم الاجتماعية كالجنائز والعقائق والعودة من الـحجّ وغيرهما..
- طلبة العلوم الشرعية (الطُّــلْـبَة): يُشَكِّلون كتلة كبيرةً وقاعدةً اجتماعية واسعة في الحقل الديني المغربي. وقَد سبَق أنْ صَنّفَهم المفكّر السياسي الفرنسي الراحل ريمي لوفو في معرض دراسته حول تأثير النُّخب التقليدية في النّسَق السياسي المغربي خلال السنوات الأولى للاستقلال ضمن “المثقّفين ذوي التّكوين التقليدي”، الذين تميَّزوا في تاريخ المغرب بعد نيلهم للتكوين الشرعي المؤسَّس على حفْظِ القرآن الكريم والمنظومات الفقهية المالكية في المعاهد العتيقة، بانتشارهم عبر ربوع البلاد بِصِفَتِهِم مدرِّسين للقرآن، أو عُدُولاً أو كُتّابا لدى القُوّاد المخزنيين، كما كان منهم مَن يحصل على ثقافة أكثر عمقا، تتيح لهم الاندماج ضمن نخبة العلماء.[13]
ختاما
تُفيدُ القراءة التاريخية أنّ النخبة الدّينية المغربية التقليدية بجميع مكوناتها الأساسية كانت لها أدوار محورية في التّعبير عن التوجهات السياسية والثقافية والاجتماعية للمجتمع، والقُدرة على تفسير النصوص الشرعية الإسلامية، والإسهام الوافر في الحفاظ على الوحدة العقدية والمذهبية للمغاربة، و كذا توطيد قيم التكافل الاجتماعي وبالأخص في أوقات الأزمات والمجاعات والأوبئة، كما أسهمت في تأطير المجال السّياسي عن طريق المشاركة في عملية البيعة و إبداء النصيحة العامة ، وهي المعادلة التي جعَلت مِن النخبة الدّينية التقليدية مكونا مُهِمّاً ضَمْن الفئة التاريخية لأهل الحل والعقد، ومُساهماً رئيسياً في صنْع قرارات المخزن، وفي الحفاظ على التوازن المـجتمعي، رغم ما عانته بعض مكوّناتها من خفوت الفاعلية تحت وطأة تحولات الدولة الوطنية والمجتمع والعالَم، وبُروز النخبة الدينية الإسلامية الحركية.
المراجع
[1] انظر: "اليهود المغاربة" ضمن تقرير "الحالة الدينية في المغرب 2007-2008" الصادر عن المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، أكتوبر 2009، ص: 421 – 430.[2] انظر: (بوتشيش) إبراهيم وآخرون: "التصوف السني في تاريخ المغرب، نسَق نموذجي للوسطية والاعتدال"، منشورات الزمن، سلسلة شرفات عدد: 27، طبعة 2010، ص: 141.
[3] (جفري) سعيد: "النخبة وسؤال الإصلاح في مغرب القرن 19"، ضمن كتاب "النخب المغاربية الخلفيات، المسارات والتأثير"، منشورات مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، مطبعة سوماكرام، 2012، ص: 47.
[4] (لوفو) ريمي: "الإسلام والتحكم السياسي في المغرب"، منشورات مجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي عدد، 13-14، لسنة 1991-1992 ص: 170.
[5] (المعتصم) محمد: "التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 1988 ص: 157.
[6] (التوفيق) أحمد: درس حسني رمضاني بعنوان "تدبير العلاقة بين الدين والسياسة"، رمضان من سنة 2004، www.habous.gov.ma
[7] انظر: - Mohamed Darif, Commanderie des Croyants : Outile de L’étalisation en Ouvrage: Monarchié Marocaine et acteurs Religieux. Ed. Afrique Orient 2010 pp: 13 -26. و( الشعيري) عبد الرحمن منظور: "إمارة المؤمنين في دستور 2011، قراءة في البنية والتوظيف"، مجلة وجهة نظر العدد: 50، خريف 2011، من الصفحة 9 إلى الصفحة 11.
[8] (المغراوي) محمد: "العلماء والصّلحاء والسلطة بالمغرب والأندلس في عصر الموحدين"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، 2001 – 2002، ص: 473.
[9] Abdellah Laroui, les Origines sociales et culturelles du nastionalisme marocain (1830-1912). Ed, Maspero.Paris.1977 p :132.
[10] (الزاهي) نور الدين: "الزاوية، الإسلام والسياسة في المجتمع المغربي"، منشورات إفريقيا الشرق، الطبعة الثانية 2003، ص: 59، وص: 86
[11] Abdellah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nastionalisme op. cit :95
[12] انظر: تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بالبرلمان يوم الاثنين 26 مارس 2012، جريدة التجديد، عدد 2862، الأربعاء 28 مارس 2012.
[13] ريمي (لوفو): "الفلاّح المغربي المدافع عن العرش"، ترجمة محمد بن الشيخ، مراجعة عبد اللطيف حسني، منشورات وجهة نظر، سلسلة أطروحات وبحوث جامعية، الطبعة الأولى 2011، ص: 105.