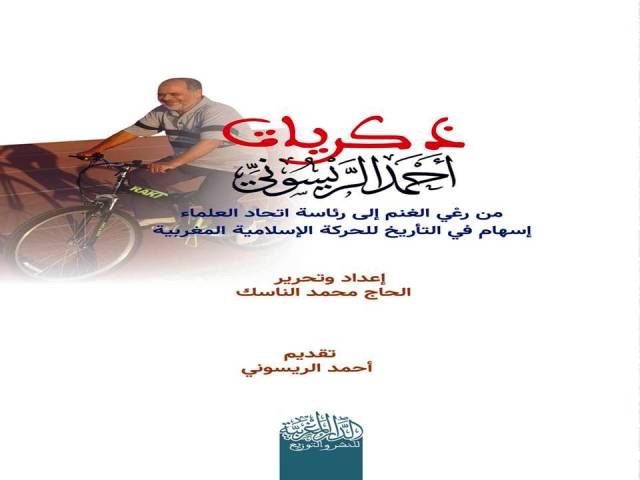
المحتويات
توطئة
درجت المكتبات العربية والغربية على استقبال أنواع شتى من المذكرات التي يكتبها زعماء سياسيون أو فلاسفة مفكرون، أو أدباء روائيون، أو دعاة إسلاميون، أو علماء مجتهدون، أو مناضلون مضطهدون… وتكون كتاباتهم تدوينا لأحداث ووقائع سرعان ما تتحول إلى شهادة على عصر أو مرحلة أو تجربة.
ولعل حظ المكتبة الإسلامية في هذا النوع من الكتابة لا يشكل نسبة مقدرة، بالرغم من تعاطي عدد من الكتاب الإسلاميين معه، بعد نجاحهم في تجاوز إشكالية الحديث عن الذات التي يستنكف عدد منهم أن يخوضوا فيها. فكان أن تحدثوا عن تجاربهم، ونجاحاتهم، وإخفاقاتهم، ومن أشهر من كتب في هذا المجال: حسن البنا، ويوسف القرضاوي، وسيد قطب، ومصطفى محمود، وعلي الطنطاوي، وعلي عزت بيغوفيتش، ومنير شفيق… ولعل آخر ما صدر في هذا المجال: “ذكريات أحمد الريسوني: من رعي الغنم إلى رئاسة اتحاد علماء المسلمين. إسهام في التأريخ للحركة الإسلامية المغربية“.
الكتاب صدر عن الدار المغربية للنشر والتوزيع بالمغرب، ودار الكلمة للنشر والتوزيع بمصر، ويقع في 416 صفحة، يقدم فيه صاحبه ذكرياته التي بدأت من تاريخ ميلاده بدوار أولاد سلطان، الثلاثاء ريصانة، إقليم العرائش، لتنتهي بالحديث عن رئاسته لاتحاد علماء المسلمين.
وفي هذه الورقة سأتناول تقديم الكتاب من خلال عتبتين اثنتين هما: العنوان والمقدمة، وأشير منذ البداية على أن مفهوم العتبة هنا ليس على “مذهب” الشعرية الفرنسية ولا البنيوية اللسانية كما هو الحال عند جيرار جنيت مثلا، بل سأعتبر عتبتيِ الكتاب موضوعَ التقديم، مدخلا سلسا يتأتى لأي قارئ لبيب، ولو كان تصفحه للكتاب واقفا أمام رف مكتبة أو خزانة أو نقطة بيع.
في صياغة عتبة العنوان
يمكن التمييز بين عنوان رئيسي للكتاب وآخر فرعي، أما الأول فـ :”ذكريات أحمد الريسوني من رعي الغنم إلى رئاسة اتحاد علماء المسلمين”، وأما الثاني فـ : “إسهام في التأريخ للحركة الإسلامية المغربية”.
ومنذ القراءة الأولى للعنوان، تجد أن الدكتور أحمد الريسوني ظل وفيا لخلق التواضع،الذي لا يختلف اثنان ممن عرفوه أنه تاج رصيده التربوي، والعلامة الفارقة في انتمائه الدعوي، وذلك حين أقحم توصيف “رعي الغنم” – دون داع حقيقي- في مقابل “رئاسة اتحاد علماء المسلمين” وكأني به يستدعي الموقف الخالد للخليفة الفاروق رضي الله عنه، فيما رواه عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغى لك هذا، فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلتْ نفسي نخوة؛ فأردت أن أكسرها”. وكأني بالدكتور أحمد الريسون يتعمّد أن يفسد على نفسه لقب رئاسة اتحاد علماء المسلمين، وأقحم هذا التوصيف الذي كان بالإمكان تجاوزه بعبارة مثل: “من دوار أولاد سلطان إلى رئاسة الاتحاد”، أو “من القرية إلى رئاسة الاتحاد” إلخ. ومما يعزز ما ذهبت إليه أن الحديث عن رعي الغنم في ثنايا الكتاب لم يتعدّ ثمانية أسطر فقط، وطّأ بها صاحب الذكريات حديثه عن فصله الأول “أيام الطفولة”، ضمن عنوان “قصة دخولي المدرسة” (ص 38).
لم يجد الدكتور أحمد الريسوني غضاضة في التنصيص على هذه العبارة، بل إن إقحامه لهذا التوصيف كان على وعي تام، وحرص منه- مع سبق الإصرار – على مغالبة نفسه، مخافة أن تدخلها النخوة التي خالطت قبله الفاروق رضي الله عنه، فأراد أن يكسرها. فكان له ذلك.
في ثنايا عتبة المقدمة
كانت المقدمة ولا تزال فرصة تهيء للقارئ الولوج السلس إلى ثنايا الكتاب، ويسعى المؤلف من خلالها إلى توضيح معالم ما كتب، متسلحا بما يستوجب من وسائل الإقناع كي يدفع بالقارئ إلى مواصلة القراءة. ويضمن النجاح في تحقيق الغاية التي من أجلها كان الكتاب.
وبذلك شكلت المقدمة–عبر تاريخ التأليف- فعلا افتتاحيا لا يمكن تجاوزه و لا التغافل عنه، وعتبةً لا بد أن يحرص الكاتب على حسن صياغتها، ليتحقق التواصل المنشود بين طرفين اثنين، مرسِل (المؤلف) ومرسَل إليه (القارئ)، ولتتحوّل تلقائيا إلى تعاقد ثان بعد عتبة العنوان، لا يملك الكاتب إلا أن يفي بمضامينه.
ويمكن الوقوف على أهمية مقدمة الكتب من خلال الشهرة التي حازتها مقدمات بعض الكتب أغنت عن الكتاب، وقد تصبح موضوعا للدرس عوضا عنه، بل أُفرد بعضها في سفر خاص، نظرا لما فيها من الكنوز والدرر، كما هو الحال بالنسبة لـ “مقدمة ابن خلدون”، و”مقدمة صحيح مسلم”، و”مقدمة فتح الباري”، ومقدمة “كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون” لحاجي خليفة …..
وقد جاءت مقدمة كتاب “ذكريات أحمد الريسوني” قصيرة مختصرة لا تتجاوز صفحتين اثنتين، (23-24) واختار لها الكاتب صاحب الذكريات عنوانا لا يقل في حمولته وأبعاده عن العتبة الأولى: “ذكريات الريسوني وتحقيقات الناسك”، إذ أول ما يشد انتباهك فيها، عزوف ضمني، وحرج مبطن، وقلق مسكوت عنه، يبرر من خلاله الدكتور أحمد الريسوني اقتحامه مجال كتابة الذكريات الذي لم يلتفت إليه، ولم يحدث به نفسه يوما، لأن “الأمر كان محسوما عندي، لا أترك واجباتي، لأكتب مذكراتي” (ص 23). حتى إذا غالبته الرغبة في مخالفة ما ذهب إليه بعد ثلاثة أسطر، عاود التبرير مرة ثانية: “ليس عندي وقت، وليس عندي مثل ما عند هؤلاء لأحكيه” (ص 23). ثم لا يملّ مرة ثالثة من إعادة بسط وجهة نظره في ما هو مقبل عليه: “من وجهة نظري وزاوية تخصصي، كنت أنظر إلى هذا العمل باعتباره من المستجدات والتحسينيات، ومن ملح العلم لا من صلبه، حسب تقسيم الشاطبي وتعبيره” (ص 24). إنها وجهة نظر في التعاطي مع هذا النوع من الكتابة، تمّ التعبير عنها بأساليب مختلفة، لتشكل جزءا معتبرا من المقدمة التي لم تلتفت لا إلى سبب التأليف، ولا شرط الكاتب في التأليف، ولا المنهج المتبع في ترتيب ما سيكتب… ليس لجهل الدكتور أحمد الريسوني بشروط كتابة المقدمة، ولكن كأني به كتبها على عجل لينفض يديه من عمل سينجح “الدكتور الناسك –تدريجيا– في انتزاع موافقة متثاقلة مني على أن أحكي له أو أملي عليه بعض الذكريات… فكان يكتبها بيده، أو يسجلها صوتيا بهاتفه (…) ومضينا على هذا النحو بضع سنين”. (ص 24).
العنوان الفرعي وشفاء الغليل
ما إن يشرع القارئ في تقليب صفحات الكتاب حتى يجد نفسه مشدودا إلى ما سطر فيه، منبهرا بعمل غير مسبوق في مجال التأريخ للحركة الإسلامية: حيث الغزارة في المعلومة، والصراحة في الطرح، والسلاسة في التعبير… إنها ذكريات و أحداث ووقائع ومعلومات وشهادات تخبر -أولا وأخيرا- بمقام الرجل، وتؤكد مكانته في تاريخ الحركة الإسلامية، وتخبر بشجاعته في سرد ما عاشه وعايشه على مدى عقود من عمر الدعوة والحركة، إذ مكّنه موقع الصدارة أن يعايش أكثر، وأن يعرف أكثر، وأن يطّلع أكثر، وأن يكون له ما يحكيه للأجيال التي لم يكتب لها أن تعيش بعضا مما كان.
الكتاب إذا، يؤسس بصدق مضمونه، ومصداقية صاحبه، لعمل انتظره أبناء الصحوة، والمهتمون بمسار الحركة الإسلامية المغربية منذ أمد بعيد. ولعل الطبعات المقبلة ستتيح للدكتور أحمد الريسوني فرص التنقيح والزيادة، من خلال ما سيثيره الكتاب من تفاعل سيلبي دون شك حاجتنا إلى هذا النوع من التأريخ الذي يأتي من موقع الشهود والمعايشة.
على سبيل الختم
لا يفوتني هنا أن أنوّه بدور الدكتور الحاج محمد الناسك كالذي سمح له رصيده المعرفي وتخصصه العلمي ليحرر هذا العمل انطلاقا مما توفر لديه من وثائق أو ما جمعه من أفواه الرجال، لتكون الحصيلة مادة كافية تؤسس لعملية تأريخ حقيقي للحركة الإسلامية المغربية. ولعله بهذا الإنجاز يقدم للباحثين الشباب، ولمراكز الدراسات والأبحاث القدوة في الالتفات إلى هذا النوع من الكتابة، لأن الحاجة إليه ماسة قبل أن يسبق القدر بتغييب من يحملون في صدورهم الكثير عن التجربة الإسلامية المغربية التي تميزت في مناحي كثيرة.
نرجو أن يكون كتاب “ذكريات أحمد الريسوني” مقدمة لأعمال أخرى نراها تترى مستقبلا، و(قل عسى أن يكون قريبا).





















