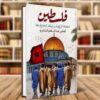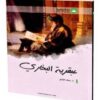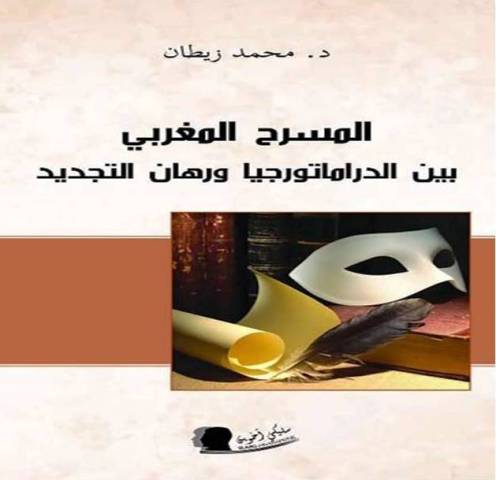
المحتويات
تقديم
الدراماتورجيا هي مصطلح واسع يشير إلى فن بناء النصوص الدرامية وتحليل العلاقة بين المضمون والشكل المسرحي. بحيث يتضمن فن تأليف المسرحيات، والنقد المسرحي، والإخراج المسرحي، ودراسة تلقي العرض المسرحي من قبل الجمهور. كما يمكن أن تشمل تحليل أي عمل فني بصري أو أدائي كعرض مسرحي أو فيلم. وتُعرف بأنها “فن تأليف المسرحيات” بالمعنى الحرفي. وتهتم الدراماتورجيا في فن بناء المسرحية بالبنية الداخلية للنص الدرامي وكيفية بناء الأحداث والشخصيات. وبالنسبة لفن تحويل اللغات المسرحية، تتعلق بترجمة النصوص المسرحية إلى لغة العرض المسرحي. وتركز على دراسة العلاقة بين المضمون والشكل، وتحلل كيفية ظهور المضمون المسرحي كشكل مرئي أمام المتفرجين. ويشارك الدراماتورج في العملية الإبداعية للنص والعرض، ويساهم في تطوير الكتابة الدرامية، أو الإعداد الجماعي للمسرح التوليفي، أو حتى في مجالات الرقص والأشكال التعبيرية المرتبطة بالفن التشكيلي.
كما تطبق الدراماتورجيا على الحياة الاجتماعية، حيث ترى الأفعال الاجتماعية كمسرحيات يقوم فيها الأشخاص بأداء أدوارهم. وتُستخدم الدراماتورجيا في التحليل المسرحي والنقد الأدبي لفهم بنية الأعمال الدرامية وتطورها.
ويأتي كتاب الدكتور محمد زيطان “المسرح المغربي بين الدراماتورجيا ورهان التجديد” ليجيب عن سؤال الدراماتورجيا دون الخوض في تفاصيل المفهوم، ويركز على دراماتورجيا مغربية لمسرح متعدد، والقيام بتطبيقات عن مسرحيتين “حكاية الزمان” و”دموع بالكحول”. والكتاب صدر عن مطبعة سليكي أخوين –طنجة، 2021م، ويقع في 93 صفحة.
مضامين الكتاب
المؤلف لا يدعي أنه بمقدوره رسم ملامح واضحة وثابتة لمفهوم “الدراماتورجيا” في سياق دينامية المسرح المغربي بكل أطيافه الإبداعية، وما أفرزته من زخم في الأعمال وتعدد في التجارب. لكنه سيعمل على مقاربة بعض الجوانب، التي يراها عاكسة لحقيقة تطور الاشتغال الدراماتورجي إلى جانب الاشتغال الإخراجي، خدمة لفكرة التحولات المشروطة بسياق ثقافي وفني عام. فإذا كان البعض يعتقد بأن الدراماتورجيا باتت تقدم حلولا سحرية للمنجز المسرحي، خاصة فيما يتعلق بإيجاد حل لندرة النصوص المسرحية، أو لعدم ملائمة بعضها لخصوصية الكتابة المعاصرة مبنى ومعنى. فتتحول بالتالي إلى مجرد أداة للقطع واللصق، أو للحشو وتجفيف العرض من فكرة أو أطروحة جمالية وفلسفية خدمة لمساحات كبيرة، يطغى عليها نوع من الكولاج، ما بين مقطع شعري وحوار هامشي عابر وغناء ورقص وصخب في غياب تام للدراما ولمبدأ “العلية”. حتى وكأننا نوقن بأن الأمر يتعلق بتغيير جذري لمفهوم اللحظة الجمالية في المسرح. (مقدمة الكتاب ص 3\4)
إن المشهد المسرحي عرف تحولات كبرى وأصبحنا أمام واقع جعل مجال الكتابة الدرامية لا يقتصر على المتخصص باعتباره كاتبا مسرحيا ذا فلسفة ورؤية فنية خاصة ومشروع إبداعی منسجم. بل تسارع عدد من المخرجين والممثلين إلى التأليف أو إلى العمل الدراماتورجي من منطلقات تحمل هاجس البعد الإخراجي/الركحي، أكثر مما تلتفت إلى البعد الفكري والجمالي وإلى الطرح الدرامي العميق، وما يقتضيه من طرز خاص للحوار بحرفية ودربة عالية، فكانت النتيجة أعمالا تندثر بمجرد عرضها واستغلالها في موسم مسرحي دون آخر.
ويؤكد زيطان على أن الدراماتورجيا هي أشمل وأعمق من ذلك بكثير. وإن كانت تعريفاتها تتعدد وتختلف من هذا الباحث إلى ذاك، ومن هذه المدرسة الفنية إلى تلك… إلا أنها جميعها تثبت بأننا أمام كتابة نص جديد… نص مشهدي هو باختصار: نص العرض الذي نجد ملامحه الأولى في أعمال برتولد بريشت، وكانتور، وهاينر موللر، وولفغانغ فاينس وآخرين ممن يتمتعون بـ”ذهنية دراماتورجية” على حسب تعبير الناقد الفرنسي برنار دوت. وهي ذهنية لا تتأتى بمجرد قراءة أو كتابة نص مسرحي فوق أريكة مريحة، أو بالاطلاع على هذا الاتجاه الفني أو تلك المدرسة المسرحية بين مدرجات الجامعة أو بين سطور بعض المؤلفات والأبحاث. إنها ذهنية تتطلب خبرة بعوالم المسرح الظاهرة والخفية، تحتاج إلى تمرس بالمجال، ما بين متابعة التداريب واستئناس بأجواء العروض، وانشغال بحيثيات التلقي الخاصة بكل عرض مع انخراط فعلي في تجربة مسرحية للتعرف عن قرب على هواجس الممثل مع هذه النوعية من المقاطع الحوارية أو تلك، مع هذه الحركة أو ذلك الأداء …للتعرف على إكراهات إنجاح رؤية سينوغرافية وإخراجية نظرا لطبيعة مكان العرض أو لخصوصية الجمهور… إنها باختصار ذهنية متفتقة عن حياة مسرحية كاملة، تصل بالعرض إلى عتبة الإيقاع المثالي . (مقدمة الكتاب ص 4\5)
وقد تضمن الكتاب المحاور التالية: سؤال الدراماتورجيا- در اماتورجيا مغربية لمسرح متعدد- الخطاب المسرحي بين النصي والمشهدي- بين النص والعرض يتأسس الاشتغال الدراماتورجي- مسرحية «حكاية الزمان» مقاربة سيميائية- من مسرحية حكاية الزمان- دموع بالكحول دراما نفسية… رجل وثلاث نساء وسرد.
خلاصة
إن صيرورة المنجز المسرحي المغربي إذن، والذي لا يعد عملا «حكاية الزمان» و «دموع بالكحول» سوى مجرد نموذجين له، لا يمكن أن تتبلور كصيغة إبداعية، ما لم يخضع الفنان أدواته ومفرداته إلى مستوى البحث والتجريب الممنهج. فالاشتغال الواعي والتوظيف المبتكر للعلامات والرموز ضمن بنية الحدث الممسرح، يجعلها تختزن بالرؤى والدلالات المتعددة، التي تنقل الأفكار من إطارها الذهني المجرد إلى التجسد الملموس. وبالتالي تكتسب التجربة المسرحية جوهر حيويتها، منساقة نحو المغايرة والتجدد، دون التقوقع في ظل تیارات جافة تدعو بتعنت إلى تقديس التراث والعيش في بؤر فرجوية محلية.