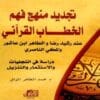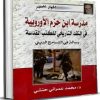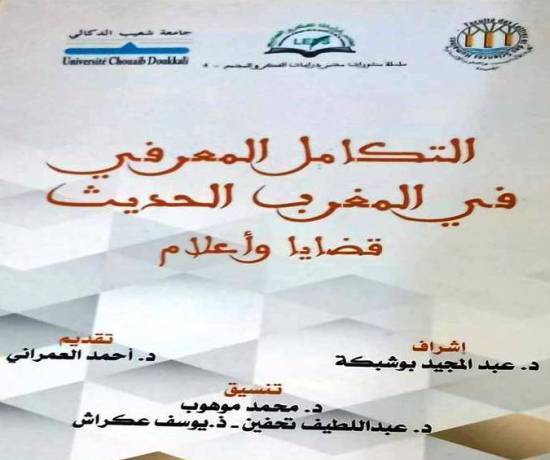
المحتويات
توطئة
تعد المعرفة من خصائص البشر التي تُميِّزُهم عن غيرهم من الكائنات، ويَتفاوت الناس في مستوى المعرفة الذي يمتلكونه، كما تتفاوت الأمم في كيفية تعاطيها معها اهتمامًا وإهمالاً، بما ينعكس على تقدُّمها وتحضُّرها، فمنها ما يَترك الناس وما يختارونه من اختصاصات واتجاهات معرفية، ومنها ما يُدير الحركة المعرفية ضمن خطط ورؤى تحرص على تعميق التخصص وإحداث التوازن والتكامل المعرفي المنشود.
إن التكامل المعرفي بين العلوم له عمقٌ تاريخي وأصالةٌ زمنية، فهو قديم قِدَم تلك المعارف والعلوم نفسها، فالعلم لا ينشأ بمعزل عن غيره، بل تتضافر العلوم وتتكاتف ويكمِّل بعضها بعضًا، حتى تشكِّل بمجموعها نسيجًا ثقافيًا وحضاريًا لشعب من الشعوب، أو للبشرية جمعاء.
وكل العلوم مطلوبة إما ابتداء أو تبعًا، وإلى هذا المعنى يشير عالم أهل الأندلس ابن رشد الحفيد حيث قال: «إنَّ العلوم صنفان: علوم مقصودة لذاتها وعلوم ممهدة للإنسان في تعلم العلوم المقصودة لنفسها»[1]. فعلوم الوحي تحتاج العلوم الإنسانية في التأصيل والاجتهاد، والعلوم الإنسانية تتطلب مستويات مادية وأخرى روحية.
ويقصد بالتكامل المعرفي الصورة العلمية المتكاملة للوجود والذات، المتحققة بتفعيل الرؤية الإسلامية في كل مجالات المعرفة، سواء أكانت علومًا طبيعية أم اجتماعية أم إنسانية أم شرعية[2]. ويؤكد هذا التعريف على أنَّ العلوم مكمِّلةٌ لبعضها، وأنها لا تكتمل إلا برؤية عقدية صحيحة في مختلف مجالاتها.
ويأتي هذا الكتاب الجماعي حول “التكامل المعرفي في المغرب الحديث.. قضايا وأعلام” ليسهم في بناء الإنسان السوي، ويكون لبنة أساسية من اللبنات التي تعنى بإعادة تشكيل عقل المسلم، أسهم فيه فيه مجموعة من الباحثين، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد بوشبكة، وتقديم الدكتور أحمد العمراني، ونسق أعماله كل من د. محمد موهوب، ود. عبد اللطيف تحفين، وذ. يوسف عكراش.
مضامين الكتاب
إن الحديث عن التكامل المعرفي الذي يعني تلك الصورة العلمية المتكاملة للوجود والذات المتحققة بتفعيل الرؤية الاسلامية في كل المجالات المعرفية شرعية كانت، أو طبيعية أو اجتماعية أو إنسانية. وهو ما لا يتحقق ولا يتم إلا باعتماد مصدري المعرفة المتمثلين في الوحي قرآنا وسنة، ثم في الكون بمجالاته الثلاثة: الطبيعة والمجتمع والنفس، مع الاعتماد على الأدوات الأساس للاستمداد: الحواس البشرية والعقل. إذ بعد تنوع العلوم وتعددها، تضخم التخصص الواحد حتى تفرع على ذاته، غدت الأدوات بعيدة عن الأهداف والغايات، ونشأ في الفكر مع مرور الزمن أن الكثير من العلوم تدرس لذاتها بعيدا عن قطف ثمارها.
وهذا ما لوحظ في زمننا وانتشر بين مثقفينا حيث تجد أستاذا في الجامعة يدرس تخصصا دقيقا دون أن تكون له علاقة بما يقرب منه من تخصصات، كمن يدرس الفقه القديم دون الحديث أو الرياضيات دون العلوم الطبيعية، وهلم جرا دون الأصول أو علوم القرآن والتفسير دون الحديث أو النحو دون البلاغة أو الأدب القديم دون الحديث، أو الرياضيات دون العلوم الطبيعية… وهكذا تفرعت التخصصات ووصلت دعاوى التخصص مداها حتى أصبح كل واحد يتخصص في جزء ذري من موضوع دراسي ضمن تخصص كبير وهذا أفرع العلوم تخصصاتها… وأنسى الباحث التفاعل بين جميع تخصصاتها، مما غيب المفهوم الشامل للمعرفة، وساهم في تدميرها وأضعف الالتقاء الضروري بين العلوم والبشرية لإعادة صياغة الوضع البشري.
فالتفتح على العلوم جملة دون انتقاء يرفع من المستوى الفكري للفرد والمجتمع، ويمكنه من التعامل مع المستجدات كما ينبغى ويلزم. ويمكن تقديم نماذج كثيرة برعت في علوم متعددة وتفوقت فيها وأخذت من كل علم بطرف حسب تعبير ابن خلدون. (أنظر مقدمة الكتاب، ص: 8/7).
ويمكن استحضار العديد من العلماء والفقهاء الموسوعيين الذين استوعبوا العلوم بتفاصيلها ونهلوا من معارفها وأبدعوا في تطويرها ونفع البشرية بها، وتنوعت تصانيفهم الكثيرة في العلوم المختلفة من تفسير وحديث وفقه وغيره، واتسمت بالغزارة والقوة. والإحاطة من أشهرها اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، تاريخ الأمم والملوك المشهور بتاريخ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن وغيرها، إضافة إلى بعض المؤلفات التي بدأ تأليفها وحال مونه دون إتمامها.
وهذا لا ينقص من عبقرية وهمة المحدثين الذين عاصرونا، ممن اقتدوا بالسلف وساروا على نهجهم وكان لهم باع في الاطلاع على العلوم فوسموا بدورهم بالموسوعيين، ممن سيتعرض الكتاب لبعضهم بالتعريف والدراسة والبحث.
ولعل اشتغال المركز الأكاديمي وتخصيصه لعدد خاص لموضوع التكامل المعرفي إشارة واضحة لإعادة توجيه الفكر للاهتمام به نظريا وعمليا والعمل الجاد لإحياء فكرة الاشتغال بالكل بدل الجزء والتنبيه على ضرورة العودة إلى الأصل الذي يحقق التعرف على العلوم الأخرى لتحقيق الموضوعية التي تعين على تطوير الأفكار وتحسينها، ويحسن عجلة التجديد والاجتهاد للوصول فيما بعد إلى إعادة الاعتبار للتكامل المعرفي داخل المنظومة التعليمية ببلادنا، بل في النهوض بالدور الحضاري المنشود للأمة.
وقد ساهم في هذا العمل المتميز ثلة من الباحثين وجاءت عناوين بحوثهم متنوعة ومتكاملة جمعت في سفر من 350 صفحة، صدر عن منشورات مختبر دراسات الفكر والمجتمع.
وقد تضمن الكتاب المقالات التالية:
- جامعة القرويين نموذج واقعي للتكامل المعرفي، (د. عبد المجيد بوشبكة).
- التكامل المعرفي بين الكلمات والحروف، (ذ. لحسن قراب).
- المشارب المعرفية في الدراسات الأدبية المغربية “لعبة النسيان، دراسة تحليلية نقدية” للدكتور إدريس الناقوري أنموذجا، (د. عبد الجبار لند).
- التكامل المعرفي في آثار القاضي محمد يوسف بن عبد الحي الرقيبي، (د. خليل الواعر).
- اجتهادات المجلس العلمي الأعلى والتكامل المعرفي، (ذ. عبد العالي أودقي).
- طه عبد الرحمن والنظرية التكاملية في تقويم التراث، (ذ. جواد الحريزي).
- رؤية بلبشير للتكامل المعرفي وثمراته العلمية والاجتماعية، (ذ. الشرقي قصاب).
- الرؤية التكاملية في فكر محمد بن العربي العلوي، (ذة. زهراء الشرفي).
- الرؤية التكاملية في الفكر الإصلاحي عند رجالات المغرب العربي: “علال الفاسي– عبد الحميد بن باديس – الطاهر بن عاشور”، (ذ. عبد الله برزكي).
- تصنيف العلوم عند العلامة اليوسي والرد في خدمة التكامل المعرفي، (ذ. عثمان النديري).
- معالم الرؤية التكاملية في فكر الأستاذ أبي زيد المقرئ الإدريسي، (ذ. هاجر المهدي).
- التكامل المعرفي عند إدريس الكتاني من خلال أرائه الفكرية، (ذ. عبد القادر بوعلافة).
- التكامل المعرفي عند الشيخ محمد رياض، (ذ. الجيلالي الساجعي).
- التكامل المعرفي عند أحمد الريسوني، (ذ. شيماء عناب).
- الرؤية التكاملية في فكر عباس الجراري، (ذ. نهيلة كاس).
- الرؤية التكاملية في فكر محمد التاويل، (ذ. يونس حمدان).
- معالم التكامل المعرفي في فكر المهدي المنجرة، (ذ. الرحيم كمال).
- التكامل المعرفي ودوره في إصلاح مناهج المنظومة التعليمية… (د. بلقاسم الراوي).
- أهمية تحقيق التكامل المعرفي عند المفسر في ظل المعرفة المعاصرة… (ذ. يوسف عركاش).
خلاصة
إن من يمعن النظر حول المعارف والعلوم، سيظهر له بكل جلاء علاقة التأثير والتأثر، والاستمداد والإمداد التي تربط بينها لتوافقها وتناسقها وتداخلها وتفاعلها على مستوى المناهج، وإن تنوعت المجالات واختلفت الموضوعات، لأنها علوم تفتقر إلى بعضها كمالا لا وجوداً، كما يستثمر بعضها آليات منهجية يقعدها البعض الآخر. وقد تضمن الكتاب التعريف بأعلام في زماننا ممن اتسموا بالموسوعية واطلعوا على علوم كثيرة تضمنتها مشاريعهم العلمية، وبرز فيها التكامل المعرفي جليا مما يفيد الباحثين والمهتمين، ويميط اللثام عن هؤلاء الموسوعيين ويعرف ببعض منجزهم الفكري والعلمي.
المراجع
[1] الضروري في صناعة النحو، ابن رشد الحفيد، ص 99.[2] انظر: التكامل المعرفي ودوره في قيام الحضارة الإسلامية وبناء الأمة المحمدية، لياسين مغراوي، مدونة «تعليم جديد».