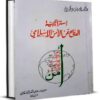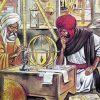المحتويات
مقدمة
تعد القصبة الإسماعيلية بتادلة إحدى أبرز المعالم التاريخية التي شيدها السلطان المولى إسماعيل في سياق مشروعه العمراني والعسكري الرامي إلى بسط نفوذ الدولة وضبط المجال المغربي خلال القرن السابع عشر. وقد اكتسبت هذه القصبة أهمية استراتيجية بفضل موقعها على ضفاف نهر أم الربيع، حيث جعلت منها السلطة قاعدة عسكرية متقدمة لمراقبة الطرق الرابطة بين شمال المغرب وجنوبه، ولتطويع القبائل المجاورة. ومع مرور الزمن، تحولت هذه القصبة من حصن دفاعي إلى النواة الأولى لنشأة مدينة قصبة تادلة، إذ اجتمع حولها السكان والتجار، فانبثق منها نسيج عمراني واجتماعي سرعان ما تطور ليمنح المدينة هويتها الخاصة. ومن ثم فإن دراسة القصبة الإسماعيلية تمثل مدخلا أساسيا لفهم نشأة وتطور قصبة تادلة عبر التاريخ.
القصبة الإسماعيلية.. من حصن عسكري إلى مركز حضري
تقع مدينة قصبة تادلة على بعد 30 كلم من مدينة بني ملال، وقديما لم تكن سوى محطة عبور تجارية تربط بين فاس ومراكش، ومع قيام الدولة العلوية، وانتقال أمرها إلى السلطان المولى إسماعيل عرفت هاته المحطة، ظهور أول نواة حقيقية في نشأتها.[1]
وتعد القصبة الإسماعيلية النواة الأولى لمدينة قصبة تادلة، حيث أُسست في إطار المشروع العمراني والعسكري للمولى إسماعيل الرامي إلى إعادة توحيد أطراف المغرب بعد مرحلة من التصدع السياسي والاضطراب القبلي الذي عم البلاد على أوسع نطاق خلال القرن السابع عشر. وقد ارتبط تأسيسها -كغيرها من القلاع والقصبات التي شيدت في عهده- بإستراتيجية دفاعية وأمنية هدفت إلى تكريس سلطة الدولة المركزية، وضبط المجال الترابي، وإعادة إنتاج منظومتها النسقية داخل الفضاء المغربي.
وقد شهدت منطقة تادلة خلال هذه الفترة ازدهار إحدى أهم الزوايا الدينية، وهي الزاوية الشرقاوية في أبي الجعد التي ذاع صيتها في مختلف أرجاء المغرب، وأصبحت مركزا روحيا وعلميا ذا إشعاع واسع. وفي هذا السياق كان للسلطان المولى إسماعيل موقف خاص من زاوية أبي الجعد ومنطقة تادلة وصلحائها، ما دفعه إلى تشييد قصبة دفاعية على الضفة اليمنى لنهر أم الربيع. وقد جعل منها قاعدة إستراتيجية لانطلاق حملاته السلطانية، بهدف إخضاع القبائل المجاورة وضبط المجال، وكذا منعها من ارتياد مراعي السهل دون إذن الدولة، وهو ما يعكس تداخل البعد الديني بالبعد السياسي والعسكري في سياسة المولى إسماعيل تجاه المنطقة.
وهكذا أضحت قصبة تادلة حلقة مركزية ضمن سلسلة القصبات التي شكلت ما يعرف بـ”الجبهة الرابعة” التي أمر السلطان المولى إسماعيل بتشييدها، قصد تطويق قبائل الجبل ومنعها من ارتياد مراعي السهل الخصبة. وبهذا الدور غدت القصبة قاعدة عسكرية متقدمة، تنطلق منها الحملات السلطانية لتطويع قبائل صنهاجة الأطلس، وتحصيل الجبايات، وإرساء هيبة الدولة. كما أقيمت بها حامية عسكرية دائمة تتكفل بتأمين الطريق السلطانية، وجعلها السلطان محطة رئيسة لاستراحة محلاته السلطانية، حيث كان يتوقف بها للنظر في شؤون قبائل المنطقة وضبط علاقاتها بالسلطة المركزية.[2]
وإلى حدود أواسط القرن السابع عشر، لم تكن قصبة تادلة تتجاوز في بنيتها العمرانية حدود القصبة الإسماعيلية ذات الطابع الحصين، والتي يمكن اعتبارها بمثابة ثكنة عسكرية تقليدية. ومن خلال هذا المعطى العمراني تتجلى بوضوح الوظيفة العسكرية التي اضطلعت بها المدينة في تلك الحقبة، باعتبارها قاعدة دفاعية ومركزا لحامية سلطانية أكثر منها فضاء حضريا مكتمل المعالم.[3]
وبما أن القصبة الإسماعيلية شكلت النواة الأولى لمدينة قصبة تادلة، فإن المستوى العمراني للمنطقة ظل، في بدايات التأسيس، محصورا داخل أسوار القصبة، التي استمرت في أداء دورها الأمني المتمثل في مراقبة الطرق الرابطة بين شمال المغرب وجنوبه، ورصد تحركات سكان الجبال. وقد حافظت القصبة على هذه الوظيفة العسكرية طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر، قبل أن تعرف توسعا تدريجيا في مساحتها وعدد سكانها، الأمر الذي مهد لتحولها من مركز دفاعي محصن إلى نواة حضرية آخذة في النمو.
قصبة تادلة خلال القرن التاسع عشر.. قراءة في معالمها القديمة
احتلت مدينة قصبة تادلة خلال القرن التاسع عشر مكانة بارزة في تاريخ منطقة تادلة، إذ واصلت أداء وظيفتها العسكرية المتمثلة في مراقبة الطرق الرابطة بين شمال المغرب وجنوبه، إضافة إلى إخماد ثورات قبائل الأطلس المتوسط. وقد أدى هذا الدور إلى توسع مساحتها وارتفاع عدد سكانها بشكل تدريجي، مما جعلها تتحول إلى مركز رئيسي لـ”كَيش آيت ربع” وقاعدته الأساسية. واقترن اسمها بهذا الكَيش، فوردت في المصادر تارة باسم القصبة التادلوية، وأخرى باسم القصبة السعيدة، وأحيانا باسم القصبة الربيعية، وهو ما يعكس تنوع أدوارها ومكانتها في البنية السياسية والعسكرية للمنطقة.[4]
لقد اتسمت المدن المغربية خلال القرن التاسع عشر بكونها فضاءات عمرانية خضعت لتنظيم منسجم مع قواعد وخصائص المدن الإسلامية، كما هو الحال بالنسبة للمدينة العتيقة بقصبة تادلة، التي شُيدت وفق تصور يراعي التكامل بين المكونات المجالية للمدينة وأسسها الاقتصادية. وفي هذا السياق، يشير ابن الأزرق في كتاباته حول تأسيس المدن إلى أصلين جوهريين ينبغي مراعاتهما: “دفع المضار وجلب المنافع”.
ففي ما يخص دفع المضار؛ يؤكد على ضرورة وضع التحصينات اللازمة، وأن يُختار للمدينة موضع دفاعي مرتفع أو عند استدارة نهر، مع الحرص على نقاء الهواء. أما بخصوص جلب المنافع؛ فيشترط توفر الماء، ويفضل أن تُبنى المدينة على ضفاف نهر، إضافة إلى وجود المراعي والقرى المحيطة. ومن الملاحظ أن هذين الأصلين قد تحققا بالفعل في قصبة تادلة، التي جمعت بين المناعة الدفاعية بفضل موقعها الاستراتيجي على نهر أم الربيع، وبين الموارد الطبيعية التي ضمنت لها مقومات الاستقرار والنمو[5].
لقد تميزت قصبة تادلة بكونها لم تتخذ شكل المدينة المغربية التقليدية بالمفهوم الدقيق، ويعزى ذلك إلى حداثة الاستقرار بها، وإلى كون الجماعات البشرية التي أسست مجالها كانت في معظمها من القبائل الأمازيغية المعتادة على حياة الترحال. وإذا قارنا المدينة القديمة، وبخاصة حي “الزرايب”، مع أنماط المدن العتيقة الأخرى في المغرب، يمكن الخروج بالملاحظات الآتية:
- أولا: عندما كانت أغلب المدن المغربية التقليدية محاطة بأسوار دفاعية، فإن حي “الزرايب” بقصبة تادلة لم يعرف هذا العنصر، بل إن البقايا الأثرية التي يمكن أن تدل على وجود سور تكاد تنعدم.
- ثانيا: غياب السور جعل الأزقة تنفتح مباشرة على الخارج، وهو ما استدعى وضع أبواب خاصة بكل زقاق أو درب، كوسيلة بديلة للتحصين.
- ثالثا: بخلاف المدن التقليدية حيث تنتظم الدروب غالبا حول بيوت الشرفاء والأعيان، فإن دروب قصبة تادلة كانت تنتظم حول بيوت أعيان القبائل، مما يعكس البنية القبلية؛ إذ جرى توزيع المجال حسب تعدد القبائل من جهة، وتعدد فخداتها من جهة أخرى.
- رابعا: على مستوى التنظيم الوظيفي للمدينة، لم يُسجل وجود الفصل الواضح بين المجالات السكنية والاقتصادية كما هو الشأن في المدن التقليدية الأخرى، وهو ما يؤكد الطابع الخاص لقصبة تادلة وارتباطها بالخصوصيات القبلية المحلية أكثر من ارتباطها بالنموذج الحضري الإسلامي الكلاسيكي.[6]
لقد احتلت قصبة تادلة مكانة متميزة في تاريخ المنطقة منذ أن اتخذها السلطان المولى إسماعيل مقرا دائما لحاميته العسكرية. وقد ساهم الاستقرار البشري، على شكل تجمعات قبلية بضواحي القصبة، في تأسيس النواة الحضرية الأولى بالمنطقة مع نهاية القرن السابع عشر. وتجدر الإشارة إلى أن حداثة التعمير والاستقرار، إضافة إلى الطبيعة القبلية للمجموعات المنتجة للمجال، جعلت التنظيم الحضري لمدينة قصبة تادلة يختلف عن أنماط التنظيم التي ميزت كبريات المدن المغربية مثل فاس ومراكش والرباط، الأمر الذي منحها طابعا محليا خاصا يجمع بين البنية الدفاعية والخصوصية القبلية.
قصبة تادلة في عهد الحماية.. الثابت والمتحول
لقد فرضت الحماية الفرنسية نفوذها على مدينة قصبة تادلة يوم 7 أبريل 1913م، إذ كان لموقعها الاستراتيجي على ضفاف نهر أم الربيع دور أساسي في استقطاب اهتمام القوات الفرنسية. وقد عملت سلطات الحماية على تدعيم وظيفتها الدفاعية من خلال إنشاء قواعد عسكرية جديدة جعلت منها مركزا للسيطرة على المجال، ووسيلة لإخضاع القبائل المتمردة على المخططات الاستعمارية في جبال الأطلس المتوسط. ومن القصبة الإسماعيلية نفسها تم التصدي للانتفاضة القبلية التي اندلعت ببني ملال يوم 15 ماي 1915م، قبل أن تنطلق منها الحملات العسكرية الفرنسية نحو المنطقة، وهو ما تُوج باحتلال بني ملال سنة 1916م. وهكذا تحولت قصبة تادلة إلى قاعدة محورية في الإستراتيجية العسكرية الاستعمارية، تؤدي وظيفة مزدوجة: ضبط المجال المحلي، وتأمين التوسع نحو أعماق الأطلس.[7]
وفي هذا السياق، أقدمت سلطات الحماية الفرنسية على إنشاء معسكرين عسكريين حول مدينة قصبة تادلة: أحدهما في شمالها (Camp Nord) والآخر في جنوبها (Camp Sud). وقد أُقيم المعسكران فوق أراض جماعية كانت في الأصل مخصصة لانتفاع فخدة سمكت، إحدى فروع قبيلة آيت ربع، التي امتلكت حق الانتفاع بالأراضي المجاورة للقصبة منذ القرن الثامن عشر. وبهذا الإجراء، لم يقتصر الوجود العسكري الفرنسي على تعزيز الوظيفة الدفاعية للقصبة، بل مس أيضا بحقوق القبيلة في استغلال المجال، مما مثل أحد أبرز أوجه التحول في البنية المجالية والاجتماعية للمنطقة خلال فترة الحماية.[8]
لقد أدى استقرار المعمر الفرنسي بمدينة قصبة تادلة، وتعزيز وظيفتها العسكرية، إلى توافد أعداد متزايدة من المهاجرين الأجانب، تمثلوا أساسا في عناصر الجيش وموظفي الإدارة والعاملين في المجال الفلاحي. وقد استدعى هذا الوضع تشييد وحدة مجالية خاصة لإيوائهم، تجلت في إنشاء الحي الإداري، الذي بني وفق تصور عمراني ينسجم مع النمط الأوروبي في معاييره الهندسية والبنائية. وقد راعى هذا البناء الجديد ضوابط الهندسة المعمارية الأوروبية، فأسفر عن فضاء عمراني متميز بجماليته وتنظيمه، بما يعكس الفلسفة العامة التي هيمنت على سياسة التعمير الاستعماري بالمغرب. وعلى المستوى المركزي، تزامن إنشاء هذا الحي مع الفترة التي كان فيها المهندس هنري بروست (Henri Prost) يضع أسس تخطيطاته العمرانية الكبرى، التي شكلت تحفا جمالية ومعمارية بمدن المغرب خلال العشرينيات من القرن العشرين[9].
وهكذا؛ شهدت مدينة قصبة تادلة بروز ازدواجية عمرانية واضحة، بين الطراز التقليدي المتمثل في المدينة القديمة التي شيدت وفق مرجعية العمارة الإسلامية، وبين النمط العمراني الجديد الذي استند إلى النماذج الغربية والمتجسد في الحي الإداري. وقد أفرز هذا المسار التاريخي مشهدا حضريا متفردا، يجمع بين العمق التراثي والحداثة التي جاء بها المستعمر. وتجسيدا لهذه الأهمية، تم في يناير 1916م تصنيف القصبة الإسماعيلية والقنطرة القديمة على وادي أم الربيع ضمن لائحة التراث الوطني، وهو ما يبين لنا القيمة التاريخية والمعمارية التي حظيت بها هذه المعالم في سياق السياسة التراثية بالمغرب خلال فترة الحماية.
خاتمة
لقد تبين لنا من خلال تتبع المسار التاريخي والعمراني لمدينة قصبة تادلة أنها مرت بتحولات جوهرية منذ تأسيسها كقصبة إسماعيلية ذات وظيفة عسكرية صرفة، إلى أن تحولت تدريجيا إلى مركز حضري قائم بذاته. فقد شكل موقعها الاستراتيجي على ضفاف أم الربيع عاملا حاسما في بروزها كقاعدة دفاعية ومحطة للتحكم في المجال، ثم كفضاء للتفاعل بين القبائل والسلطة المركزية.
ومع دخول الحماية الفرنسية، تعزز هذا البعد العسكري وترافق مع بروز تباينات مجالية واضحة، تجلت في ازدواجية عمرانية بين النسيج التقليدي والحي الإداري الأوروبي. وهكذا غدت قصبة تادلة مشهدا حضريا فريدا، يحمل في ثناياه بصمة التراكمات التاريخية ويعكس في الآن ذاته دينامية المجال المغربي في علاقته بالتحولات السياسية والعسكرية والعمرانية.
المراجع
[1] محمد ميوسي، الجهاز الحضري بتادلا: قصبة تادلة، القصيبة وزاوية الشيخ، مراكز قديمة في تحول، المجال، الثقافة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال، جامعة القاضي عياض، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1992م، ص13.[2] أحمد عمالك، ملامح من تاريخ قصبة تادلا، ورد في: "تادلا : التاريخ، المجال، الثقافة، الملتقى العلمي لمنطقة تادلا، أيام 15-16-17أبريل 1992م، جامعة القاضي عياض، كلية الاداب والعلوم الانسانية بني ملال، طبع بمطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 1993م، ص91.
[3] محمد ميوسي، الجهاز الحضري بتادلا، مرجع سابق، ص14.
[4] محمد بن البشير بوسلام، تاريخ قبيلة بني ملال 1854-1916م، جوانب من تاريخ دير الأطلس المتوسط ومنطقة تادلا، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1991، ص211.
[5] أحمد عمالك، ملامح من تاريخ قصبة تادلا، مرجع سابق، ص87.
[6] محمد ميوسي، الجهاز الحضري بتادلا، مرجع سابق، ص 205.
[7] محمد بن البشير بوسلام، تاريخ قبيلة بني ملال 1854-1916م، جوانب من تاريخ دير الأطلس المتوسط ومنطقة تادلا، مرجع سابق، ص223.
[8] محمد ميوسي، الجهاز الحضري بتادلا، مرجع سابق، ص 34.
[9] محمد ميوسي، الجهاز الحضري بتادلا، مرجع سابق، ص37.