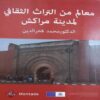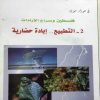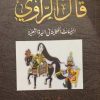المحتويات
توطئة
لم يكن الجيل الأول من المؤرخين يهتم بالجوانب الفلسفية والنظرية للتاريخ، وكان كُتَّاب التاريخ يعتمدون على المناهج التقليدية التي تتصل بعلم الحديث، كمنهج المتن والسند، ومنهجية الجرح والتعديل، ولم تكن هناك مناهج تهتم بدراسة معنى الحقيقة التاريخية، وجوهر المعرفة التاريخية، وتمييز الخطأ من الصواب والممكن من المستحيل[1]، مع إقرارنا بوجودِ استثناءات لمؤرّخين اجتَهدوا في النظر والبحث والفحص والنقد كما هو الحال مع المسعودي في القرن العاشر الميلادي[2] الذي أدخَل العلوم العقلية (فلسفية وطبيعية)، وركز على عوامل الأمة واللغة والسلطة، وكذا العوامل الجغرافية في علاقتها بتكوين حياة البشر. ناهيكَ عن العلاّمة عبد الرحمن بن خلدون الذي وظّف أيضاً فلسفة التاريخ، وبلَغت معه الأسس النظرية والمنهجية لفلسفة التاريخ ذِرْوَتها.
وإنّ استحضار ابن خلدون يُجدِّد عندنا الحديثَ عن حلقة وصْل تمكِّننامن العبور بين أصناف التاريخ العربي والإسلامي في العصور الوسيطة، وأصناف التاريخ العام في عالمنا المعاصر[3]. صحيح أنّ هناك مؤرخين سبقوا ابن خلدون في توظيف العلوم العقلية؛ إلا أنّ ابن خلدون أولَ مَن وضع أسسها بشكل علمي ومنهجي، وهو من مؤسسي التاريخ الاجتماعي بحيث حَوّلَ تركيز التاريخ من الإنسان-الفرد (الملوك والقادة والعلماء والأنبياء والرموز) إلى الجماعة، ومِن الله (يعني هنا التاريخ الديني)، إلى الطبيعة (أي إعطاء مجال للأبعاد الأخرى، كالاقتصاد، الجغرافيا، الفيزيولوجيا إلخ…)، ومن القُصور إلى الأسواق، أي أنّ التاريخ كان يهتم بالأساس بما يدور في دهاليز القصور من معاهدات، خيانات، قرارات للحرب والسلم. والآن أعيد الاعتبار حتى للمجتمع والأسواق لأنها مظهر من مظاهر الاجتماع البشري، وهي تحمل معنى رمزي، ومن أيضا من الحدث الفردي إلى منظومة الأحداث[4]، بمعنى أنّ ابن خلدون أوْلى أهمية للتاريخ الطويل والمديد، باعتبارهِ بنية مترابطة تُؤْثِر سوابق الأمور فيها على لواحقها، ومنظومة الأحداث تندرج في “علم العمران”.
نَظَر وتحقيق وتَعليلٌ للكائنات دَقيق
ثَـمّةَ جدلية يناقشها ابن خلدون بشأْنِ “مَن يؤثِّر في الآخر”؟، هل الإنسان (أي الفرد) يؤثر في المجتمع وفي مجريات التاريخ، أم أنّ المجتمع هو ما يؤثِّر في الإنسان؟ وكثيرا ما يردد عبارة أنّ الإنسان “ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه”، الأمر الذي يَعني أنّ الإنسان لا يَسير بطبعه وإنما يتطبع ببيئته، وكي نفهم الإنسان؛ علينا أنْ نفهم الأحوال التي ساهمت في تشكيله. وإذا لم نفهم هذه العلاقات؛ فالأحداث التاريخية لا تبدو بدونها سوى قصة مليئة بالضجيج والعنف الذي لا معنى له، كما يقول شكسبير على لسان إحدى شخصياته[5].
جدير بالذكر أنّ النقلة التي عرفها التاريخ مع ابن خلدون (تــ 1406م)، أي مِن التاريخ السياسي إلى الاجتماعي ومن التفسير بالعوامل الدينية إلى الانفتاح على العوامل الأخرى الطبيعية والمادية؛ عرفت أوْجها خلال القرن العشرين مع ظهور المدارس التاريخية الحديثة، والتي نادت بإعطاء أهمية للتاريخ من الأسفل، أي رصْد نبض المجتمع وتحولاته، وليس الاكتفاء بالتاريخ من الأعلى، أي تاريخ السلالات الحاكمة، والأحداث السياسية، وقضايا الحرب والسلم بين الأمم.
طبائع التّأليف التاريخي وحرفة المؤرخ
نتوقف في فكر ابن خلدون عند نصّين مُهِمّين من مقدّمته الشهيرة، يُعرّف في أحدهما مفهوم التاريخ، وفي ثانيهما بحرفة المؤّرخ وصنْعته، أو ما الذي يُشترط في المؤرخ أنَ يكون عليه.
أمّا أولهما، أي مفهوم التاريخ؛ فهو عند ابن خلدون له صلة بعلم العمران، وهذا العلم يعتبره ابن خلدون نفسه مدخلا لفهم التاريخ، يقول: “حقيقة التاريخ أنه خَبَر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يَعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال، مثل التّوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التّغَلّبات للبَشر بعضهم على بعض، وما يَنشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما يَنْتَحِله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدُث مِن ذلك العمران بطبيعة الأحوال”.[6]
يُلخّص ابن خلدون لنا علم العمران وشمائله، أي ما يشتمل عليه، ومن ذلك طباع المجتمعات والشعوب، ويُفَرّق بين الشّعوب المتوحّشة التي تعتمد على العنف والقوة والغلبة، ثم الشعوب التي تأنّست (من الأنس) أي التي دخلت في نمط المدنية، ودجّنتها القوانين وأصبحت مهادِنة ومسالمة في نمط عيشها. ويشتمل علم العمران أيضا على نظريات تفكّك بنية المجتمع والدولة، كنظرية العصبية، وهي الرابطة التي تؤلف بين الجماعات؛ سواء رابطة العقيدة، أو الدم، أو الإيديولوجيا،وتسعى من خلالها للوصول إلى الحكم، وعلى أساسها يقوم الملك وتتأسس الدول.كل هذه الأمور وغيرها تدخل ضمن نطاق الاجتماع الإنساني (علم العمران)، والتاريخ بحسب ابن خلدون هو خَبَر عن هذا الاجتماع وعن هذا العمران، وعمران أمة ما أو جيل ما هو الذي يحدّد تاريخها.
أما النص الثاني فمُتَعلّقٌ بماهية المؤرّخ وحِرْفته، أو ما الذي يحتاجه المؤرخ لدراسة تاريخ العمران البشري؟. فالمؤرخ يحتاج _ بحسب ابن خلدون _ إلى “العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد والنِّحَل والمذاهب وسائر الأحوال، والإحاطة بالحاضِر مِن ذلك ومماثَله ما بينه وبين الغائب من الوفاق، أو بون ما بينهما من الخلاف، وتعليل المتفق منها والمختلف، والقيام على أصُول الدّول والملل ومبادئ ظهورها، وأسباب حدوثها، ودواعي كونها، وأحوال القائمين بها، وإخبارهم حتى يكون مستوعبا لأسباب كلّ خبر؛ وحينئذ يعرض خبر المنقول على ما عنده مِن القواعد والأصول، فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا، وإلاّ زيفه واستغنى عنه”.[7] إنه اشتراطٌ واضح من العلّامة ابن خلدون، أن يكون المؤرّخُ شموليا في فكره، أن يهتم بالتاريخ السياسي والاقتصادي والحضاري والعالمي والجغرافي والفكري، وهذه الشمولية هي التي تتيح للمؤرخ أنْ يَقف على حقيقة علم العمران البشري.
والتاريخ الحقيقي انطلاقاً من تأليف وتصنيف مؤرّخٍ متمكّن من حرفته؛ هو التاريخ العالمي الشّامل والموسوعي، وهذا ما يخلق تحديا أمام المؤرخين الذين يَكتفون فقط بجمع الأحداث التاريخية التي تَبني في النّهاية صورة عن موضوع معين، أما ابن خلدون فكأنه يقول إنّ المؤرخ عليه ألاّ يَلتفت إلى الحوادث المنفردة، بل إلى الأحوال التي كانت قائمة في ذلك الزمن، أو بصيغة أخرى، ألاّ يَسأل هل حدث هذا الأمر أم لا، بل أن يسأل هل كان بالإمكان أنْ يحدث مثل هذا الأمر في مثل ذلك الزمان؟ والإجابة على هذا السؤال تقتضي العبور بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي وما اقتصادي إلخ.
التاريخ والفعل التاريخي البشري نِتاج العُمران
إنّ التاريخ بحسب ابن خلدون، لا يُعرَف ولا تُضْبَطُ أحداثه وتُفهَم تأثيراته؛ إلا بالرجوع إلى البيئة (أو العمران) الذي يتحرّك فيها، واكتشاف البيئة يؤدّي إلى فهْم عميقٍ للأسباب والمؤثّرات الخفية في الأحداث التاريخية وفي مسيرة التاريخ. والبيئة بحسب المفهوم الخلدوني لا تَعني تطوّر الكائنات الطبيعية، وإنما تطوّر المجموعات البشرية من حال إلى حال. أما فلسفة التاريخ عند ابن خلدون أو الفكر التاريخي عنده فَيَظهر أنه نِتاج معرفته الكبيرة بالفلسفة والعلوم اليونانية والشريعة الإسلامية واللغة، واهتمامه الشّديد بالتاريخ المقارن وبالعلوم الكثيرة الأخرى. كلّ هذا وذلك ساهم في ابتعاد الكتابة التاريخية عن نسق التاريخ الدّيني (الصراع بين الشر والخير، الحق والباطل)، وعن نسق التاريخ السياسي أيضا بمعناه الضيق (سِير العظماء)، والتاريخ الـحَدَثي؛ فاتجهَت الكتابة التاريخية نحو التاريخ الدنيوي الاجتماعي الذي يمكن اكتشافه من خلال علم العمران.
خلاصة
إنّ ابن خلدون_ حسب استقراءات وخلاصات الباحث الطّريفي _ مَدين لمن سبَقه مِن مؤرّخي الإسلام، وخاصة منهم مؤرّخي الحضارات الذين دفعوه إلى الاهتمام أكثر بالمبادئ والأسس الاجتماعية. وأنّ المأساة تتعلق بكون ابن خلدون لم يُوَرّث علمه لتلامذته، ولهذا تأخّر الاهتمام بالحقل الاجتماعي في الكتابة التاريخية إلى غاية القرن العشرين في أوربا، واستمرت الكتابة التاريخية في العالم العربي والإسلامي حبيسة التاريخ السياسي والدّيني والإسطوغرافيا الـحَدَثية، إلى أن قام الغربيون أنفسهم بالنبش في التراث الخلدوني والنهل من فكر ابن خلدون كما فعل أرنولد توينبي وغاستون لوغوف وأضرابهما.
المراجع
[1]طريف الخالدي:"بحث في مفهوم التاريخ ومنهجه"، ص: 30[2] انظر: أبو الحسن المسعودي: "مُروج الذهب ومعادن الجوهر"، 4 أجزاء، المطبعة العالمية للكتاب، الطبعة 2، 1990.
[3] طريف الخالدي، بحث في مفهوم التاريخ، مرجع سابق، ص 34.
[4]طريف الخالدي، بحث في مفهوم التاريخ، مرجع سابق، ص34.
[5] طريف الخالدي، بحث في مفهوم التاريخ، مرجع سابق، ص35.
[6]عبد الرحمن ابن خلدون: "المقدمة"، ج1، نهضة مصر، القاهرة، 2004، ص: 326.
[7] ابن خلدون، عبد الرحمن: "المقدمة"، المجلد الأول، تحقيق كاترمير، منشورات مكتبة لبنان، 1992، ص: 43.