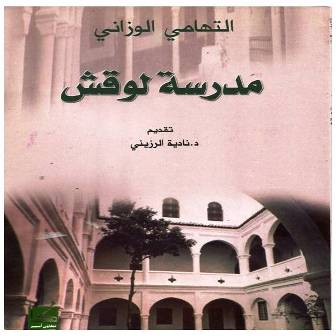
المحتويات
مقدمة
من أهمِّ ما حُقِّقَ وطُبِع من الإرث الفكري والعلمي للمثقَّف العصامي والأديب المرحوم التهامي الوزّاني (1903-1972)؛ كتاب: “مَدرسة لوقش”، أو “مدرسة لوقَش كَـفِكرة”، الصادر عن جمعية تطاون أسمير، بتقديم الباحثة نادية الرزيني، في طبعته الأولى سنة 2001، من الحجم المتوسط.
أصل هذا الكتاب؛ استعادةٌ لمحاضرة كان قد ألقاها التهامي الوزاني بعد أنْ جمع مقالاتٍ حرَّرها ونشرها في مجلة “الأنيس” الشهرية، فيما بين شتنبر ودجنبر من سنة 1953، وذلك بمناسبة انصرام قَرنين عن بناء مدرسة لوقش.
محتويات الكتاب
يتضمن الكتاب تقديماً بقلم كلٍّ من الأستاذ إبراهيم الخطيب، والباحثة نادية الرزيني، وتوطئة، وقسمين رئيسيين، يَنظُمهما 17 فصلاً.
القسم الأول:
يَسرُد الكاتِب في القسم الأوّل؛ الجانبَ التاريخي للمؤسَّسة العريقة، والسياق العام لمجيئ أسرة (آل لوقش ذات الأصول العربية الأُموية، والأندلسية، استقرت بربض تطوان منذ منتصف القرن السابع عشر، وأضحت في خدمة المخزن المغربي منذ القرن الثامن عشر، حيث مارس بعض أفرادها مهمة كاتب لدى السلطان إسماعيل العلوي، وقائدا لمرسى تطوان. واشتهر منهم أيضا الفقيه عمر لوقش، والعلّامة عبد الوهاب، والقائد عمر.
يأتِي الكاتب على ذِكْر الحالة السياسية العامة للبلاد وقتئذٍ، ويتطرَّق لمعلوماتٍ هامة عن أسرة لوقش، وعن السيدين البارزين منها: الفقيه عمر لوقش وولده الحاج محمد لوقش، وما كان يتمتّع به أهل تطوان منذ عهد السلطان المولى إسماعيل العلوي من حقِّ اختيار وانتخاب عامِلِهم على المدينة. كما حكى لنا الكاتِب عن خَفِيِّ الصراع وظاهِره بين آل لوقش وآل الحمامي، ومِن ثَمَّ التنافس على الرياسة والشَّرف وخِدمة العلم والطلبة.
يُعتبَر مدرسة لوقش المدرسة التقليدية الوحيدة التي لم يتمَّ تدميرها في شمال المغرب، والمدرسة التاريخية التي بُنِيت وسُيِّرت بأموال الأوقاف الخاصة ولم تَصلها تمويلات السلاطين ولا دعم التجار الكبار أو ممثِّلي السلاطين بشمال المغرب.
يؤكد التهامي الوزاني أنّ الحاج محمد لوقش لما بَلغه تمنُّع الفقيه الذي اختارَه للإمامة والخطبة بمسجد مدرسة لوقش عن أداء وظيفته لاعتباره المالَ الذي تمَّ إنفاقه في بنائه مشكوك في نزاهته؛ أحْضَر القائدُ لوقش عَدْلَين أمام الفقيه و”أقسم أمامهما بالله العظيم على أنه لم يُدْخِل في بناء المسجد والمدرسة إلا ما أفاء الله به عليه من غنائم سبتة، وهي مِن أَحَلِّ الحلال. فاطمأن خاطِر الإمام ولازَم هذا المسجد الجديد”[1].
إنّ المدرسة المذكورة قد بناها عامل السلطان على تطوان، محمد بن عمر لوقش في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، اتّسمت بتنامي النزاع والصراع على السلطة بعد وفاة السلطان العلوي القوي إسماعيل بن الشريف. وقد كان محمد هذا قد ورِثَ عن أبيه عمر الذكاء والفطنة والشغف بالعلم والتطلع للرياسة، فولّاه السلطان عبد الله العلوي على تطوان يوم 30 نونبر 1750.
يُدْرج المثقف التهامي الوزاني بِلغة رفيعة وأفكار متناسِقة ومقالاتٍ مُقتضَبة؛ الجانب المؤسساتي أو الدّاخلي لمدرسة لوقَش؛ مِلكيتها، وضعيتها، حبوسها، علاقتها بالمسجد الملاصِق لها، تأثيرها الروحي والديني في مدينة تطوان وأحوازها، حضورها في الرواية الشَّفهية للساكنة، طبيعة المال الذي أُنفِقَ على بنائها ومصدره، وضْعيتها قَبْل زَمن تأليف الكتاب وفي حياة المؤلِّف، طَلَبتها، الصراع على المشروعية والتأثير مع مثيلاتها في تطوان _ لا سيما مدرسة (بن قريش) _، ويتحدّث عن موقع المدرسة والجامع ضمن نطاق الأحياء التي انتعشت ونمت واتّسعت بعد حلول الموريسكيين ومِن قبل الأندلسيين، والتي تحمل اليوم اسم “الغرسة الكبيرة”، وقيامها على أصْلِ هندسة أندلسية جميلة، ماتحةً من المعمار الفني البديع لعصر النهضة الأوربية، وتعدُّ في طليعة الهندسة المعمارية التطوانية.
القسم الثاني:
في القسم الثاني؛ يأتي الكاتِب على عَقْد المقارنات بين مدرسة لوقش وجامعة القرويين بفاس، والفروق بينهما في تنظيم الشّأن الداخلي للمؤسسة التعليمية، وإيواء الطلبة وإطعامهم، حيث كانت تتكفّل أحباس القرويين بإيوائهم وتوفير مؤونتهم، بينما كانت تتكفَّل الأسر التطوانية بإطعام طلبة مدرسة لوقش، و”لم ينقطع عنها العلم والتعليم والعلماء والمتعلِّمون في فترة من الفترات مهما كانت عصيبة” (ص37).
يُرجِع التهامي الوزاني سبب اشتهار مدرسة لوقش وخلودها وإقبال النخب والعامة والبسطاء على تدريس أبنائهم بها أنّ ابن لوقَش “لما فرِغ مِن بناء مسجده ومدرسته، سلَّمهما جُملة وتفصيلا للأحباس الكُبرى، وقطع علاقاته بالمؤسَّسَتَيْن، تاركاً شأنهما لمن له النَّظـر في الأحباس العامة”.
ومما يتأسَّف له التهامي الوزاني ضياع الحوالية الـحبسية لمسجد لوقش، بعد اندلاع حرب تطوان وفرار التطوانيين وبعض النخب خارج الحاضرة، فيقُول “ومن جملة الحوالات التي ضاعت حوالة مسجد لوقش ومدرسته فلا يُدْرى هل كان لها أحباس أم أنَّ الحاج محمد لوقش بنى المؤسستين وتركهما دون حبس؟” ثم يستدرك قائلا: “ولكن الذي يَقرأ المراسلة التي دارت بين السلطان مولاي محمد بن عبد الرحمن وبين عامله على تطّاون القائد ابن الخضر السلاوي؛ يُلاحِظ أنَّ المؤسستين كانت لهما أوقاف” (ص44)، وفي موضع آخر يُضيف أنه “كان لجامع لوقَش ومَدرستها ناظر، وذلك يوجِب أن تكون لها أحباس” (ص46).
يُرجع المؤلِّفُ ثباتَ وصمود هذه المدرسة رغم تقلّبات الزمن وعصفِ السلطة بمؤسّسها وتوالي الأزمات إلى كون “التطوانيين توارثوا العَطف على هذه المدرسة لأنها أَثَرُ والٍ وَلَّــوهُ على أنفسهم ولم تَطُل مُدّة ولايته أكثر مِن سبع سنواتٍ، ثمُّ نُحِّـيَ عن وظيفته دون أخْذِ رأي أهل البلد” (ص50)، و”سيظلُّ هذا الاسم محبوباً إلى القلوب ما دامت المعرِفة معترِفة بالـجميل لـفاعِليه” (ص54).
وفي الكتاب نتعرّف على خاتمة مسيرة السيد محمد لوقش، وعُزلته بالحرم المشيشي بقبيلة بني عروس، إلى أنْ توفِي ودُفِن هناكَ بجَبل العَلم، مُخلِّفاً أخْلَدَ الآثار وأنْبَـلها في تطوان إلى يومنا هذا، “مدرسة لوقش” التي تحوّلت إلى متحفٍ ديني تُديره مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويُفتح في أوجه الزوار والسياح على مدار الأسبوع ما خلا يوم العطلة، ويُقدم معطيات تراثية وثقافية وإثنوغرافية هامة جدا، ويَصون الذاكرة التاريخية للمدينة، وشقها التعليمي أساساً.





















