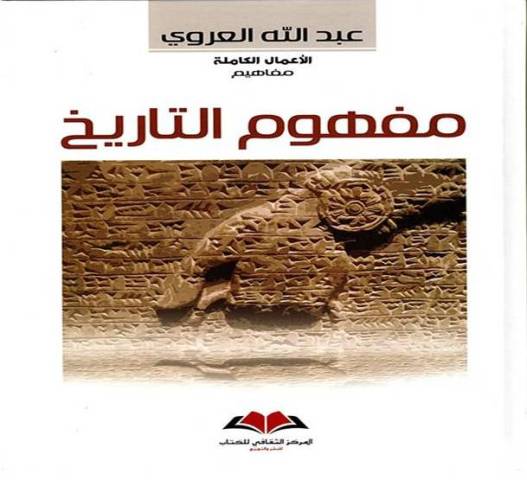
المحتويات
مقدمة
كتابة التاريخ ليست مجرد تقنية، وإنما هي أبعد من ذلك عبارة عن رؤية وفلسفة، تتفاوت من مؤرخ إلى آخر، ما قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى نتائج تاريخية متباينة رغم أن الحقبة المدروسة واحدة، فالكتابة التاريخية هي انعكاس للوعي والواقع الاجتماعيين؛ تلك هي الفكرة المحورية التي يوضحها الفيلسوف والمؤرخ المغربي عبد الله العروي، في القسم الثالث “تاريخيات/ الاسطوغرافيا” من كتابه “مفهوم التاريخ” الصادر عن المركز العربي، في طبعته الرابعة سنة 2005، وهو الكتاب الذي يعتبره صاحبه -في تصريح ذات مرة- أنه أهم كتبه، لأن باقي مؤلفاته تمتح منه.
فما هي أبرز الطرق التي كتب بها التاريخ؟ وما هي البنى المعرفية الكامنة وراءها؟ وكيف تعكس وعي الإنسان بمفهوم التاريخ؟
عرض مضامين الكتاب
الفصل الأول: التاريخ بالخبر:
إن الوعي بطرق كتابة التاريخ عند العروي لا يقتصر على حصره لها، بل يتعداه إلى ترتيبها، إذ أول ما يبدأ به هو: طريقة التاريخ بالخبر المسموع أو التاريخ الشفوي، مبررا ذلك بأن التاريخ بدأ في الأصل مادة روائية، وما زال كذلك إلى اليوم في شق كبير منه، كما أن الكتابة ما هي إلا وسيلة من وسائل حفظ الرواية.
ويقصد العروي بالخبر “الوصف الشفوي للواقعة.. جيلا بعد جيل”، وهو الجزء الأكبر من مراجع المؤرخين إلى اليوم. وتدور مادته الخبرية على اللغة بما هي ثقافة وفكر وسلوك اجتماعي، وهي مادة مشتركة بين التاريخ والأنثروبولوجيا وعلوم اللغة؟.
من هنا ينطلق العروي إلى إشكالية تقاطع التاريخ مع علوم أخرى، فاللغة كما هي موضوع للتاريخ بالخبر/ الكلمة، هي كذلك موضوع لعلوم اللغة والأنثربولوجيا، فهل هذان العلمان مساعدان، أم موازيان أم منافسان للتاريخ؟ وكيف ينبغي للمؤرخ أن يتعامل مع هذا الإشكال؟.
ويجيبنا المؤرخ المغربي أن تناول كل من علوم اللغة والأنثربولوجيا للغة بمنهجية التلازم والتساكن (السنكرونية) جعلهما ينفصلان عن التاريخ ذو المنهجيية القائمة على الاستتباع والتولد (الدياكرونة)، وهي مفاصلة تدعو المؤرخ إلى أخذ الحذر في الاستعانة بهذين العلمين نتيجة الاحتمال الكبير لإهمال البعد التاريخي الكامن في الظواهر اللغوية. وإلى وضع نتائجهما على محك التطور الزمني للتأكد من مصداقيتها.
الفصل الثاني: التاريخ بالعهد:
يقصد العروي بالتاريخ بالعهد: التاريخ المكتوب عادة بالوثائق المحفوظة؛ وهذه الأخيرة هي مادته، ولا يعتمد على الرواية، وهو منهج يستبطن معنى قانونيا يتمثل في التحقيق القضائي الذي لا يقبل بالشهادات الشفوية، ما لم تسندها وثائق وشهادات ملموسة. وهي طريقة تعكس وعيا متقدما بالتاريخ؛ عبر الانتقال من الشفوي إلى المكتوب، فالعقود مؤشر على تطور عام في حياة الإنسان.
ويرتبط هذا النوع من التأليف التاريخي بالفكر العلمي الحديث. خصوصا النقدي والوضعاني منه، والذي يؤسس أحكامه على الوثيقة الملموسة، لأنه لا يعترف بالعوامل المؤثرة في التاريخ إلا المسجل منها في الوثيقة؛ ويتطلب من كاتبه أن يكون متخصصا ومدربا على استعمال الوثائق.
بذلك يدخل التاريخ بالعهد هو الآخر في تشابك مع علوم أخرى كثيرة مثل الأبيغرافيا والباليوغرافيا والديبلوماسيات والكريبتوغرافيا وعلوم الموازين والمكاييل.. التي تتدخل لفك طلاسم الحرف (الرمز المكتوب) والحامل (الأثر المادي) الشاهد على التاريخ.
لا يتحقق التاريخ بالعهد عند العروي إلا عند اختراع الكتابة كانعكاس للازدهار المدني والتجاري.. وعند الاستمرار الذي يجعل الدول ترغب في جمع المواثيق والعهود، وتوفر تعددية السلط التي تحتم صياغة معاهدات لحفظ الحقوق، إضافة إلى التقدم العلمي المعبئ للوسائل المادية (آلات جمع ونسخ وحفظ وترميم والمواثيق)، وهي شروط لم تتوفر إلا في مجتمعات القرن 19 المتقدمة اقتصاديا وثقافيا، حيث انتعش النقد/ الانتقاد ببعديه: التحقيق التقني بالعودة إلى أصل النص، والتحقيق الفكري بالحذر الدائم إزاء الوثيقة.
الفصل الثالث: التاريخ بالتمثال:
يعني التمثال هنا: شاهدة تشكيلية قد تكون فنية وقد تكون مجازية، وكما تختلف أشكالها قد تختلف حواملها والغايات من رسمها. وهي نوعان: إما بادية ظاهرة (الصورة/ الحرف)، أو مضمرة خفية مثل الشكل المعبر والرمز. فكما يكتب التاريخ بالمكتوب يكتب أيضا بالصور والنقوش.
لكن، ليست شاهدة التمثال موضع علم التاريخ فقط، بل تتقاطع فيها عدد من العلوم الأخرى مثل: الفن والأيقونات وعلم الخواتم والطوابع والتوقيعات، والتصوير الجوي والمرئيات المعاصرة..
وإذ يثني العروي على هذه الطريقة في إغناء الكتابة التاريخية، وتجديد منهج البحث التاريخي، إلا إنه يحذر من تحد يطرح تأويل التمثال المفتوح على كل قراءة، وهو ما يتطلب من المؤرخ الاحتراز في التعامل معه، فقد لا يكون معبرا عن واقعه التاريخي بقدر ما يكون امتدادا لموروث سابق على الفترة التي صيغ فيها، ما يموه الباحث ويحرفه عن إدراك الموضوعي للواقع التاريخي.
الفصل الرابع: التاريخ بالأثر (الطبيعي):
يعرف العروي التاريخ بالأثر: “كل سرد يستند أساسا إلى كشوف الحفريات/ المخلفات أو الآثارالمادية”، شريطة أن تكون هذه الآثار طبيعية ملموسة (حجر، عظم لباس، أثاث، حلي، سلاح، نفاية طعام..).
ويعكس هذا النوع من البحث تأثر التاريخ بالفلسفة الطبيعية التي عرفها القرن الثامن عشر، مع بزوغ نجم العلوم الطبيعية، واقتناع المفكرين بوجود تاريخ إنساني أقدم من المتصور، وأن للطبيعة ذاتها تاريخها الخاص. وهي فلسفة لم تؤثر فقط على البحث التاريخي، وإنما شملت مجالات أخرى مثل وسائل الإثبات في القضاء التي لم تعد مكتفية بالاعترافات الشفوية والكتابية، ما لم تكن مسنودة بأدلة مادية.
لقد كانت المناهج السابقة تركز على ما هو فكري أو سياسي أو عقدي فقط، لكن التاريخ بالأثر كان إعلانا عن التحول من البحث عن المكتوب والمرويات إلى الحفر عن آثار مدفونة في جوف الأرض.
إن اتخاذ الأثريات كمادة لهذا النوع من الكتابة سيجر على التاريخ عددا من الأزمات؛ فالأثريات هي أيضا ملتقى عدد من التخصصات والعلوم مثل: الحفريات، التوقيت والتأرخة، التحليل الكيميائي والفيزيائي للقطع المكتشفة… مما يحتم على الباحث أن ينفتح على هذه العلوم، وتوسع مفهوم الأثر المادي، وتضاعف الكشوفات بشكل خيالي، مع إخضاع كل قطعة إلى عشرات المعلومات (موضعها، لونها، مادتها، شكلها..) جعل الحاجة ملحة لاستعمال الحاسوب الالكتروني. ناهيك عن هيمنة سوق المتاحف والعوائد المالية، على الهم العلمي الصرف، كما أن دقة تحليل تاريخ الأثر الطبيعي، لا يعني بالضرورة دقة تحليل التاريخ الإنساني.
يَخلُص العروي إذن إلى أن طرق البحث في التاريخ تختزن تحيزات معرفية تؤثر على نتائج البحث، فغلبة الاعتماد على الشواهد المادية، يختزن الجنوح نحو العلوم الطبيعية، وغلبة الاعتماد على الأعمال الفنية، انحياز إلى ميدان الفن والأدب.. وهكذا.
الفصل الخامس: التاريخ بالعدد:
التاريخ بالعدد أو التاريخ الكمي والعددي أو الإحصائي، وهو اصطلاح أنجلوساكسوني، يعتمد بالأساس الوثائق التي تغذي الحاسوب، وتحويلها إلى جداول (تاريخ جدولي)، أو هو تاريخ يحشد طوابير من الأعداد المتناسقة (الأسعار، الكميات، المسافات، المساحات، إلخ) شريطة أن تكون المادة المستعملة قابلة للتبديل والتحويل.
والتاريخ بالعدد هو إفراز لعدد من السياقات، والتي أحدثت التحولات السابقة ثورة حقيقية في مجال التاريخ لما تم إدخالها في مناهج دراسته، وقد عاد فرنسوا سيميان لفهم أزمة 1930م المخالفة للأزمات العشرية المعتادة، على كتب التاريخ لاستخراج معلومات رقمية، كون منها جداول منسقة ثم أجرى عليها المعادلات الإحصائية.
لكن التاريخ بالعدد عند العروي لا يخلو هو الآخر من تحديات/ أزمات أبرزها؛ عدم إمكانية تحققه إلا بوجود مادة قابلة للتبديل والتحويل، ومدى تمثيل المعطيات الإحصائية لحقيقة العلاقات الاجتماعية؟ بالإضافة إلى إمكانية تدخل الأحكام المسبقة في ضبط المعلومات وتعبئة العمليات الحسابية، فهل العدد المستعمل رمز مباشر لشيء ملموس، أم هو رمز بواسطة الواسطة التي هي هنا المؤرخ؟ وهو ما يطرح تحدي الإدراك الموضوعي للواقع مرة أخرى..
الفصل السادس: التاريخ بالموروث:
يشير العروي في هذا الفصل إلى التقاطع الحاصل بين علم التاريخ وعلم البيولوجيا، إذ يقوم التاريخ بالموروث على شاهدة الجينة والفصائل الدموية والتصنيفات القبلية، ليصبح التاريخ هنا تاريخ سلالات مادته أو شاهدته هي “الجينة”.
وقد ولد هذا الاتجاه النظري متأثرا بالاكتشافات/ الثورة البيولوجية التي عرفها منتصف القرن العشرين، والتي بينت بالبرهان أن الجينة حقيقة، وليست مجرد فرضية كما دأبت الدراسات التاريخية السابقة على استعمالها (ابن خلدون، المسعودي، مونتيسكيو)، حيث تم النظر إلى الجينة كعامل كيميائي عضوي مادي وملموس، وفي نفس الوقت كخطاب، وبرنام، قد يتطور بالشكل المعتاد، وقد تطرأ عليه بعض الطفرات.
إن هذه الفترة بالذات هي الفترة التي أصبحت فيها البيولوجيا مصدر التأثير في العلوم الإنسانية، عبر إمدادها بالمفاهيم والتصورات.
لقد كان للتاريخ تجربة سابقة مع التصنيف الوراثي؛ انطلاقا من التركيز على تغير اللون أو الهيكل الجسماني، والتغذية والعادات واللغة.. لكن الجديد هذه المرة هو تطور علم البيولوجيا، فما هي آفاق الكتابة التاريخية المعتمدة على البيولوجيا أساسا علميا لها؟ يتساءل العروي.
ويجيب أن النظرية السلالية تعرضت لانتقاد سياسي وأخلاقي شديدين؛ بسبب استغلالها في الحروب العنصرية، ولانتقاد علمي أيضا وهذا هو المهم، حيث أدت المحاولات التصنيفية بناء على الفصائل الدموية إلى إحصاء مائة مليون تأليفة، ما جعلها أكثر احتمالية وغير قطعية فلكل فرد مميزاته.
ولكن العروي مع ذلك لا يرى مانعا من استعمال هذه الوثيقة الجسمانية في كتابة التاريخ، خصوصا تاريخ الحروب الذي أثبتت مساهمة اللغويات والطبيعيات ضعفها فيه. يقول: “هناك أمر بدهي وهو أن الفرد يحمل في جسمه آثار تحولاته عبر الزمان ورموز تنقلاته على وجه الأرض. الماضي حاضر في الكلمة وفي الجسم. إنها “وثيقة محفوظة في الجسم”.
الفصل السابع: التاريخ بالحلم:
يقصد العروي بعبارة “التاريخ بالحلم” منهج التحليل النفسي في الكتابة التاريخية، وهي النظرة التي تنظر إلى التاريخ كحلم، حلم به أبطاله وصناعه، هنا تكون الشاهدة هي النفس البشرية، إذ هي موضوع البحث، يبحثها المحلل مثل المؤرخ والأنثربولوجي واللغوي في المصادر/ المواد الأولية (الأمثال، الأحاجي، الطقوس، العادات، الأساطير العقائد الأعمال الفنية والأدبية..) وعلى رأسها الاعترافات والسير الذاتية.
يقول العروي: إن المحلل النفسي يحول المصدر إلى عمل تاريخي، إلى حلم ويؤوله على ذلك الأساس.. التاريخ هو حلم العظماء: نظرية فريويدية وتقليدية قديمة، قدم الأساطير”.
ظهر منهج التحليل النفسي في التاريخ مستوردا من علم النفس، وبالأساس من نظرية التحليل النفسي لفرويد؛ الذي اعتبر الموروث هو اللاوعي الذي يتسبب في الانحرافات المرضية وفي ظهور أطوار غير عادية في الأفراد والجماعات، وربما في البشرية جمعاء، ويستمر هذا الموروث عبر المواقف النموذجية الأصيلة المتجددة بتمثيلها الدائم في إطار الأسرة والمجتمع نتيجة الحواجز التي ترفعها الثقافة لمقاومتها ودحرها. كما تدل الأحلام على مخزون اللاوعي، والحلم هو كل حالة ترفع فيها قيود العقل، أتحققت بالنوم أو التنويم أو أي وسيلة أخرى. لكن هذا المنهج لا يخلو هو الآخر من اعتراضات جعلت هوة بينه وبين علم التاريخ.
الفصل الثامن: التاريخ بالمفهوم:
التاريخ بالمفهوم أو التاريخ بالقيمة، هو التاريخ الذي يستفيد من فلاسفة التاريخ، عبر اقتباس القوة الكامنة/ القيمة وراء تطور التاريخ (عناية ربانية، حرية، روح قومية، همة، سعادة..) واستعمالها كمفهوم مجرد يقيس به الأحداث. مع تمحيص هذه المفاهيم وأخذ المناسب منها.
ويختلف هذا القسم عن غيره من خلال اتخاذه التاريخيات ذاتها كمادة أولية، وبانتقاء الحوادث/ الأمثلة حسب المفهوم المعتمد. وثيقته إذن هي المفهوم وضمائمه ولوازمه المستنبطة.
ويتميز التاريخ بالمفهوم بميزات منها؛ عدم الاهتمام بالتفاصيل بقدر ما يهتم باكتشاف القوانين العامة المنطبقة على كل الأمبراطوريات… ويعتقد العروي أن هذا النموذج لم يمت وإنما رحل إلى حقل آخر تحت اسم كلاميات (ثيولوجيا) التاريخ.
أما عن مشكلة هذا النوع من التأليف فتتجسد في سقوطه كثيرا في الخطأ عند الجزئيات، ومع ذلك فإن المؤرخين الذين ينتقدونه لا يتورعون عن استعمال مفاهيمه. ومما يؤخذ عليه أيضا؛ أنه ينطلق من أفكار مسبقة، وأنه يحدد قبليا المصير الموحد الذي ستنتهي إليه الأمم. ومن أبرز من كتب فيه ابن خلدون، أرنولد توينبي، فولتير وغيرهم.
الفصل التاسع: تاريخ أم تواريخ:
يثير تعدد المنهجيات السابقة سؤال الغاية من التاريخيات أهو واحد أم متعدد؟
قبل أن يجيب العروي عن هذا السؤال يوضح نقطة جوهرية توصل إليها بحث لليونسكو حاول الإجابة عنه، مفاده العلاقة الوثيقة بين شكل كتابة التاريخ وبنية المجتمع، لقد ظلت أسئلة المنهج في التاريخ وتجاوز أزماته حكرا على المجتمعات الاستعمارية، أما مجتمعات العالم الثالث فاكتفت بالمناهج التقليدية لفقرها وعدم تحكمها في اقتصادياتها، ما منعها من استعمال المناهج الحديثة التي تتطلب موارد مادية باهظة.
ينطلق بعد ذلك العروي إلى المدرسة الفرنسية في التاريخ، والتي انطلقت من المدرسة الألمانية الرائدة في قواعد النقد والتحقيق، وتجاوزتها إلى المستوى النظري، خصوصا وأن الفلسفة الفرنسية كان لها الإسهام الأكبر في قرن الفلسفة؛ القرن الثامن عشر.
هذه الريادة النظرية ستنتهي بعد الحرب العالمية الثانية إلى بروديل الذي سيطور مدرسة “الأنّال” (الحوليات) من خلال تسطير برنامج بحثي طموح، وواضح عبر دمجه جهازا مفاهيميا، أبرز لبناته مفهوم التناهج الذي يعني تكامل التخصصات وتآزر المباحث لدراسة موضوع واحد من شتى جوانبه. مستعيرا الفكرة الماركسية القائمة على ثلاثة مستويات: البنية التحتية (البيئة) اختصاص الجغرافيين والاقتصاديين، والبنية الفوقية (الروحانيات والذهنيات والنفسيات) اختصاص علوم المنطق واللغة والعقل والنفس، ثم البنية: (التنظيم القانوني والترتيب السياسي والسلوك) اختصاص المؤرخين التقليديين والفقهاء والاجتماعيين والأنثربولوجيين.
لقد أقصى بروديل بذلك المحققين والمدققين (المدرسة الألمانية)، وأعطى مساحة واسعة للمؤرخ الذي أصبح منظم/ منسق/ واصل/ موصل بين التخصصات.
يطرح هذا المنهج الشمولي سؤال: هل نحن أمام شمولية أم تلفيق؟.
يرى العروي أن مشروع بروديل الذي ذاع في كل الآفاق، سرعان ما دخل أزمة أخذت تتفاقم شيئا فشيئا، ملخصها؛ أن المناهج المستعملة من تخصصات متعددة لم تحقق اندماجا بقدر ما اكتفت بالتساكن والتجاور، إضافة إلى أن المنهج الشمولي/ الحوليات أدى إلى أزمة البحث الطويل المرهق للباحثين، ناهيك عن تراكم البحوث الجزئية غير المنسجمة وغير المتجهة إلى نفس الاتجاه.
لقد أصبح المؤرخ يدرس كل شيء، وينقد ويمحص مناهج علوم أخرى طبيعية وبشرية، منتقلا من المستوى الوضعاني إلى المستوى المعرفي.
ويرجع العروي هذه الاختلالات إلى أن التناهج عند بروديل كان عملا جماعيا وليس فرديا، لكن السبب الرئيسي حسبه هو سطو بروديل على خطة الانثربولوجيا وتسميتها تاريخا، مغفلا الوحدة الثقافية التي تفرضها الأنثربولوجيا، وهذا بدوره يرجع إلى تخلي المدرسة الفرنسية عن النظرية المعرفية التي أنتجتها المدرسة الألمانية.
الفصل العاشر: درس التاريخيات:
أخيرا وبعد الفصول السابقة يطرح العروي سؤال: هل كل نمط في الكتابة التاريخية هو وليد طبيعي وحتمي لسابقه؟ أم أن الأمر يعكس بنية متداخلة؟
يجيب العروي بأن أسطوغرافيا التاريخ بالأساس ليست زمانية بقدر ما هي بنيوية. نظرا لعدد من الاعتبارات:
- الاعتبار الأول: يتمثل في أن التمايزات الحاصلة اليوم بين الخبير كالكيميائي في مختبر ملحق بمعهد تاريخي، والراوية الذي يسرد القصة، والمؤرخ الذي ينظر في السوابق واللواحق من الأحداث، يمكن محوها حينما تجتمع بالفعل في شخص واحد.
- الاعتبار الثاني: يرتبط بتساكن المناهج المذكورة فيما بينها أكثر مما تتابع وتتوالد. واكتشاف الوثيقة الشاهدة الجديدة لا يعني سوى تعرف الانسان على جانب من نشاطه لم يكن يعرفه. وبعبارة أخرى يمكن القول: إن العروي يعتبر أنشطة الإنسان ومخلفاته بغض النظر عن طبيعتها (شفوية، كتابية، أثرية، فنية، بيولوجية..) هي في مجموعها تشكل بنية الفعل الإنساني، وفي كل مرة كان التاريخ يعتمد على جانب منها.
- الاعتبار الثالث: مرتبط بما هو منهجي: منهج الإحصاء ومنهج التفسير ومنهج التأويل يمكن تطبيقها على الشواهد الثمانية دون استثناء، صحيح أن هناك شاهد معين أقرب إلى منهج معين، ومع ذلك لا مانع من التعميم.





















