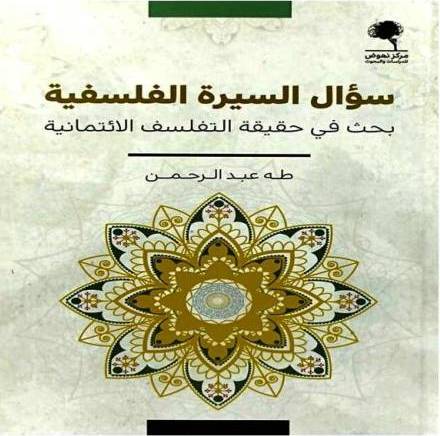
المحتويات
توطئة
طه عبد الرحمن آخر الفرسان، حار المفكرون والباحثون في تصنيفه، فهو فيلسوف الأخلاق” تارة، و”فقيه الفلسفة” تارة أخرى، وأحيانا “الفيلسوف المتصوف”… هذه ألقاب تطلق على قامة من قامات الفكر المغربي. داع صيته في الآفاق . رجل بعيد عن التكلف والتصنع، صاحب فطرة سليمة، وروح شاعرية شفافة يكاد لا يملكها غيره ممن دخلوا عالم الفلاسفة المليء بالغموض. رجل تجاوز الثمانين من عمره وما زال عطاؤه مستمرا. آخر إصداراته كتابه “سؤال السيرة الفلسفية بحث في حقيقة التفلسف الائتمانية”، صدر سنة 2023م عن “مركز نهوض للدراسات والبحوث”، تتجاوز عدد صفحاته الخمسمائة. يذكّر طه بأن أصل الفلسفة كونها “ليست فكرا مجرّدا” بل “سيرة حيّة”، وبأنها في الأصل ليست التفكير الذي يتوسل بالعقل المجرد “وإنما هي ممارسة حية تتوسل بالعقل المسدَّد، إصلاحا للإنسان. فما مسار هذا الكتاب وما الجديد فيه؟
مضامين الكتاب
يذكّر طه بأن أصل الفلسفة كونها “ليست فكرا مجرّدا” بل “سيرة حيّة”، وبأنها في الأصل ليست التفكير الذي يتوسل بالعقل المجرد “وإنما هي ممارسة حية تتوسل بالعقل المسدَّد، إصلاحا للإنسان”.
وفي علاقة “الفلسفة” و”الحكمة”، يدافع طه عن أنها في الأصل لم تكن علاقة امتلاك بل “علاقة ائتمان”؛ فالفلسفة في أصلها عبارة عن الائتمان على الحكمة، حيث يتعين على الفيلسوف أن يعود إلى هذا التصور الائتماني للفلسفة”.
اختص الكاتب الفصل الأول: مفهوم السيرة الفلسفية، بإثبات الدعوى الأساسية لهذا الكتاب المسماة “دعوى الفلسفة المسددة”، ومضمونها أن الفلسفة ليست تفكيرا في الأشياء على مقتضى العقل المجرد، وإنما هي ممارسة حية على مقتضى العقل المسدد، ابتغاء إصلاح الإنسان؛ وهذا يتطلب من الفيلسوف أن تصدق أفعاله أفكاره، وأن يتوسل في صوغ أفكاره وضبط أفعاله، بالعقل المسدد. (الكتاب ص 21)
ولا يزال الفيلسوف على هذا التصديق والتسديد، حتى يُدرك رتبة “الفيلسوف الصديق” ولم يفت هذا الفصل أن يوضح العلاقة بين “الفلسفة ” و”الحكمة”، فكشف أنها لم تكن، في الأصل، علاقة امتلاك، وإنما علاقة ائتمان، فالفلسفة، في أصلها، عبارة عن الائتمان على الحكمة، بحيث يتعين على الفيلسوف أن يعود إلى هذا التصور الائتماني للفلسفة.
وأفرد الفصل الثاني: “أركان السيرة الفلسفية” لبيان كيف أن سقراط يمثل أفضل نموذج لهذه السيرة في تاريخ الفلسفة، إذ سبق غيره في اعتبار الفلسفة اشتغالا بالإنسان، لا بالطبيعة؛ وقد حاول أن يستخرج أركان السيرة الفلسفية من سيرته الحية، وهي ثلاثة:
- أولها؛ التشبه بالنبي، حيث إنه صدق بالنبوءة التي أخبرته بكونه أحكم الناس ولو أنه أخضعها للاختبار، وادعى سماع هواتف تنهاه عن كل فعل يضره وكان يبدي ميلا خفيا إلى التوحيد، كأنه يتستر عليه، فقد اتهم بالدعوة إلى دين جديد .
- والركن الثاني؛ التفكر، وله جانب ائتماني تمثل في طريقته في السؤال والتعريف، هذه الطريقة التي لا تسعى إلى امتلاك المعرفة، وإنما تسعى إلى الدوام على طلبها. كما له جانب إشهادي تمثل في عمليات ثلاث: “التفطر” (أي اطلاع الروح على المعاني في عالم الخلود) و”التذكر” و “التوليد”.
- والركن الثالث؛ التخلق الفطري، واقتضى هذا الركن من “سقراط» القيام بعمليات ثلاث هي “التبكيب” أي كشف تناقضات محاور، ثم “الامتحان”، أي كشف عيوبه، وأخيرا، “الوعظ”، حثا أو زجرا .(الكتاب ص 22)
وعقد الفصول الثلاثة اللاحقة لبيان كيف تم تحريف السيرة الفلسفية بإخلال فلاسفة العرب ومقلديهم من المسلمين بالأركان الثلاثة المذكورة، أي “التشبه بالنبي”، و”التفكر”، و”التخلق الفطري”. فتناول الفصل الثالث؛ الإخلال بالركن الأول، إذ أبدل به أفلاطون “التشبه بالإله”، ودعا إلى عروج الروح إلى عالم الآلهة بطريق التطهر، ولم يكن مقلده أبو بكر الرازي أقل منه تعلقا بهذا التشبه، بل سعى إليه، لا بتقوى الإنسان التي تدل على طاعة الإله كما فعل أفلاطون، وإنما بالرحمة الإلهية التي تتسع للمطيع والعاصي.
كما تناول الفصل الرابع؛ الإخلال بالركن الثاني، إذ أبدل به أرسطو “التنظر”، وجعل معناه ينحصر في الدلالة على النظر الذي يكتفي بذاته، مستغنيا بالكلية عن العمل، وخص به الآلهة والمتألهين؛ ولم يزد مقلّده أبو بكر ابن باجة إلا تمسكا بنظرة أرسطو الامتلاكية إلى الفلسفة، كما ازداد ازدراء للفضائل الخلقية التي يسميها بـ “الفضائل الشكلية”، منزّها عنها الإلهيين والسعداء الذين لا تعلق لهم إلا بالمعقولات الخالصة، وتحامل بشدة على الغزالي الذي ادعى مشاهدة أمور لا طاقة للعقل المجرد بها، فنسب مشاهداته إلى عالم الخيال الذي يشترك فيه مع العامة.
وأخيرا تناول الفصل الخامس؛ الإخلال بالركن الثالث، إذ أبدل به نيتشه “التخلق الغريزي”، معلنا موت الإله باعتباره موتا لقيم الدين وأخلاق العبيد، وداعيا إلى بعث الحياة بوصفه بعثا لإرادة القوة، نظرا لأن هذه الإرادة هي وحدها القادرة على الانقلاب على القيم الدينية وإحياء القيم اليونانية القديمة وأخلاق الأسياد. أما مقلده عبد الرحمن بدوي، فلم يقف عند حد “قلب القيم” كما وقف عنده نيتشه، وإنما تجاوزه، فدعا إلى محو القيم الأخلاقية التقليدية بالمرة، منكرا أن يكون للتجربة الوجودية للذات أخلاق تنضبط بها أصلا، ذلك لأن الذات كلها حرية مطلقة وإمكانات مشرعة.
وأما الفصل السادس والأخير، فقد خصصه للنبي إبراهيم (ع) لأنه جمع بين المقامين السلوكيين “مقام الصديقية” الذي قد يصل إليه الفيلسوف متى واظب على العمل بـ مبدإ التصديق”، وبين مقام “النبوة ” الذي يؤهله لأن يتشبه به الفيلسوف، واجتهد في توضيح بعض معالم “الصديقية” عنده التي تجعل منه فيلسوفا، بمعنى ” الباحث عن الحكمة”، كما تجلى ذلك في تأملاته في الملكوت، كما اعتبر أن سقراط، سار على ما يشبه ما سار عليه إبراهيم “ع”، تفكرا وتخلقا، محصلا، بذلك، درجة من درجات “الصديقية”، مع تأكيده على أن الفيلسوف، مهما بذل من جهد في ” التشبه بالنبي”، فإنه لا يرث منه إلا قدرا من “الصديقية”، لأن الانتقال إلى رتبة “النبوة” لا يحصل إلا بميثاق إلهي مخصوص، والفيلسوف، من حيث هو كذلك، لا حظ له في هذا الميثاق التفضيلي الخاص .
وأما الملحق: “تهافت نظرية النبوة عند فلاسفة الإسلام”، فالغرض منه هو بيان أن ركن “التشبه بالنبي” من أركان السيرة الفلسفية يغني كليا عن هذه النظرية العجيبة التي تعرض لها شبهات شنيعة وتوقع في إشكالات عويصة؛ وقد وقف عند إشكالات ثلاثة وضع لها أسماء خاصة، أولها “التجريد العقولي” ويدور على القول بوجود عقول مفارقة في عالم المعقول، والثاني؛ “التأييد النبوي”، ويتعلق بالقول بالاتصال بالعقل الفعّال، والثالث؛ “التخييل النبوي”، ويدور على الادعاء بأن أخبار الأنبياء عن العالم الآخر عبارة عن تخييلات للحقائق كأنما الأنبياء لا يسعهم إلا أن يتخيلوا من أجل العامة ما يستطيع الفلاسفة أن يتعقلوه من أجل خاصة الخاصة، وقد جاء بتفاصيل أدلتهم على هذه الدعاوى الثلاث على التوالي، وأوردها على كل واحدة منها من الملاحظات والاعتراضات ما كشف عن مكامن تهافتها، فضلا عن بالغ مصادمتها لمبادئ فلسفة تكون مبنية على أصالة ثقافتنا.
وأما الخاتمة، فقد أفردها لتحديد أهم الشروط العامة الواجبة في إبداع فلسفة إسلامية حقة ووصف هذه الفلسفة بـ “الحقة”، ولم يصفها بـ “الأصيلة”، نظرا لأن “الحق” أخص من “الأصيل”، فكل حق أصيل، وليس كل أصيل حقا. غير أن هذا الوصف، أي “الحقة”، لا يعني البتة أن ما سوى الفلسفة الإسلامية من الفلسفات الأخرى باطل بالكلية، وإنما يعنى أن هذه الفلسفة تستوفي الشروط الدنيا التي تجعل كل فلسفة تستوفيها تستحق أن تُنسب إلى الإسلام بوصفه طريقة خاصة في الحياة؛ ابتغاء صلاح الإنسانية جمعاء (الكتاب ص 25).
خاتمة
أراد طه عبد الرحمن تذكيرنا بهذا الأصل المنسي، وهو أن الفلسفة ليست فكرا مجردا، وإنما هي “سيرة حية”، وأن يجدد نظرتنا إلى “الفلسفة” بل أن يبعث فينا القدرة على الإبداع الفلسفي، فقام بتحديد أركان السيرة الفلسفية، مبرزا ما ينطوي فيها من عناصر الائتمان وأسباب الإبداع، ثم بين كيف أن هذه الأركان الفلسفية لم تحفظ على وجهها الائتماني الأصلي، وإنما تعرضت لتحريفات متتالية من لدن ” المتفلسفة” أنفسهم، زادها سوءا تقليد ” فلاسفة الإسلام” لهم، مما حال دون قيام فلسفة إسلامية حقة. ومن خلال بيانه لهذه التحريفات المتعاقبة، أثبت أن الرجوع إلى السيرة الفلسفية يوجب أن نعيد وصل الفلسفة ب “أسسها المأخوذة من الحكمة” وأن هذه الأسس ارتبطت بالدين، منهجا، ولم تنفك عن مضامينه أبدا، ومن هذه الأسس ما يسميه ب “الرتبة الصديقية” و” الروح الإبراهيمية”. لذلك يرى طه الفيلسوف المجدد أنه لا سبيل إلى إبداع فلسفة إسلامية حقة، بل إبداع “الفلسفة الحقة”، إلا بتحصيل سيرة فلسفية مبينة على هذه الأسس الحكمية.





















