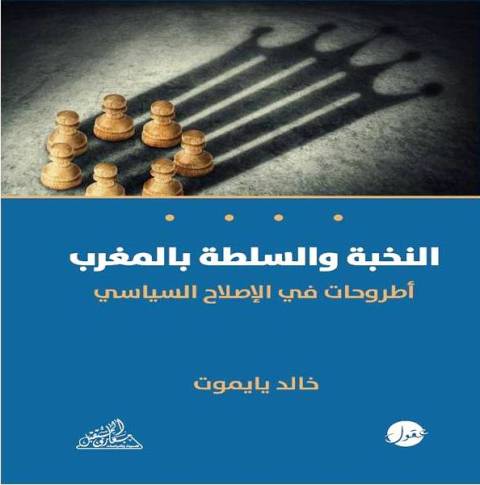
المحتويات
توطئة
لقد روادت الفكرة الإصلاحية الإصلاحيين منذ تأسيس الدولة بمفهومها الحديث. وتعددت الرؤى والأطروحات الإصلاحية باختلاف منطلقاتها وتوجهاتها، وقدمت الدراسات حول الإصلاح، ورصد التراث الإصلاحي المغربي في القرن التاسع عشر، متوقفة بشكل أساسي عند مظاهر يقظة المغرب الحديث، وذلك بالتركيز على كتابات العلماء والفقهاء، وكتب الرحلة، لاسيما منها السفارية. ومن الذين اهتموا بهذا محمد المنوني رحمه الله في كتابه “مظاهر يقظة المغرب الحديث” بجهد كبير في تصنيف المادة الإصلاحية التي كتبت تحديدا في هذا القرن. وقام باحثون آخرون مثل عبد الإله بلقزيز، ومحمد بن سعيد العلوي، بدراسة متون كثيرة في المادة الإصلاحية المغربية. واختلفت مقارباتهم عن المقاربة التأريخية التعريفية التي سلكها محمد المنوني. واهتم أيضا مفكرون وبعض زعماء الحركة الوطنية بالفكرة الإصلاحية، وعلى رأسهم الزعيم علال الفاسي صاحب”النقد الذاتي“. وجاء بعده من المفكرين عبد الكبير الخطيبي صاحب “النقد المزدوج”، وعبد الله العروي صاحب “الإيديولوجية العربية المعاصرة”، والجابري صاحب مشروع “نقد العقل العربي”، وعلي أومليل صاحب “الإصلاحية العربية والدولة الوطنية”. بالقدر الذي ندر فيه تناول هذه المحاولات في سياق نقدي تحليلي مقارن، ينشغل بسؤال سياق تشكل أطروحات هؤلاء حول قضايا الإصلاح السياسي والدولة الوطنية، وأهم المؤثرات التي ساهمت في صوغ أفكارهم الرئيسة، والخلافات التي تخترق هذه الأطاريح، ومحاولة فهمها في سياق جدل الداخلي والخارجي من جهة، وفي سياق جدل صراع الدولة والمجتمع من جهة ثانية[1].
ويعتبر كتاب الدكتور خالد يايموت “النخبة والسلطة بالمغرب أطروحات في الإصلاح السياسي”، محاولة جادة لتناول دور النخبة المغربية المعاصرة في طرح إشكالية الإصلاح السياسي من زاوية دستورية وسياسية وفلسفية. وقد صدر الكتاب عن عقول للثقافة للنشر والتوزيع بشراكة مع مركز معارف المستقبل للبحوث والدراسات – الطبعة الأولى، 2024م، وعدد صفحاته 263.
مضامين الكتاب
يحاول الكتاب أن يقارب موضوع الإصلاح السياسي وفق رؤية مقارنة بين اجتهادات الإصلاحيين في حقل سياسي مغربي باستحضار نموذجين والمقارنة بينهما على مستوى الطرح. ويؤكد في البداية أن الإصلاح ليس مشروعا ولا هماً للنخبة الحزبية فقط بل تناولته بالتنظير والتحليل النخبة العلمية المغربية. وتفاعل الوسط الأكاديمي الوطني مع ما يدور في الحقل السياسي من صراعات، وأطروحات لمشاريع الإصلاح السياسي والدستوري.
ويقصد المؤلف في هذا الكتاب بالإصلاح: رؤية معرفية شاملة، لها مدركاتها السياسية الخاصة، ونسقا ثقافيا ناظما لشؤون الحياة، ولتنظيم العلاقة بين البنى والنظم المعرفية الذاتية. وهذه الرؤية المعرفية هي التي تخلق نظرة متجددة ومتفاعلة مع أصول الخبرة التاريخية. كما أن المدركات، هي التي تقود الفعالية المجتمعية وممارستها السياسية، وترسم اختيارات الناس، وممارساتهم في بناء المؤسسات الأهلية والسياسية.
كما يطرح الكتاب الإصلاح باعتباره رؤية معرفية شاملة، مؤطرة لعملية التحديث السياسي. مما يعنی تجاوزا معرفيا لفكر “التثنية” الموروث عن الانقسامية، والمستوردة من الفكر الأنثربولوجى للإمبريالية الغربية. ذلك أن المؤلف يدافع عبر نماذج من أطروحاته المختلفة، على خبرة تاريخية، وحقيقة واقعية مفادها أن عملية الانقسام المفترضة في الفكر والمجتمع المغربي، لم تصبح في أية فترة من تاريخ الفكر والاجتماع السياسي المغربي، واحدة من الوقائع المدمجة في الرؤية المعرفية للمجتمع المغربي. بل إن ملامح ومؤشرات “الانقسام” تتعرض منذ ثمانينات القرن العشرين لعملية التجاوز السلس مغربيا وعربيا. (مقدمة الكتاب، ص: 9\10)
فلا يمكن اليوم الحديث من داخل النسق الإجتماعي أو من داخل النسق السياسي المغربي عن انفصال المجتمع المغربي المعاصر، عن المحددات والمدركات الجماعية، الدينية أو الساسية التي تكون الهوية التاريخية الحضارية للأمة المغربية. كما أنه من الصعب الحديث عن انفصال النخب المغربية التي طرحت المشاريع الإصلاحية السياسية، عن العناصر المكونة لهذا المجتمع ونظامه السياسي و المعرفي الديني.
لقد كان الإطار المرجعي الإسلامي حاضرا مع بناء دولة الاستقلال، حيث قادت الملكية، والحركة الوطنية مرحلة جديدة من مشاريع الإصلاح وتحديث الجهاز الإداري والعسكري، وبناء المؤسسات السياسية. وكانت جهود بناء الدولة في هذه المرحلة، امتدادًا طبيعيا لما طرحته الإصلاحية المغربية في القرن 19 وبداية القرن العشرين “مع مشروع الدستور المغربي الأول لسنة 1908م“. (مقدمة الكتاب، ص: 11)
وقد بدأ التعارض بين النخبة السياسية مع النظام المغربي بمجرد تبني النخبة وإيمانها بحتمية الالتحاق بالحداثة الغربية. وبالخصوص بتبني الاشتراكية مدخلا مرجعيا لتحقيق حداثة المغرب. وتم اتهام النظام بكونه “راعيا” للدولة التقليدية الرجعية، ومعرقلا لأي إصلاح يحقق الحداثة السياسية العلمانية. وترتب عن هذا خلق ثنائيات فكرية تعكس إيديولوجية الحداثة المُعلْمَنة.
وسيعمل المؤلف على معالجة مسألة الإصلاح والتحديث السياسي، مع افتراض أنهما لا يتصادمان مرجعيا، ولا في الخبرة الاجتماعية. ولا بد من التأكيد هنا، أن التجارب التاريخية المغربية، تظهر أن الإسلام يتأطر بالمرجعية الإسلامية في حالة التقارب والتشارك بين النخبة السياسية والنظام السياسي السلطاني والملكي. وأن هذا التقارب يتم تفعيله عن طريق تحديث جوانب متعددة من الحياة العامة السياسية. يشير إلى ذلك عودة هذا المسار للظهور مجددا في مشروع الإصلاح السياسي الأخير، والذى شاركت فيه مختلف القوى المجتمعية والسياسية، بمبادرة من الملك محمد السادس سنة 2011م . (مقدمة الكتاب، ص 12\13)
لقد استطاعت الملكية بقدرتها المتجددة، مع الإعلان الدستوري الأخير، على إعادة بناء «التعاقد السياسي مع المجتمع المغربي، تحت ظلال خبرته التاريخية الخاصة والمتميزة. وارتكزت هذه المرة على ثوابت مرجعية قديمة، وهي الإسلام والملكية والوحدة الترابية، وأضيف إليها الاختيار الديمقراطي ليصبح رابع ثابت دستوري غير قابل للمراجعة. (مقدمة الكتاب، ص: 15)
الكتاب لا يستهدف تحقيـب بنية الفكر النخبوي وتحيزات الإبستيمولوجية، وتطوراته الإيديولوجية والحزبية بالقدر الذي يحاول عرض واستنطاق منطق الفكر الداخلي، ورؤيته للإصلاح السياسي، عبر نماذج اختارت لنفسها تحيزات إيديولوجية ومنهجية، فإن الكاتب يتطلع إلى أن يكون هذا العمل حجرة في بركة تحليل الفكر النخبوي المغربي الراكدة، والكشف عن سياق إنتاج الفكر السياسي المغربي المعاصر.
ولأن الكتاب لا ينشغل بالتحقيب بل يستعمل السياق التاريخي لأفكار الإصلاح المغربي. فإن صاحبه اختار كلا من المفكر علي أومليل، وناقش فكرة الدولة الحديثة من خلال كتاباته وارتباط ذلك ببعض القضايا مثل الديمقراطية والإختلاف والتراث. قبل أن ينتقل إلى طرح وتحليل أطروحة عبد الله العروى، المتعلق بالدولة القومية والحداثة والتحديث. كما أن المؤلف يهدف من خلال كل هذا، إلى طرح إشكالية بناء مدرسة مغربية في الفكر السياسي. تستأنف مسار خبرة تاريخية مغربية، لها دورها البارز ومسارها المتميز في ثقافة وتاريخ البحر الأبيض المتوسط. واحتفظت لنفسها على الدوام بصلاتها العميقة بالشرق العربي وإفريقيا. (مقدمة الكتاب، ص: 16\17)
وقد تضمن الكتاب بعد المقدمة التالي: الفصل الأول عنونها: السياق التاريخي وتحولات الواقع السياسي، وبه مبحث أول: النخبة الحزبية والإصلاح الدستوري، ومبحث ثان: الدولة الديمقراطية الحديثة أطروحة علي أومليل نموذجا. الفصل الثاني عنونه بـ: نظرية التحديث السياسي وبناء الدولة القومية، ومبحثه الأول: العلمانية ونظرية التحديث، والمبحث الثاني: الحداثة والتحديث السياسي: أطروحة عبد الله العروي نموذجا.
خاتمة
حاول هذا الكتاب طرق موضوع تنظيرات النخبة المغربية لمسألة السلطة. وقدم في معرض تحليله للإشكالية المدروسة بعض الملاحظات القصد منها إغناء الفكر السياسي المغربي والدفع به لإعادة قراءة ما أنتجته الفلسفة الغربية. وتجاوز النظرية السياسية التقليدية للقرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. خاصة وأن الجهود المبذولة في مجال التفكير العقلاني، تحتاج من جديد إلى عقلنة رؤيته المعرفية، ووضعها في سياق تطور علم تاريخ الأفكار، والبحث في العلاقة المباشرة والفعالة للتراث الحضاري الإسلامي في تجاوز القرون الوسطى الأوروبية.
وقد خلص إلى أن أطروحات عبد الله العروي وعلي أومليل، لم تبدد في النهاية الضباب الكثيف الذي يلف إشكالية الدولة الحديثة، ومفاهيم الإصلاح والتحديث السياسي. فقد عمل المفكران على التبني السلفي لبعض الطروحات الإيديولوجية القديمة لفكر الأنوار الفرنسي ممزوجة بإسهامات هيجل وماركس، وماكس فيبر بخصوص الدولة الحديثة. ويبدو أن هذا العطب المعرفي جعل جزءا مهما من النخبة المغربية حبيسة الفكر الغربي للقرن التاسع عشر وحرمها من الاندراج العلمي في الفكر الحداثي النقدي الغربي المعاصر، والأطروحات العلمية العالم ما بعد الغرب.
وقد ركز الكاتب في معرض تناوله لجوهر هذه الإشكالية، على الفكرة المركزية للمفكرين عبد الله العروي وعلي أومليل. ورسم خطاطة تحليلية لأطروحاتهما المعرفية ودعواتهما الفكرية والسياسية، القائلة بضرورة الخروج من التأخر التارخي.
وتوصل إلى أنه لا يبدو في الأفق أن الدولة الحديثة العربية، قادرة على صياغة نموذج جديد للتحديث. فخبرتها السياسية تؤكد عجزها على بناء انتماء محلي ومشروعية تداولية للسلطة، وللمؤسسات الديمقراطية. كما أن غياب المشروعية السياقية، منعها من التحول إلى حالة اجتماع سياسي محلى أو إقليمي قادر على خلق تكتل دولتي مشابه أو مطور لتلك التكتلات الدولتية التي سبقت الفترة الاستعمارية في السياق العربي الإسلامي. (الكتاب، ص: 216\222)




















