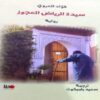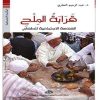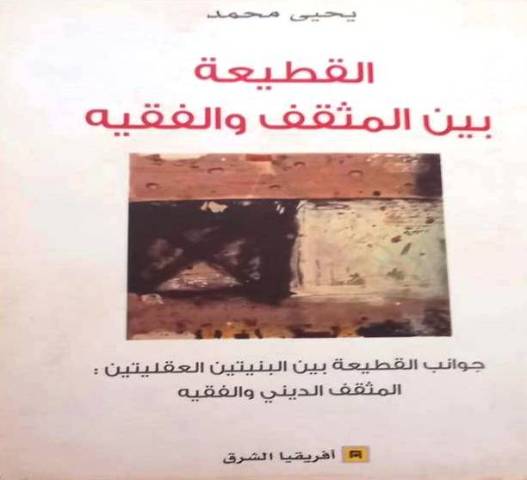
المحتويات
توطئة
إن العلاقة بين الفقيه والمثقف تثير العديد من التساؤلات، بعضها مرتبط بالمفهوم وآخر بالعلاقة الوظيفية بينهما والأدوار. وإذا كان دور الفقيه أساسا في جعل المنظومة الفقهية تواكب ما استجد للناس من أقضية ونوازل، وذلك عن طريق استنطاق النصوص الشرعية “القرآنية والحديثية” والإجابة عن حاجات الناس المرتبطة بتدينهم وبالقضايا التي تحول دون تحقق هذا التدين مثل التطرف، والغلو، والإرهاب.. في أبعادها ومصادرها المختلفة والتي تستند إلى النصوص الدينية وغير الدينية، فإن عمله يظل قاصرا في مواجهة الإشكالات التي يفرضها الواقع المعاصر، إذا لم تتم الاستعانة بالخبراء في مجال الفكر والثقافة. وإذا كان علماء الدين وفقهاء الشريعة معنيين بإيجاد أجوبة فقهية أحكامية على مختلف النوازل التي يسأل عنها الناس لارتباطها بتدينهم، وإذا كانوا معنيين أيضا بدحض الأسس الفقهية والشرعية التي تستند إليها الأفكار المتطرفة الدينية واللادينية، فإن المثقف أو المفكر الديني معني بإبراز فلسفة الإسلام ومقاصده الكبرى، كما أنه معنيٌّ أيضا بالحفر في الأسس الفكرية والاجتماعية التي تتأسس عليها الأفكار المتطرفة. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الكتابات التي تتحدث عن المثقف وعلاقاته. والغالب على هذه الكتابات هو أنها سلطت الضوء على الأفكار الأيديولوجية التي حملها هذا الكائن، خصوصاً فيما يتعلق بمواقفه السياسية وأطروحاته التبشيرية. ويهدف كتاب “القطيعة بين المثقف والفقيه” ليحيى محمد تسليط الضوء على قضية جديدة لم يتم طرقها بعد، ألا وهي الجانب المنهجي والبنيوي للمعرفة لدى العقل المثقف، بغض النظر عن الاعتبارات الأيديولوجية والمذهبية. وسيتم التركيز حول المثقف الديني دون غيره من أصحاب التوجهات الأخرى. كما سيقوم بتحديد العلاقة التي تربطه بنظرائه ومنافسيه معرفياً. فغرض المؤلف هو إجراء المقارنة وإبراز جوانب القطيعة المعرفية بينه وبين الفقيه.
إشكاليات وتساؤلات
بما أن البحث يستهدف المقارنة بين البنيتين المعرفيتين لكل من المختص متمثلا بالفقيه، وغير المختص متمثلا بالمثقف، أثار المؤلف العديد التساؤلات نعتبرها إشكالية ومن أهمها: ما علة اتخاذ الفقيه نموذجاً دون غيره من مختصي العلوم الدينية؟ ولماذا المثقف دون غيره من فئات المجتمع؟ ثم ماذا يقصد بالمثقف وكيف تحدد بنيته المعرفية؟ ولماذا جعله تحت طائلة غير المختصين مع أن منهم المفكرين والمبدعين، وأحياناً فإن منهم المختصين والفقهاء؟ والسؤال الأهم ما هو مبرر الإختلاف والتنازع بين المختص وغيره؟ وبعبارة أخرى من أين تتولد دائرة النزاع بينهما، فهل هي مجرد وجهات نظر ربما يراها البعض بأنها ناتجة عن ضعف إدراك غير المختص أو جهله لما يقدمه المختص من الأدلة ودقة الصياغة، أو أن الخلاف بينهما هو من نوع آخر له علاقة بالمنهج وليس بدقة الإستدلال وعمق المعرفة؟.
وفي رده على تلكم التساؤلات يرى بخصوص التساؤل الأول، أن لديه عدداً من الإعتبارات تجعلنا نتخذ الفقيه نموذجاً للمختص دون غيره؛ نجملها بما يلي:
- أولاً: إن طبقة الفقهاء كانت وما زالت تلعب دوراً مؤثراً في المجتمع أكثر من غيرها من أصحاب العلوم الإسلامية.
- ثانياً: إن النص في حياة الأمة الإسلامية هو بمثابة روحها، وأن أبلغ من اعتمد على النص فهماً وامتثالا هم الفقهاء.
- ثالثاً: لقد أضحى الفقهاء ومن على شاكلتهم ممن يطلق عليهم النصوصيون سلطة معرفية شبه مطلقة تغطي ساحات التفكير وقضايا العقائد وسائر العلوم الإسلامية في مجتمعاتنا الدينية.
- رابعاً: إن للفقهاء دورهم المتميز في التعامل مع الواقع، خلافاً لغيرهم من رواد العلوم الإسلامية، وستتبين أهمية ذلك ومغزاه بالنسبة لعلاقة المثقف بالواقع.
أما لماذا المثقف دون غيره من فئات المجتمع، فواضح باعتبار أنه يمثل الطرف الوحيد الذي باستطاعته إدراك البعد العلمي والنظري للمختص، وأن يقدم البديل المعرفي بحكم ارتباطه بالمعرفة فهما وإنتاجاً وإن لم يكن من ذوي الاختصاص. وتساءل في الأخير عن ما يقصد بالعقل المثقف؟ وما طبيعة إجابتنا عن سائر التساؤلات التي عرضناها ؟ فهذه القضايا هي لب موضوعه والتي سيتناولها بالتفصيل في هذا الكتاب. (الكتاب، ص: 10)
مضامين الكتاب
لقد جرت معالجة هذه الدراسة ضمن محورين مختلفين، وهما كالآتي: الأول: ويتحدد بملاحظة الخلاف الحاصل بين التوجهات المعرفية للمثقف والفقيه كما هو قائم ومجسد في الواقع؛ عبر التركيز على نماذج بارزة لفئة المثقفين ومقارنتها بمسالك الفقهاء معرفيا. والثاني: يتعلق بالمقارنة بينهما ككائنين صوريين مجردين عن الواقع الموضوعي، أي باعتبارهما عقلين منتجين للمعرفة، فأراد التعرف على هويتيهما البنيويتين كماهيتين صوريتين محددتين تبعا للوظيفة المعرفية التي يقومان بإنجازها. على هذا فقد صنف الكتاب إلى قسمين رئيسيين ضمن إطار ما سماه المثقف والقطيعة مع الفقيه، فأطلق على الأول (القطيعة التشخيصية)، وعلى الثاني (القطيعة البنيوية)، حيث تناول في الأول تحديد هوية المثقف وأصنافه المتعددة ومنها المثقف الديني، ثم قام بمقارنة مسالك الصنف الأخير مع مسالك الفقيه التقليدية. كما تناول في القسم الثاني طبيعة المرتكزات المعرفية التي يتأسس عليها العقل الفقهي والعقل الثقافي، إذ كما هو معلوم أنهما يختلفان في المصدر والآلية والأصول المولدة للمعرفة، ثم كشف بعد ذلك عن جملة من الخصائص المعرفية القائمة على المرتكزات لكل منهما. وبالتالي أظهر عمق تباينهما وخلافهما، وهو معنى القطيعة العقلية أو المعرفية بينهما. وقد عزا علة هذه القطيعة إلى الاختلاف التكويني لمصدرهما المعرفي، فهو لدى الفقيه عبارة عن النص، لكنه لدى المثقف يتمثل بالواقع، أي أن الأول قد تمسك بكتاب الله التدويني، في حين تمسك الآخر بكتابه التكويني. وفي نهاية البحث اقترح بعض الإصلاحات التي من شأنها القضاء على موارد الضعف المعرفي والمنهجي عندهما. كما مهد لهذا البحث مدخلاً تناول فيه الأدلة التي تثبت وجود تكافؤ معرفي للأحكام المنضبطة بين المختص وغير المختص، لتبرير عمل المثقف المعرفي قابلة الفقيه ومنافسته له في الحجج المعرفية.
وهكذا فقد تضمن الكتاب – الذي يقع في 239 صفحة عن دار إفريقيا، ط 2013م- بعد التمهيد قسمين الأول عنونه بالقطيعة الشخصية، وعنون الثاني بالقطيعة البنيوية ويتكون من فصلين، الفصل الأول: المرتكزات المعرفية، والفصل الثاني: الخصائص المعرفية.
خاتمة
خلص البحث إلى أن هناك موارد للصدام والتقاطع بين العقلين المثقف والفقيه تجعل أحدهما يقف في طرف قبال الآخر، وأن مبررات هذا التقاطع نابعة مما لديهما من اختلافات جوهرية حول المرتكزات المعرفية، مع ما يحتاج كل منهما من إصلاح. فما يحتاجه الفقيه هو الاعتراف بمرجعية الواقع والوجدان العقلي كمصدرين أساسيين في التكوين المعرفي، بغية أن تتحول الممارسة المعرفية لديه مما هي ذات طابع ما هوي إلى طابع وقائعي عقلائي. أما ما يحتاجه المثقف الديني فهو الوضوح المنهجي والتخصص.