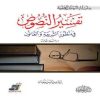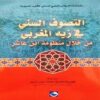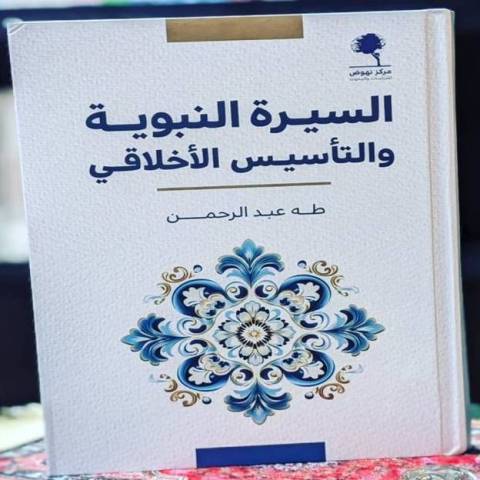
المحتويات
توطئة
كتاب “السيرة النبوية والتأسيس الأخلاقي” للفيلسوف طه عبد الرحمن هو عمل فلسفي عميق يتجاوز السرد التاريخي للسيرة النبوية ليقدم قراءة أخلاقية لها. والكتاب صادر عن مركز نهوض للدراسات والأبحاث، الذي يقع في 430. ويعتبر فيه السيرة النبوية أساسًا لبناء الأخلاق في قيمها وأفعالها وأحوالها. ويقدم مقاربة أخلاقية قائمة على التأويل مستمدة من القيم المُثلى والقواعد الأولى التي تُؤسّس الأخلاق. ويدعو الكتاب إلى إعادة اكتشاف الأخلاق النبوية كمرجعية لإصلاح الأفراد والمجتمعات في العصر الحديث.
كما يفتح الفيلسوف طه عبد الرحمن، في هذا الكتاب ، آفاق “التفكّر” في “السيرة النبوية”؛ فبعد أن كشف حدود المحاولة المنطقية لابن النفيس والمحاولة التاريخية لابن خلدون، عَرَض مقاربته الأخلاقية المتميزة. إذ اتَّبَع فيها طريق “التأويل” في بيان كيف أن” السيرة النبوية” ليست مجرد نموذج أخلاقي متفرّد لا تنفد دلالاته العملية، وإنما هي الأساسُ الثابت الذي ينبغي أن يُبنى عليه عموم الأخلاق، قيمًا وأفعالًا وأحوالًا. وانتهى إلى إثبات أن “تتميم صالح الأخلاق” الذي تحدّدت به “الدعوة النبوية” ليس -في الحقيقة- الإتيانَ بقيم إضافية من رتبة القيم السابقة، وإنما هو تزويد الأخلاق الصالحة بالقيم المُثلى والقواعد الأولى التي تُؤسّسها، وتَـمدّها بالمشروعية.
مفاهيم الكتاب الرئيسية
- السيرة أساس الأخلاق: يرى الكتاب أن السيرة النبوية ليست مجرد نموذج أخلاقي فريد، بل هي الأساس الثابت الذي يجب أن تُبنى عليه كل الأخلاق.
- مقاربة التأويل: يقدم طه عبد الرحمن مقاربة أخلاقية متميزة تعتمد على التأويل، متجاوزًا المحاولات المنطقية والتاريخية التقليدية لدراسة السيرة.
- تتميم الأخلاق: يؤكد الكتاب أن الدعوة النبوية قامت بتتميم صالح الأخلاق، لا بإضافة قيم جديدة، بل بتزويد الأخلاق الصالحة بالقيم والمبادئ الأساسية التي تُؤسّسها وتمنحها المشروعية.
- الأخلاق في بناء الحضارة: يوضح الكتاب كيف استطاع النبي (ص) تحويل الأخلاق إلى أساس متين للحضارة الإسلامية، وأن الدعوة الأخلاقية كانت أكثر أهمية من الفتوحات العسكرية في بناء الأمة.
مضامين الكتاب
أعد الفيلسوف طه عبد الرحمن كتابه للباحثين عن قراءة فلسفية عميقة في السيرة النبوية. ولمن يسعى لفهم أسس بناء مجتمع متين قائم على القيم. ولمن يهتم بإيجاد حلول أخلاقية لمشكلات العصر من خلال استلهام القيم من السيرة النبوية.
اتبع طه عبد الرحمن، في تناول السيرة النبوية، على وجه الإجمال، منهجيات مختلفة أبرزها وأعرفها المنهجيات الثلاث: “منهجية المحدثين” و”منهجية المؤرخين” و”منهجية الفقهاء”.
لقد امتازت “منهجية المحدثين”، كما هو معلوم، بالتزام قواعد غاية في الضبط، اصطلاحا ونقدا وجرحا وتعديلا. وكان هدفها تخليص أخبار السيرة النبوية من سقيم الروايات، حتى كأن الصحة الحديثية هي المعيار الوحيد للانتفاع بهذه “السيرة”.
أما “منهجية المؤرّخين”، فتقيّدت بتتبع وقائع “السيرة النبوية” في تفاصيلها وتسلسلها الزمني أو اختارت أن توزعها على مجموعة من الموضوعات المختلفة. متعاطية جمع الأخبار والروايات الخاصة بكل موضوع منها. وكان هدفها هو استيعاب أقصى ما يمكن من أحداث هذه السيرة، حتى كأن الجمع التاريخي هو المعيار الوحيد للانتفاع بـ “السيرة النبوية”. ولئن كانت ” منهجية المحدثين” قد فضلت منهجية المؤرخين، تدقيقا وتحقيقا، فقد فضلت هذه الأخيرة منهجية المحدثين، توسيعا وتوحيدا.
أما “منهجية الفقهاء”، فقد تولت استنباط الأحكام والقواعد والفتاوى من أخبار السيرة النبوية عقدية كانت أو عبادية أو تعاملية. وشأن هذه المنهجية في الضبط والتحري لا يقل عن شأن منهجية المحدثين. وكان هدفها استثمار هذه الأحكام في تحديد الأعمال والتصرفات المشروعة، حتى كأن “الحكم الفقهي” هو المعيار الوحيد للانتفاع بـ “السيرة النبوية”. (الكتاب، ص: 11)
وقد قسم الكتاب كتابه، بعد المقدمة، إلى ثلاثة أقسام، ولو أنها متفاوتة في الحجم، فإنها تعبر بصورة واضحة عن محتويات هذا العمل. أما القسم الأول فيعرض مقاربة ابن النفيس لـ «السيرة النبوية”. واختصت هذه المقاربة بكونها عبارة عن استدلالات متصلة على نوعين من مسائل هذه السيرة؛ المسائل الخاصة بشخص خاتم النبيين، والمسائل الخاصة بشرع خاتم النبيين. لكن إرجاء ابن النفيس حقائق السيرة إلى اعتدال المزاح ساقه إلى إهمال البعد القيمي في الأوصاف والأفعال محولا الأخلاق إلى مجرد طباع.
وأما القسم الثاني، فيقدّم مقاربة ابن خلدون لـ “السيرة النبوية”، واختصت هذه المقاربة بكونها عبارة عن تعليلات متصلة منضبطة بمبادئ تحليلية ثلاثة؛ أحدها مبدأ العقل المسدد، ويقضى بتجاوز التجريد واعتبار القيم في مسائل “السيرة النبوية”. والثاني؛ مبدأ الدين المعضد، ويقضى باستناد الدعوة الدينية إلى “العصبية”. والثالث مبدأ العصبية المُبصرة، ويقضي باهتداء العصبية بقيم الدين. غير أن إرجاع ابن خلدون حقائق “السيرة النبوية” إلى “العصبية” بمعنى “النعرة” ساقه إلى إهمال الخصوصية الوجوبية للقيم والأساس الميثاقي للرباط الاجتماعي . (الكتاب، ص: 21)
وأما القسم الثالث، فيعرض مقاربة النظرية الائتمانية لـ “السيرة النبوية”، وتفردت هذه المقاربة بكونها عبارة عن تأويلات متصلة لتوصل فيها بحقائق المواثيق الإلهية، وتضمن هذا القسم خمسة فصول: تناول الفصل الأول منها، انطلاقا من “ميثاق الإشهادة”، تخلق الصدق الذي اتصف به محمد، قبل البعثة، متوصلا إلى دلالته الحقيقية، بالنسبة إليه، وهي “التوحيد”. كما عالج الفصل الثاني، انطلاقا من “ميثاق الاستثمان”، خلق “الأمانة” الذي اتصف به محمد صلى الله عليه وسلم، متوصلا إلى دلالته الحقيقية بالنسبة إليه، وهي “العدل”. أما الفصل الثالث، فقد تطرق إلى تخليق رسول الله عقول أصحابه على “الصدق”، مذكرا إياهم بخطاب الله لهم وبإقرارهم بوحدانيته، وبواجب الصبر على الأذى، ثمنا لتوحيدهم. وأما الفصل الرابع، فقد تعرض لتخليق رسول الله الإرادات أصحابه على ” الأمانة” ، منشئا مجتمعا ائتمانيا يقوم على التخلص من نزعة الامتلاك، والتحلي بروح الائتمان، والتمسك بالأخوة الائتمانية. وأما الفصل الخامس، فتناول ” كمال الأخلاق” عند الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم؛ وتجلى هذا الكمال الخلقي في الارتقاء بدلالة “الصدق” على ” توحيد الإله” إلى دلالته على “العبودية لله”، وأيضا في الارتقاء بدلالة ” الأمانة” على “العدل” إلى دلالتها على “الفضل”؛ كما تجلى هذا الكمال في سعي الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم إلى تخليق عقول أصحابه على العبودية لله، وتخليق إراداتهم على “الفضل”. (الكتاب، ص: 22)
خاتمة
تولت الخاتمة؛ بيان دلالة تتميم الأخلاق التي حصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، وكيف أن هذه الدلالة توجب تأسيس الأخلاق على “السيرة النبوية”. وكيف أن هذا التأسيس يتخذ صور التأسيس الاقتدائي، إذ يقدم العلاقة الابتدائية على غيرها في التعاميم مع القيم الأخلاقية والمعاني العليا التي تنطوي فيها.
إن مما ميز الكتاب أنه تجاوز التركيز على الأحداث والغزوات في السيرة النبوية. وقدم رؤية فلسفية عميقة للسيرة، لا تكتفي بسرد الأحداث بل تفسر كيف تم بناء أمة عظيمة على أساس الأخلاق. وهو دعوة لإعادة اكتشاف الأخلاق النبوية كمرجعية لإصلاح الأفراد والمجتمعات.