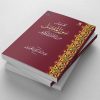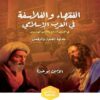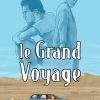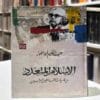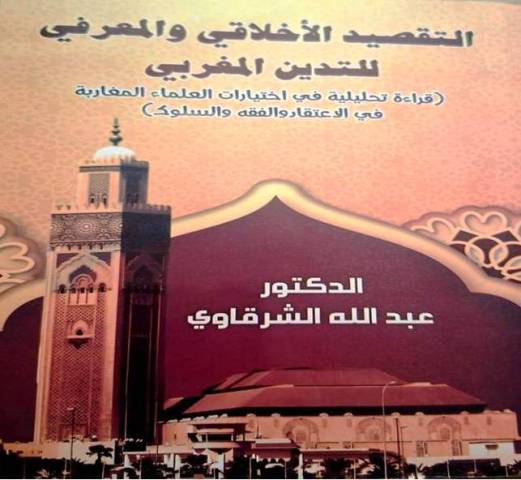
المحتويات
توطئة
يركز التدين المغربي بشكل أساسي على الجوانب الأخلاقية والسلوكية، متجنبًا التعقيدات الفكرية والفلسفية للتدين الشرقي. وتمتلك مؤسسات علمية تقليدية مثل “العلماء المغاربة” معرفة واسعة بهذا التدين، الذي يتسم بالحفاظ على الفطرة والبعد عن الغلو والتطرف في العقيدة والسلوك. كما يرتكز الجانب الأخلاقي والمعرفي للتدين المغربي على البساطة والوسطية في العقيدة. ويتبنى التيار الصوفي السني في المغرب موقعًا وسطًا في العقيدة، بعيدًا عن التشبيه أو التعطيل في صفات الله. ويرتبط بالمذهب المالكي، ويبتعد عن التعقيدات الفكرية، ويعتمد التأصيل العملي للدين، ويبني هوية دينية متفردة. وإن من المصادر الرئيسية للمعرفة: التصوف السني، وعلم الكلام الذي يتداخل في المغرب مع التصوف، ويركز على ترسيخ الاعتقاد السليم لدى المغاربة، بالإضافة إلى التراث العلمي والاجتماعي حيث يعتمد علماء المغاربة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي في فهم وتأصيل التدين المغربي.
دواعي التأليف
إن الدافع الذي دفع الكاتب إلى تناول هذا الموضوع في هذا الوقت هو ما لاحظه من السيولة في التدين العام بشكل ملفت للنظر. بسبب العولمة الفكرية التي تلبس الحق بالباطل في بعض الأحيان، فجعله ذلك يراجع نفسه التي تدعوه إلى ترك الكتابة في مثل هذه الأمور الشائكة التي تزل فيها القدم وتحتاج إلى خبرة علمية وميدانية بحركة التدين في المغرب.
لكن لما رأى ما يذهل العاقل في واقع التدين من الخلط بين المرجعيات والمناهج حتى تلاشت الحدود الفاصلة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت منبرا لمن لا منبر له. فقد أدى ذلك إلى السيولة في المعرفة والأخلاق التي حولت القيم الإنسانية إلى الشيئية القابلة للتفاوض في سوق الاستهلاك المادي عبر السماسرة المحترفين للمكاء والتصدية مقابل الاعتياض. وأصيب التدين بغبار هذا الاحتراف المنتشر في فضاء هذه الشبكات التي أتاحت الفرصة لكل راغب في الحديث أو الكتابة دون قيد أو شرط. فامتد ثوب التفاهة إلى الكلام في الدين إلا من رحم الله وهم قلة، فتعلقت إرادة المؤلف بالمساهمة بهذا البحث في تنبيه الغافل الشارد في غفلته بكثرة ضجيج المعلومات على المنصات التواصلية التي أربكت تدينه بالحيرة في اختيار الصواب، أو تذكير المسكين في بضاعته المعرفية بالدين مثل الذي يدخل إلى سوق التواصل فيرى فيه كل شيء قابلا للتغير، كأنه على كثبان رملية متحركة .
إضافة إلى ما سبق، فقد عايش الكاتب واقع التدين المغربي عن قرب أزيد من ثلاثة عقود تقريبا منها عقدان في تدبير الشأن الديني في الميدان مدته هذه التجربة الميدانية بمعرفة لا تصادف في ملفوف ولا توجد مصنف، فصاغ منها رؤية شاملة لأصول التدين المغربي المستمدة من المنحى المعرفي لأهل المدينة، فأغرته هذه الرؤية الأولية لينفق أعظم وقته في قراءة تاريخ التدين المغربي في ملامحه العامة من الدولة الإدريسية إلى الدولة العلوية الشريفة. (مقدمة الكتاب ص 15)
منهج الدراسة
وللوصول إلى المراد من هذه الدراسة استخدم المؤلف المنهج التحليلي للتدين المغربي عبر اختيارات العلماء المغاربة في الاعتقاد والفقه والسلوك والإمامة العظمى، بمعرفة تكاملية بين الثوابت وليس التركيز على وصف المعلومات المشكلة للتدين التي من شأنها تضخيم البحث بما يمكن الاستغناء عنه.
وأضاف إلى ذلك أنه حدد بعض الأسباب التي تصنع التدين الفئوي الغريب على طبيعة المغاربة. ومنها تعدد المرجعيات في قراءة نصوص الشريعة والمذهب المالكي، أو العقيدة أو السلوك. فينتج عن ذلك تنزيل الأحكام الجزافية على الناس بناء على المواقف التي تحددها المرجعية المعتمدة في تصنيف تصرفات الناس القولية والفعلية. وطرحت بعض البدائل المنهجية لاستثمار التدين المغربي في التنمية الحضارية. وكل هذا رمى فيه الاختصار باكتفائه أحيانا بالإشارة إلى المرمى والمقصد ليترك للقارئ والمتعقب مدخلا واسعا للنصح والتسديد.
وفتح الدراسة بتحديد المفاهيم المؤسسة للطرح المنهجي، لأن المفاهيم تتشكل من الخلفية العقيدية للنسق الحضاري. لأن الجهل بالمفاهيم يؤدي إلى الخلط في المعاني فيتولد من ذلك فساد معرفي وأخلاقي فتضطرب المجتمعات في تدينها. وختم البحث بتأكيد خلاصة أن المغرب يملك إرثا حضاريا مميزا بالتنسيق المحكم بين العلماء وإمارة المؤمنين عبر تاريخه. وفيه من العبر والإيجابيات التي تجعل كل مهتم وعامل يقنع بفعل الممكن إن لم يستطع فعل الواجب بتمامه للنهوض بالتدين علما وعملا واستقرارا.
مضامين الكتاب
يعد كتاب “التقصيد الأخلاقي والمعرفي للتدين المغربي.. قراءة تحليلية في اختيارات العلماء المغاربة في الاعتقاد والفقه والسلوك” للدكتور عبد الله الشرقاوي، الصادر سنة 2025م في طبعته الأولى عن مطبعة رؤى برينت، والذي يقع في 242 صفحة، طبع بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -يعد- لبنة في بيان اختيارات المغاربة في الاعتقاد والفقه والسلوك.
فموضوع هذا البحث يهدف أساسا إلى إظهار مميزات التدين المغربي من خلال دراسة تحليلية لاختيارات العلماء المغاربة في الاعتقاد والفقه والسلوك. ودور الإمامة العظمي في تدبير وحماية هذه الاختيارات الضابطة للتدين الجمعي للمغاربة من النزاعات الطائفية أو الإيديولوجية التي من شأنها زعزعة الاستقرار الجمعي.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن التدين الجمعي للمغاربة يتميز بالتكامل بين وظيفة العلماء، ووظيفة الإمامة العظمى في خدمة الأمة عقيدة وشريعة وأخلاقا، انطلاقا من مرجعية واحدة. وهي مرجعية المدينة في الاجتهاد المطلق بقيادة الإمام مالك رحمه الله لصياغة التدين الجمعي، مرجعية محلية تراعي الواقع المغربي في صياغة التدين عبر الاختيارات الدينية والوطنية. فكان التلاحم بين علماء الأمة والإمامة العظمى في خدمة المصالح العليا للأمة، وحماية تدينها الجمعي، لأن شرعية الإمامة العظمى والتدين المغربي انطلاقا من مرجعية واحدة، مما حمى المغاربة من النزاعات البغيضة بين التدين الرسمي والتدين الشعبي. (مقدمة الكتاب ص 5\6)
وقد جاءت هاته الدراسة مكونة بعد المقدمة من ثلاثة عشر فصلا على الشكل التالي: الفصل التمهيدي: بين يدي الدراسة. الفصل الأول: مفاهيم ودلالات علاقة الأخلاق بالمعرفة. الفصل الثاني: مفهوم الدين والتدين وعلاقتهما بالمعرفة والأخلاق. الفصل الثالث: مفهوم التقصيد الأخلاقي لغة واصطلاحا. الفصل الرابع: التقصيد الأخلاقي في التمييز المنهجي بين العقيدة والفقه. الفصل الخامس: المنطلق المعرفي والمنهجي للاختيارات الدينية للمغاربة. الفصل السادس: هوية المنحى المعرفي لأهل المدينة أساس المعيارية المرجعية المغربية. الفصل السابع: التأصيل الشرعي للاختيارات الدينية للمغاربة. الفصل الثامن: التكامل المعرفي والأخلاقي للاختيارات الدينية للمغاربة. الفصل التاسع: أثر الواقع المغربي في صياغة الاختيارات الدينية دور الإمامة العظمى في حمايتها. الفصل العاشر: مفهوم المرجعية المغربية وخصائصها وشروطها. الفصل الحادي عشر: أثر المعيار الفقهي في المرجعية المغربية في التدين بالعقيدة الأشعرية. الفصل الثاني عشر: أثر المعيار الفقهي في المرجعية المغربية في التدين بتصوف الجنيد. الفصل الثالث عشر: التدبير الاستراتيجي لحماية التدين من السيولة الأخلاقية. ثم الخاتمة.
خاتمة
ويمكن تلخيص ما توصل إليه المؤلف في التالي:
- إن الميزان الذي وزن به العلماء المغاربة الاختيارات الدينية هو الواقع المغربي في عملية التنزيل والعوامل المؤثرة فيه.
- إن العلماء المغاربة اتخذوا المعيار الفقهي من المذهب المالكي في التدين بالثوابت الدينية حتى لا يتعرض المجتمع في تدينه للتصنيف والتقييم العقيدي.
- إن العلماء المغاربة فرقوا بين التقرير العقيدي البسيط الخالي من التعقيدات الكلامية، فجعلوه أساسا للتدين الجمعي، وبين القضايا العقيدية المختلف فيها بين العلماء فحصروها فى أهل الاختصاص.
- إن هذه الاختيارات الدينية مؤسسة على تكامل معرفي وأخلاقي، بين الإسلام والإيمان والإحسان.
- إن أزمة الأمة تتجلى من وجهة نظري في فهم المنهج في كلياته الثابتة. وفقه تنزيله في واقع خاضع للاستحداث والتنوع في مجالات الحياة كلها. مما جعل بعض الفضلاء المشتغلين بالدعوة إلى الإسلام أن يقدم الإسلام حلا للمجتمع من خلال صور التدين التاريخي السالم عبر نماذج من القيادات الإسلامية الناجحة.