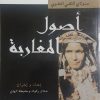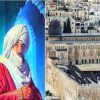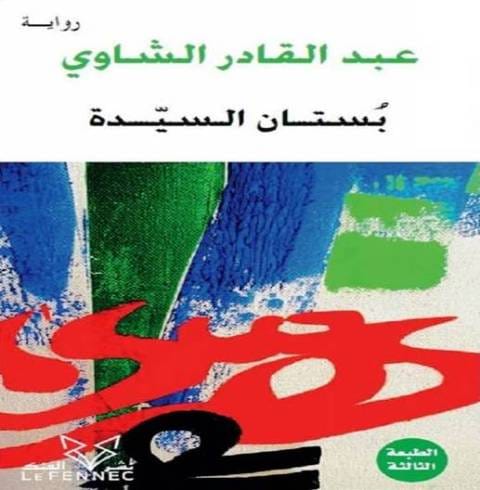
المحتويات
توطئة
عبد القادر الشاوي روائي مغربي مدين لفترة اعتقاله الطويلة، توج في رحاب قصر الحمراء في غرناطة، بجائزة «ابن رشد للوئام»، التي تكافئ المؤسسات أو الأفراد، مغاربة وإسبان، العاملين في مجال تعزيز التعايش والحوار بين الثقافات. وهو صاحب روايات: “كان وأخواتها” و”باب تازة” و”دليل العنفوان” و”من قال أنا/ تخييل ذاتي” و”الساحة الشرفية” و”مرابع السلوان” و”مربع الغرباء”. ويبقى العامل المشترك بين هذه العناوين جميعا، “فضلا عن الموضوعات المختلفة المتعلق بعضها بمفهوم الخراب في علاقة بالماضي، وبالذات في علاقة بالزمن، وبالتاريخ في علاقة بالتطور، فإن الموضوع المشترك، يتعلق أساسا بالذاكرة، مع الاعتقاد الراسخ بأنَّ ذاكرتنا حاضرة فاعلة مؤثرة، حسب الدواعي والمجال وبأكثر أدوات التأثير قدرة، على تأكيد (والتَّحَقُّق) من بعض مفارقات تجاربنا، أو أحداث ماضينا، أو طبائع العلاقات العامة التي كانت لنا مع الأفراد والأمكنة والرؤية في الزمان والمكان”.[1]
مضامين الرواية
تبدأ أحداث الرواية، من مشروع ترجمة كتاب من العربية إلى الفرنسية، بعد أن طلب صاحب دار نشر من سعد مساعدته على إيجاد مترجم. ستتدخل صديقته وحبيبته السابقة مريم البدري لتقترح عليه اسم صديقتها الحميمة، الشاعرة حنان الداودي التي اشتغلت على العديد من الترجمات واستطاعت أن تمنح نصوصا عديدة حيوات أخرى في لغة أجنبية، وعجزت عن أن تبقي على حياتها.
سعد وسيط الترجمة، سيصبح ترجمانا للأشواق الدفينة، مُشعلها وموقد حرائقها التي سيصطلي بها أيضا، وستمنحه حنان المنتحرة، مذكرات ويوميات ورسائل… ما ينقذه من الموت.. أقصد ذلك الجفاف والانحباس في الكتابة الأدبية الذي أنهكه، إذ نشأت علاقة عشق سرية حالمة أو واهمة أو مفترضة، بين سعد الموظف في شركة إسبانية للاتصالات وحنان المتزوجة من كريم السعداني الذي يوجد على حافة الموت بسبب مرض عضال. وإذا صح أن وراء كل رواية عملية قتل ما، فإن الكاتب يمنح موتاه جنازة تليق بهم، أو يعيد بعثهم في نص حكائي باذخ مبنى ومعنى.. هو “بستان السيدة”.
تنمو الحكاية انطلاقا من الذاكرة، وعبر الأثر الذي تركته حنان الداودي مكتوبا أو موشوما في رسائل إلكترونية حارقة وقلقة بين سعد وحنان. وحين تكتمل الحكاية في ثنايا الألم وتواشجاته، يمنح سعد مشروعه الإبداعي بدمه على خذه إلى قارئه الأول لنصوصه الإبداعية صديقه أحمد الناصري، الذي يوسع متاهة الحكاية عبر فتح كوة نحو نص روائي إسباني “الوداع الأخير” للكاتبة الإسبانية سليبيا جويس، الذي يتحدث عن علاقة مستحيلة بين ساندرا وعشيقتها/معشوقتها مونيكا…
يمنح نص “بستان السيدة” للمبدع عبد القادر الشاوي معنى حيويا لمفهوم أن الرواية جنس حر حد الاعتباطية، أي جنس مفتوح على كل الإمكانات الجمالية، تستدعي الحلم والتأمل والوهم وأشباهه، عبر كتابة تسلط الأضواء وتضع نقط الاستفهام، ليس فقط حول القيم والعواطف والعلاقات والأنساق والبنيات والتمثلات… ولكن أيضا حول معنى وقيمة مكانتها التاريخية والاجتماعية كما يؤكد ميشيل زيرافا.
إن النص السردي الأخير للشاوي، غير قابل للاحتجاز النصي، برغم تنصيص المؤلف على جنس الرواية على صدر الغلاف، لكنه ذاته سرعان ما يخرق هذا العقد القرائي في مفتتح النص بالحديث عن الحلم، وهي العبارة التي أضحت مثل عنوان فرعي في الصفحة الموالية للغلاف، بل إن سارده يمنح القارئ حرية التجنيس: “في هذا العمل (سمه رواية إن أحببت)”. (الرواية، ص: 5)
يرسم النص مساره الحر في ذاكرة المتلقي المفترض ليرسو على شكله الأجناسي، إذ المؤلف لا يفرض صيغة “رواية” إلا بما تفرضه مواضعات المؤسسة الأدبية، لكنه في فجوات النص ومضمراته، يقوم نص “بستان السيدة” على الالتباس، الاشتغال على النص أثناء كتابته ومساءلة أدوات الكتابة، موضوعا وأسلوبا وبرنامجا سرديا.
لقد قدّم الشاوي روايته “بستان السيدة” على أنها توهم القارئ بعلاقة حميمية مستحيلة، إذ تتحدّث عن امرأة غير موجودة في الواقع، بل توجد بتعدّدها؛ فهي شخصية متناقضة انتقلت من مجال إلى آخر على المستوى العقدي، وعاشت تبعية وشبه عبودية بين الانطلاق والتحرّر على المستوى العاطفي، كما عاشت بين الاندماج وعدم الاندماج، لتمثّل بذلك المقابل الأنثوي لشخصية ذكورية تعيش حياة من الطبيعة نفسها.
ويرجع تاريخ كتابة هذه الرواية إلى سنة 2007، ونُشرت بعد مراجعتها، رغم أن الكاتب لم يغيَّر فيها الكثير، لأن قدرَ الكاتب الأدبيَّ هو أن يكتب الرواية بهذه الطريقة التي فيها “نوع من التمحّن”، وفي عمقها بحث متصل ومتواصل عن الموضوعات والأساليب والشخوص.
وقد جاءت عناوين الرواية على الشكل التالي: كيف أن الانتحار يكون نهاية، انتحرت حنان؛ ما الأسباب ما النتائج، هدفي من الكتابة، صراحة، القارئ أحمد الناصري، رائعة سيلبيا جويس، الاقتراب والابتعاد، قبل الرواية، اللهفة، القرب، قبل “الإجفال”، الإجفال، الرواية، قرب النهاية.
وصف الشاوي روايته بأنها: “مركبة في تقنياتها وأسلوبها وموضوعها، وبنيتها النصية. فالبنية التقابلية التي تتألف من مربعين، الأول فيه حياة يلم الكاتب والشخصية وسعد، وهي مجرد أقنعة تناوب على تشكيل المعنى بطريقة شضرية. فيما المربع الثاني الذي يضم حنان وكريم لهما حياتهما الخاصة في باريس ومدريد، وهي مجموعة أقنعة تتناوب، وتعمل على تشييد المعنى في بناء الرواية بتراسل نصي، على حد تعبير الروائي. وأن ما يجمع ذلك أربعة روابط أساس، الأول يتمثل في سبب المعرفة، والثاني في محاولة التقاط عناصر حياة كل منهما “هي في مدريد، وهو في باريس”، والثالث سيرة سهلت عملية الالتقاء، والرابع رابط معنوي ونصي، حيث يكتب عن رواية أخرى “مفترضة” فرنسية/إنجليزية، في علاقة ثنائية بين فتاتين من نفس الشكل. وقد بدأت بفصول قصيرة، وانتهت بتقرير، وفيها نوع من التشظي، لأن هدف المؤلف أن يوصل فكرة اللامعنى، وأحيانا العدم والاستحالة بسبب تأثيرات قرائية معينة، لأن الوحدة تكرس التماهي، والاختلاف يفرز الاستحالة.
خلاصة
“بستان السيدة”، رواية زئبقية بامتياز، بلغة إشارية ذات نفس صوفي، فالعنوان نفسه ذو منشأ صوفي من بستان السيدة فاطمة الزهراء إلى “بستان الواعظين ورياض السامعين” لابن الجوزي، وكتاب “بستان العارفين”، ليحيى بن شرف النووي، وحلقات المديح والسماع الصوفي الذي يسمى لدى الصوفية “بستان السماع”. ولغة الحلم لأن الرواية كلها هي خيال ورؤيا، كقوله: “غير أنني أرى لقاء ما يدعوني إليه”، و “حلمت بأن اللقاء الباريزي”، و “أنت في حلمك يا هذا ذاهب إلى باريس”، و”كانت تلك الأيام في الحلم باردة”، و”هل كان من المفروض أن أتوقع كل شيء في الحلم.
يظهر عبد القادر الشاوي وكأنه يتخطى الحدود ليصور الحالات الإنسانية لشخوصه الروائية، يصور الصعوبات التي لقيها الراوي في كتابة الرواية، كما يصور صعوبات الشخوص في الرواية، كما أنه يقدم نفسه ناقدا لهذا الواقع الذي تتواجد فيه هذه الشخوص، في مختلف اللحظات، من البداية إلى النهاية، مع أسلوب حافظ فيه الروائي عبد القادر الشاوي كملاحظ ومراقب لهذه المجريات التي سارت عليها الأحداث طوال فصول الرواية.