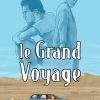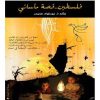المحتويات
توطئة
تُعتبر كتب النوازل الفقهية، سجلات حية للفتاوى والأحكام القضائية التي يصدرها الفقهاء النوازليون استجابة لقضايا واقعية طارئة ومستجدة في المجتمع الإسلامي. فهي مصادر فقهية مهمة لا تقدّر بثمن نظرا لما تُقدم من فهم لتحولات المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي. وبالتحديد في منطقة الغرب الإسلامي التي نشتغل بها، كما تعتبر نافذة مُشْرَعةً على واقع المرأة ومكانتها وحقوقها لا سيما في مجال الميراث.
وموضوع ميراث المرأة الذي نقاربه اليوم والذي أثار جدالا حادّاً في أيامنا هذه، نروم من خلاله معرفة كيف تناولت هذه النوازل حقوق المرأة الإرثية، وكيف كشفت الانتهاكات التي تعرضت لها والتي لم تكن متأصلة في جوهر التشريع الإسلامي، بل غالباً ما كانت نتاجاً لتأويلات بشرية مجحفة، أو ممارسات قضائية جائرة أو متحيزة.
وإن الصيحات الأخيرة التي ارتفعت في بلادنا حول ادعاءات هضم حقوق المرأة في الميراث ليس إلا سوءُ فهم للنصوص الشرعية، أو تحامل على الشريعة الإسلامية بطريقة ممنهجة في محاولة لإسقاط أحكام ما يتعلق بميراث المرأة منها، وأن التعصيب الذي هو مدار النقاش يقفُ حَدّاً فاصلا ضد الاعتداء على حقوق المرأة في الميراث لأنه مبدأ متأصل في الشريعة الإسلامية.
وكما لا يخفى على أحد، فإن نظام الميراث في الإسلام يعتبر نظاماً تشريعيا مفصلاً ودقيقاً، وضعته الشريعة الإسلامية بنصوص قطعية وواضحة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وَتُشَكِّلُ العدالة الإلهية كأصل من أصول الدين الإسلامي الذي صّحح الممارسات الجائرة التي كانت سائدة في بعض المجتمعات قبل الإسلام، حيث كانت النساء والأطفال الصغار غالباً ما يُحرمون من الميراث. فجاء القرآن الكريم وحدد نصيب كل وارث ووارثة بدقة متناهية، ولم يوكل ذلك لأحد، مؤكداً على حق المرأة في الميراث في مختلف درجات القرابة (ابنة، ابنة ابن، زوجة، أم، جدة، أخت).
ميراث المرأة في النوازل الفقهية
وحينما نعرج على كتب النوازل الفقهية وندقق فيها نجدها مرآة لتطبيق حقوق الميراث، مؤكدة على مبدأ حق المرأة في الميراث وفق ما جاء به الشرع. ومفصلة لقضايا متنوعة تتعلق بالميراث، مثل قضايا الإرث بين الأزواج: حيث كانت الزوجة ترث ربع تركة زوجها إن لم يكن للزوج ولد، وثمنها إن كان له ولد. وقد عالجت كتب النوازل الفقهية تفاصيل هذه الحالات كوجود الموانع الشرعية للإرث. وتطرقت إلى إرث البنات والأخوات، وأشارت إلى تطبيق النص القرآني الذي يعطي البنت الواحدة النصف، وللبنتين فما فوق الثلثين، وللأخوات نصيبهن االثلثين كذلك، أو التعصيب في حالة وجودهن مع بنات الهالك. وبينت تفاصيل قضايا مثل وجود العصبة وتأثيرهم على نصيب البنات. كما لم تغفل القضايا التي تتعلق بالوصايا والهبات، حيث كانت المرأة تتمتع بحق الوصية والهبة والتصرف الحرِّ في ملكيتها الخاصة، بما في ذلك ما ورثته، شأنها في ذلك شأن الرجل. وأظهرت هذه الكتب قضايا تتعلق بالنزاعات حول صحة الوصايا أو الهبات. كما أشارت إلى التصرف في الأملاك الموروثة، وأن المرأة كان لها دائما الحق الكامل في التصرف في أملاكها الموروثة بالبيع والشراء والإجارة، دون الحاجة لإذن ولي أمرها، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية مثل الحجر. أما الانتهاكات المزعومة في المواريث فلا شك أنها خطأ في التطبيق لا في التشريع. فعلى الرغم من وضوح النصوص الشرعية والحرص الفقهي في النوازل على تطبيقها، ظهر في بعض السياقات التاريخية أو الجزئيات الفردية أن المرأة تعرضت لانتهاكات لحقوقها في الميراث. ولم تكن هذه الانتهاكات أبداً نتيجة لقصور في التشريع الإسلامي نفسه، الذي كرم المرأة وأعطاها حقوقاً لم تكن تتمتع بها في كثير من الحضارات الأخرى. بل كانت نتاجاً لعوامل متعددة مثل الجهل بالشريعة الإسلامية: فقد يكون بعض الأفراد في المجتمع، وحتى بعض القضاة أو المتفقهة غير المتخصصين، يجهلون التفاصيل الدقيقة لأحكام الميراث، مما يؤدي إلى أحكام مجانبة للصواب تضيع بسببها الحقوق. وكذا الأعراف والتقاليد القبلية، فنحن نعلم أن في بعض المناطق خاصة القروية ، أوالأسر، عادات وتقاليد تحرم المرأة من الميراث أو تُقَلِّلُ من نصيبها منه ، وقد استمرت هذه في الممارسات، وتم فرضها بقوة العرف الاجتماعي بدلاً من قوة الشرع. كما أن ضعف الحماية القضائية في بعض الحالات، قد لا يُمَكِّنُ المرأة من الوصول إلى القضاء بسهولة لإنصافها في هذا المجال، أو قد تواجه ضغوطاً اجتماعية للتنازل عن حقوقها، خاصة في غياب الوعي الكافي أو الدعم الاجتماعي. ناهيك عن التأويلات الخاطئة والتي تحكمها المصالح الخاصة، فقد تُلجِؤُ البعض إلى تأويلات مخطئة للنصوص الشرعية، أو تُستخدم بعض الاستثناءات الفقهية في غير موضعها لتبرير حرمان المرأة من حقوقها، مدفوعين بمصالح شخصية أو عائلية أو مادية.
لكن كتب النوازل الفقهية، التي كانت مرجعاً للقضاء النوازلي، كانت تسعى جاهدة لتصحيح هذه الممارسات المنحرفة والجائرة ، فالفقهاء والقضاة المعتبرون كانوا يُشدِّدون على ضرورة تطبيق أحكام الميراث بحذافيرها، وكانت الفتاوى تَرُدُّ على الاستفسارات لبيان هذه الحقوق وتأكيدها. وهذا يثبت أن جوهر الدين ومقاصده كانا دائماً في صف عدالة المرأة، وأن أي تحريف إنما هو انحراف عن هذا الجوهر.
ووتأسيسا على ما سبق ذكرُهُ، فإن كتب النوازل الفقهية تُظهر بوضوح أن الشريعة الإسلامية منحت المرأة حقوقاً إرثية واضحة ومكفولة، وإن ظهرت أحياناً صراعات على الحقوق أو محاولات للتجاوز، فإن هذه المؤلفات الفقهية في مجملها كانت تهدف إلى ترسيخ وتطبيق هذه الحقوق، مما يؤكد أن أي انتهاكات كانت تحدث على أرض الواقع لم تكن نابعة من الدين نفسه، بل كانت نتيجة لقصور في الفهم، أو تأثير لأعراف مخالفة للشرع، أو ضعف في التطبيق القضائي. فالدين الإسلامي براء من هذه التجاوزات، وقد جاء ليحرر المرأة ويمنحها حقوقاً واجبة في مجتمع كان يهمشها.
نظام التعصيب.. نماذج تطبيقية
ولمزيد توضيح كيفية حماية حقوق المرأة في الميراث ضمن التعصيب الذي وقع حوله النقاش في أيامنا هذه، سأقدم بعض النماذج التطبيقية.
التعصيب هو إحدى طرق الميراث في الإسلام، حيث يرث العصبة وهم كلُّ ذكر ينتسب إلى الميت بذكر أو أنثى، أو أنثى تنتسب إلى الميت بذكر فقط، أو كل من يرث الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم المحددة شرعاً، أو يرثون التركة كلها إذا لم يكن هناك أصحاب فروض. فالفهم الشائع للتعصيب أحياناً يركز على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، وهذا صحيح في حالات محددة مثل الأولاد من نفس الدرجة، لكنه لا يعني حرمان المرأة أو ظلمها في جميع الحالات. بل إن التعصيب في كثير من الأحيان يحمي حقوق المرأة ويضمن لها نصيباً في التركة لم تكن لتأخذه بغيره. وهذا مما يؤكد العدالة الإلهية، فنظام الميراث في الإسلام نظام مفصل ودقيق وضعته الشريعة الإسلامية بنصوص قطعية وواضحة في القرآن الكريم والسنة النبوية كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
- المثال الأول: الأخت مع الأخ أو الابن مع البنت أو ابن الابن مع البنت أو بنت الابن، هذا هو المثال الأشهر الذي تُطبق فيه قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، ولكنه يوضح في نفس الوقت كيف أن البنت ترث نصيباً كاملاً ومُهِمّاً.
-
- الحالة الأولى: توفي شخص وترك: بنتا واحدة وأخا شقيقا. البنت تأخذ نصيبها باعتبارها صاحبة فرض: النصف من التركة. والباقي من التركة النصف يذهب للأخ الشقيق بالتعصيب. ونلاحظ هنا أن البنت أخذت النصف فريضه، والأخ أخذ الباقي تعصيبا فالأنصبة واضحة ومحددة.
- الحالة الثانية: للتعصيب المباشر بين الأولاد، توفي شخص وترك: بنتا واحدة وابنا واحدا. في هذه الحالة، لا يوجد أصحاب فروض آخرون. الأبناء يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قُسمت التركة إلى ثلاثة أسهم، تأخذ البنت سهما واحدا (1/3) ويأخذ الابن سهمين (2/3).
إذن فحماية حق المرأة هنا حتى وإن كان نصيب الابن ضِعْفَ نصيب البنت، فالشريعة راعت أن الابن هو المكلف بالنفقة على نفسه وعلى زوجته وأولاده وأحياناً على والديه وأخواته في حال الحاجة، بينما البنت ليست مكلفة بالنفقة على أحد، فيبقى لها نصيبها ملكاً خالصاً تتصرف فيه بحرية.
- المثال الثاني: البنت مع ابن الابن الذي هو من درجة أدنى، في هذا المثال يبرز كيف أن التعصيب يحمي حقوق المرأة، حتى لو كان الوارث الذكر بعيداً نسبيا.
-
- الحالة الأولى: توفي شخص وترك بنتا واحدة وابن ابن أي حفيده. فالبنت تأخذ نصيبها “النصف” فريضة، والباقي من التركة «النصف الأخر”، يذهب لابن الابن تعصيبا. هنا حماية حق المرأة واضحة فلو لم يكن هناك ابن الابن، لكانت البنت قد أخذت نصف التركة فقط، وربما ذهب الباقي لورثة أبعد. فوجود ابن الابن كعاصب أقرب لا يحرم البنت من نصيبها النصف، بل يضمن أن الباقي يبقى في نطاق القريب الأدنى. ولا يدخل الغريب أو البعيد بين الورثة.
- المثال الثالث: وجود أكثر من بنت مع عاصب: ابن ابن، أو أخ، أو عم، وهذا يوضح التعصيب باعتباره حماية لتوزيع الباقي بشكل عادل.
-
- الحالة الأولى: توفي رجل وترك: بنتين أو أكثر وعم شقيق. فالبنات اثنتان أو أكثر يأخذن نصيبهن فريضة: الثلثين من التركة (2/3) والباقي من التركة وهو الثلث (1/3)، يذهب للعم الشقيق بالتعصيب. وهنا أيضا تظهر حماية حق المرأة: فالبنات أخذن الجزء الأكبر من التركة الثلثين. والتعصيب يضمن أن الثلث المتبقي يذهب إلى عاصب قريب بدلاً من ضياعه أو ذهابه لبيت مال المسلمين في بعض الحالات.
- المثال الرابع: الزوجة مع العصبة (الأبناء أو الإخوة)
-
- الحالة الأولى: توفي رجل وترك: زوجة وابنا وبنتا. الزوجة تأخذ نصيبها فرضا: الثمن (1/8) لوجود الفرع الوارث (الأبناء). الباقي من التركة (7/8) يذهب للابن والبنت بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك حماية حق المرأة سواء كانت زوجة أو بنات، الزوجة هنا أخذت نصيبها الشرعي كاملاً ومحدداً. والأبناء والبنات تقاسموا الباقي. كل من الزوجة والبنت نالتا حقوقهما المحددة شرعاً.
- المثال الخامس: البنات مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب، اَلْأَخَ لِلْأَبِ كَمَا يَسْقُطُ فِي اَلْحِمَارِيَّة كَذَلِكَ يَسْقُطُ لوجود الإخوة الأشقاء ، فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ ، وَهِيَ مَا إِذَا تَرَكَ اَلْهَالِكُ بِنْتَاً وَأُخْتاً شَقِيقَةً وَأَخَا لِأَبٍ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ رغم أنه ذكر ، لِأَنَّ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفَ بِالْفَرْضِ وَلِلشَّقِيقَةِ اَلنِّصْفَ اَلْبَاقِي، وَهُوَ قَدْرُ سَهْمِهَا اَلَّذِي يُفْرَضُ لَهَا إِذَا اِنْفَرَدَتْ، وَيَسْقُطُ اَلْأَخُ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ له شَيْءٌ مِنْ اَلْمَالِ .
فهذه النماذج التطبيقية في التعصيب تُظهر أن حقوق إرث المرأة في الإسلام مصونة، وأن التعصيب كآلية توزيع يُكَمِّلُ منظومة الإرث بما يضمن وصول المال إلى أقرب المستحقين، دون هضم لحقوق أصحاب الفروض ومنهم النساء. كما أن نصيب المرأة ثابت في أغلب الأحوال، (مثل البنت المنفردة، الزوجة، الأم، الجدة) لا يتأثر بالتعصيب، بل تأخذ نصيبها كاملاً أولاً. والتعصيب يكمل المنظومة ويضمن أن الباقي من التركة مكفول بعد أخذ أصحاب الفروض لحقوقهم، لا يذهب بعيداً، بل يورث لأقرب العصبة، الذين قد يكونون هم أنفسهم بنات وأخوات في حالات أخرى كما في التعصيب بالغير أو مع الغير. ثم إن مبدأ “للذكر مثل حظ الأنثيين” هو مبدأ تكاملي مرتبط بالتكافل الاجتماعي، حيث إن الأعباء المالية والتكاليف الشرعية تقع على الرجل بشكل أكبر في المنظومة الإسلامية. وقد تتفوق المرأة أحيانا على الرجل في الارث كما ذكر في المسألة الحمارية “الأخ للأب مع وجود الأخت الشقيقة” فإنه يسقط وتأخذ حقها لأنه لم يبق له شيء من التركة.
وهذا ما حرصت عليه كتب الفقه الإسلامي عموما وكتب النوازل الفقهية على وجه التخصيص فقد كانت تطبيقاً لهذه المبادئ، حيث دأب القضاة والمفتون على التأكيد على تطبيق الأنصبة الشرعية الواضحة للنساء في التعصيب وغيره، وكان أي تحريف أو تجاوز يعتبر خروجاً عن روح الشريعة الإسلامية وغاياتها العادلة.
ميراث المرأة في مؤلفات أبي عبد الله الكيكي
يعتبر كتاب: “إتحاف الحذاق وقرة عين المشتاق في شرح فرائض خليل ابن إسحاق” للإمام أبي عبد الله الكيكي المتوفى عام 1185 هـ الذي نحن بصدد تحقيقه، وكتابه “مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السَّائبة والجبال” بتحقيق الدكتور أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، يندرجان ضمن الكتب التي تتناول ما أشرنا إليه سابقًا، أي حقوق المرأة في الميراث في الغرب الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري. وأبو عبد الله الكيكي باعتباره فقيهًا مالكيًا مغربيًا مشهورًا في عصره، والنوازل من صميم اهتمامه، كان يفتي في القضايا الواقعية التي تعرض على الناس من كتبه المعروفة السابقة الذكر، وكان رحمه الله من المنافحين عن حقوق المرأة في زمانه، خاصة في كتابه “مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال” فكان عمله أكثر قيمة وملاءمة ودفاعا عما يسمى الآن “مقاربة النوع ” من وجهة نظر إسلامية من خلال كتبه ، مع التركيز على حقوق المرأة في الميراث”. ومن خصائص كتب العلامة الكيكي نذكر ما يلي:
- المصداقية والقيمة البحثية: التي تضفي وزناً خاصاً على فتاواه في هذا الشأن. فبدلاً من مجرد استعراضه للأحكام الفقهية، يمكن ملاحظة كيفية دفاعه عن هذه الحقوق في مواجهته للأعراف السيئة والمماراسات السلبية التي كانت منشرة في زمانه وخاصة في الجبال.
- دحضه للانتهاكات مما يبين بأن أي اعتداء على حقوق المرأة لم يكن جوهراً في الدين، بل كانت هناك أصوات فقهية قوية مثل الكيكي تدافع عن هذه الحقوق وتصحح المسار.
- غنى المادة البحثية: ففي مؤلفاته ” كمواهب ذي الجلال” أو غيره من كتبه نجد أمثلة تطبيقية ونوازل تظهر قضايا النزاع حول حقوق المرأة في الميراث، وكيف تَدَخَّلَ الكيكي باعتباره فقيها نوازليا لتأكيد هذه الحقوق للمرأة ودفع الظلم عنها. وهذا كلُّه قدَّم رؤية عملية حول كيفية التعامل مع هذه القضايا في القرن الثاني عشر الهجري.
- توازنه العلمي: فوجود فقهاء مثل الكيكي يمنح صورة أكثر توازناً للوضع الفقهي والقضائي، الذي يُظهر أن هناك دائماً من الفقهاء من كان واعياً بحقوق المرأة ومدافعاً عنها، حتى في الأوقات التي قد تكون فيها الأعراف الاجتماعية السلبية سائدة.
المراجع
[1] إتحاف الحذاق وقرة عين المشتاق في شرح فرائض خليل ابن إسحاق(مخطوط).[2] إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة"، للعلامة أحمد بن سليمان الرسموكي، تقديم الفقيه إد إبراهيم إبراهيم التامري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط1، سنة 2004.
[3] التاج والإكليل للمواق، دار الكتب العلمية سنة 1994.
[4] التوضيح في مختصر ابن الحاجب، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، 1429هـ - 2008م.
[5] الدرة الجليلة في مناقب الخليفة" تحقيق الدكتور أحمد عمالك، منشورات وزارة الأوقاف سنة 2014.
[6] دليل مؤرِّخ المغرب الأقصى تأليف عبد السَّلام بن عبد القادر لابن سودة المرِّي، منشورات دار الفكر، ط1، 1997.
[7] الذخيرة للقرافي (ت: 684هـ)، حقق جزء 1، 8، 13 محمد حجي، وجزء 2، 6: سعيد أعراب، وجزء 3 - 5، 7، 9 - 12 محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي- بيروت الطبعة: الأولى، 1994م.
[8] شجرة النُّور الزكية في طبقات المالكيَّة، تأليف محمَّد بن محمَّد بن مخلوف، القاهرة، المطبعة السَّلفية ومكتبتها، 1349.
[9] شرح الزرقاني على مختصر خليل"، باب الفرائض، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ - 2002 م، 8/362.
[10] الفتاوى الفقهية في أهم قضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية، دراسة وتحليل الأستاذ الحسن اليوبي، منشورات وزارة الأوقاف، سنة 1998.
[11] الفكر السامي، اعتنى به هيثم خليفة طعيمي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط1، سنة 2006.
[12] فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للشيخ عبد الحي الكتَّاني، اعتناء الدُّكتور إحسان عبَّاس، دار الغرب الإسلامي، بيروت. ط الثانية، 1982.
[13] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للنفراوي (ت: 1126هـ)، دار الفكر، سنة 1415هـ - 1995م.
[14] القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي"، تحقيق ماجد الحموي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1434هـ.
[15] المختصر الفقهي لابن عرفة، تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة الأولى، 1435 هـ - 2014 م.
[16] المدونة، كتاب المواريث، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م.
[17] مسائل أبي الوليد ابن رشد، تحقيق: محمد الحبيب التجكاني، دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب، الطبعة 2، 1414 هـ - 1993.
[18] المصادر العربية لتاريخ المغرب للعلاَّمة محمَّد المنوني، منشورات كلية الآداب بالرباط، سنة 1983.
[19] المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية ودار الغرب الإسلامي – بيروت، 1401 هـ.
[20] المقدمات الممهدات لابن رشد الجد، تحقيق الدكتور محمد حجي الناشر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1408 هـ - 1988 م، م 3/148.
[21] مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها للرجراجي، اعتنب به أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، ط1، سنة 2007.
[22] الموافقات للشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.
[23] مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السَّائبة والجبال للكيكي: تحقيق ذ. أحمد التَّوفيق، دار الغرب الإسلامي، سنة .1997.