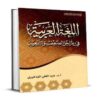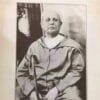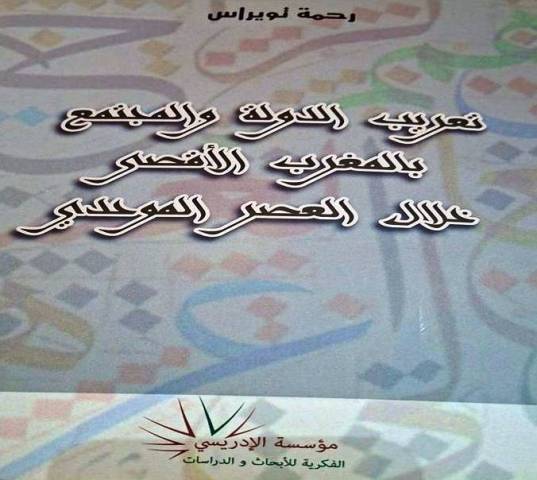
المحتويات
توطئة
شهد العصر الموحدي بالمغرب الأقصى عملية تعريب واسعة في الدولة والمجتمع، مدفوعة بالاهتمام السياسي والثقافي، حيث ساهمت سياسات الخلفاء الموحدين في ترسيخ اللغة العربية كلغة للإدارة والثقافة والتعليم، وذلك عبر تشجيع الرحلات العلمية وتكوين العلماء ونشر اللغة في الدواوين والمساجد والمدارس، مما أدى إلى اندماج المجتمع في الثقافة العربية الإسلامية واتساع نطاقها على حساب اللغة الأمازيغية في النطاق الرسمي والحضري. ومن أهم عوامل التعريب وأدواته العامل الديني، السياسة الموحدية التي اعتمدت تخصيص العربية في الإدارة، الرعاية العلمية، نشر التعليم، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية، والاستقرار السياسي، وتوافد الأندلسيين. وفي هذا المضمار يأتي كتاب “تعريب الدولة والمجتمع بالمغرب خلال العصر الموحدي” للأستاذة رحمة تويراس، والصادر عن مؤسسة الإدريسي الفكرية للأبحاث والدراسات، الطبعة الأولى لسنة 2015م، ويقع في 319 صفحة.
جاء الكتاب ليرصد سيرورة تمكن اللغة العربية من المغرب الأقصى خلال العصر الموحدي، نظرا لما يمثله موضوع التعريب من أهمية تاريخية لارتباطه بالهوية المغربية، وكان لابد من وصل حلقاته بتتبع مساره التاريخي، وكشف العوامل المؤثرة، واستقراء المكونات الأساسية دون إغفال الجزئيات التي ساهمت في تقرير المصير اللغوي للمنطقة.
مضامين الكتاب
اهتم العديد من الباحثين بتاريخ المغرب في مختلف مراحله التاريخية، لغناه وتعدد القضايا التي شكلت نسيجه المجتمعي، وتعاقب الدول عليه وبروز النبوغ المغربي في حقب تاريخية، ولمكانته بين الأمم وموقعه الجغرافي، وتلاقح الثقافات وتنوعه وغناه. وإن من أهم القضايا التي استأثرت باهتمام الدارسين الوقوف على سيرورة تمكن اللغة العربية من المجتمع المغربي خلال العصر الموحدي الذي احتضن عوامل عديدة ساهمت في تقرير المصير اللغوي للمنطقة.
وقد استرعى التحول اللغوي خلال العصر الوسيط اهتمام الدارسين، وأثار لديهم عددا غير قليل من الأسئلة. وكما هو معروف أثرت الفتوحات الإسلامية في كل الشعوب التي حلت بينها وبدأت اللغة العربية تخترق بيئات جديدة ذات حضارات عريقة في كل من آسيا، وإفريقيا، وشبه الجزيرة الإيبيرية واحتكت أثناءها بعدد من اللغات مثل الآرامية السريانية واللاتينية بالشام والفارسية ببلاد فارس، والقبطية بمصر، والأمازيغية واللاتينية بشمال إفريقيا، والقوطية بإسبانيا، إلى غير ذلك من اللغات في أقطار مختلفة كالهند وغيرها. وكان تأثير اللغة العربية في هذه اللغات متفاوتا من منطقة إلى أخرى. (مقدمة الكتاب، ص: 5)
أهمية الموضوع:
تبدأ أهم خطوات البحث عند رحمة تويراس باختيار الموضوع، وهناك مجموعة من العوامل تتحكم في دراسة موضوع دون أخر، وهنا طرحت مجموعة من الأسئلة المرتبطة بمبررات الاختيار ومن أهمها لماذا موضوع تعريب الدولة والمجتمع خلال العصر الموحدي؟.
فلما اعتنق الأمازيغ الإسلام بدأت اللغة العربية تشق طريقها تدريجيا في المجتمع الأمازيغي، وهناك ملاحظة أولية تفرض نفسها هي أن التعريب لم يكن ملازما للإسلام. ورغم الارتباط الوثيق بين الإسلام والعربية، فإنهما لم يسيرا بشكل متواز، إذ أصبح جزء كبير من المغرب مسلما في أقل من قرنين من الزمن في وقت لم تستقر فيه اللغة العربية بعد. وتدريجيا برزت كفاعل أساسى في مسار تاريخ المغرب واجتمع لها من عوامل القوة، وتهيأ لها من الأسباب ما جعلها لغة الإدارة والتعليم والآداب ولغة التخاطب اليومي، ساعدها في ذلك سلطتها المعنوية كلغة يجب أن تؤدى بها كثير من العبادات الإسلامية، فهي لغة القرآن ومفتاحه. غير أن القضية لم تتصل فقط بالشعور الديني، إذ إلى جانب الموقف العاطفي توجد عوامل أخرى داخلية وخارجية مهدت للتعريب. (مقدمة الكتاب، ص: 6)
ولعل أهم ما يبرز أهمية الموضوع أن هناك مجموعات بشرية اعتنقت الإسلام مثل الفرس والأتراك والأفغان والأفارقة، لكنها حافظت على لغاتها ولهجاتها، وإن تأثرت بشكل أو بآخر باللغة العربية، بينما أصبح المغرب الأقصى يشكل جزءا مهما من المجتمع العربي الإسلامي. فهل كان مؤهلا أكثر من غيره ليصبح بلدا ناطقا باللغة العربية؟ وقد حاول البحث الوقوف على الظروف التاريخية التي جمعت بين اللغتين لمعرفة أسباب تراجع اللغة المحلية. (مقدمة الكتاب، ص: 7)
أهداف البحث:
حددت المؤلفة أهداف الدراسة كالآتي:
- الوقوف على العوامل التي أفسحت المجال للغة العربية، مع التمييز بين العوامل الجوهرية والعرضية.
- الوقوف على بعض المعالم والمحطات التي من شأنها إثراء المعرفة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التي كانت تتجاذب أقطار الشمال الإفريقي والأندلس، إذ لا يمكن تجاوز هذا العامل أو تغافله في فهم هذا التحول .
- كشف المؤثرات المختلفة والوسائل التي استخدمتها الدولة الموحدية للدفع بمشروع الانخراط في الثقافة العربية.
- رصد تهجير المجموعات العربية الهلالية التي أعطت للوجود العربي أهمية على مستوى تغيير الخريطة الديموغرافية والإثنية، لكنها شكلت أيضا الحلقة الكبرى في تعريب البوادي. (مقدمة الكتاب، ص: 9)
إشكاليات البحث:
العنصر البشري لبنة أساسية من لبنات التعريب، حيث عرف المغرب تغييرا في تركيبته الديموغرافية بسبب الهجرات التي تعاقبت عليه سواء من إفريقية أو الأندلس، ثم تعزز العنصر العربي بعد ذلك بالمجموعات الهلالية التي ساهمت في تعريب المجال. وتعاقب هذه الهجرات من شأنه أن يوضح أسباب انكماش الأمازيغية وتقلص رفعتها داخل المجتمع. وتساءلت هل هناك عوامل أخرى مهدت لهذا التحول غير الجانب البشرى؟ هل كان للشعور بوحدة الأصل دور محوري لصالح التعريب؟ وهل خلق هذا الاعتقاد نوعا من التأهيل الذاتي والاستعداد الوجداني لتقبل اللغة العربية؟. فمن المعروف أن العصر الموحدى شهد انخراطا كبيرا في الثقافة العربية التي صارت من مقومات الحضارة المغربية. فمن الذي تحكم في هذا الاختيار؟ وما هي العوامل التي كانت أساس هذا البناء الثقافى؟ وما هي الخطوات التي اتخذها الموحدون لتنمية الثقافة العربية؟. (مقدمة الكتاب، ص: 9\10)
أبواب وفصول الكتاب:
قسمت الباحثة بحثها بعد المقدمة إلى أربعة أبواب. تناول الباب الأول بالدراسة العوامل المساهمة في استقرار اللغة العربية من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر المرابطي، وقد تم إعداد هذا الباب كأرضية ممهدة للبحث، واشتمل على فصلين تناول الفصل الأول بالتحليل الكتل البشرية المكونة للمجتمع المغربي بدءا بالعناصر المستوطنة منذ القدم، ثم تعرض للعناصر العربية التي توافدت على المنطقة ابتداء من الفتح الإسلامي إلى حدود العصر المرابطي، وانصب الاهتمام في الفصل الثاني على إبراز الجوانب التي أعطت للمدن القدرة على استيعاب اللغة العربية مع تحديد الجهات التي كانت أكثر تأثرا.
وخصص الباب الثاني لدراسة عوامل أخرى مؤثرة، ساهمت في صناعة هذا الواقع التاريخي. فاهتم الفصل الثالث أساسا بدراسة دور المؤسسات الدينية والتعليمية في نشر اللغة العربية، أما الفصل الرابع، وهو المتعلق بمسألة الإلتحام في النسب العربي فقد تم الوقوف فيه على العوامل التي أسست الفكرة القرابة ضمن سلسلات النسب الطويلة والمتشعبة، مع إقامة علاقة افتراضية بين هذا الانتحال وتقبل اللغة العربية. ودرس الفصل الخامس انخراط الأمازيغ في الثقافة العربية مع توضيح الظروف والمؤثرات التي ساهمت في احتضانها .
وركز الباب الثالث على دراسة دور الدولة الموحدية في ترسيخ تعريب الإدارة وتطوير الثقافة العربية، ويحتوي على فصلين. يتضمن الفصل السادس دور الدولة الموحدية في إرساء دواليب وهياكل إدارية كانت السيادة فيها للغة العربية. واهتم الفصل السابع برصد حضور الدولة الموحدية في إثراء الحياة الثقافية في قالبها العربي.
أما الباب الرابع، فاختص بدراسة تعريب المجتمع الموحدي عبر رصد بنيته وتحديد العناصر السكانية المشكلة له في كل من المدينة والبادية، حيث جاءت الهجرة الأندلسية لتتجه تدريجيا بالمجتمع الحضري نحو التعريب، بينما أثر وصول القبائل الهلالية على البادية المغربية.
وفي الفصل الثامن تم التركيز على متابعة تهجير القبائل العربية، ورصد تحركاتها ومناطق نفوذها، مع توضيح الظروف التي ساهمت أيضا في تعريب المدن الموحدية. وتناول الفصل التاسع العامية المغربية خلال العصر الموحدي كثمرة تفاعل بين اللغة العربية والأمازيغية، وإن لم يصلنا منها سوى آثار قليلة وردت في ثنايا بعض المصادر التاريخية. أما الفصل العاشر، فكان النظر فيه مركزا على الأسماء الطوبونيمية، خاصة أن هذا الواقع التاريخي، قد سجلت بعض آثاره أسماء بعض المواقع.
وتضمنت الخاتمة بعض الخلاصات ونتائج الدراسة بصورة عامة.
خاتمة
لقد تبين من فصول البحث التي تم من خلالها وصل حلقات التعريب وتوضيح خطواته، أن هذا الواقع كان وليد تفاعل يومي وتاريخي، عرفه المجتمع المغربي على مراحل وحلقات وبكيفية تدريجية وبطيئة، تسير وفقا لقانون التطور الذي يخضع له عادة انتشار اللغات والعادات، وسائر المؤثرات الحضارية.
وبما أن قضية التعريب لا يمكن فصلها عن الجانب البشري والأحداث السياسية التي سيطرت على المغرب، فإنه تم الكشف عن مكونات المجتمع المغربي بإبراز مختلف مراحل تكوينه، بدءا بالعناصر الأصلية التي استوطنت المنطقة منذ القديم، ووصولا إلى الموجة العربية الهلالية التي تم استقدامها خلال العصر الموحدي الذي استكمل فيه المغرب مقومات الشخصية البشرية.
وخلال القرون اللاحقة ستصبح اللغة العربية سارية في شرايين المجتمع المغربي ملتحمة به إلى جانب اللغة الأمازيغية، على اعتبار أنهما إحدى العناصر الفاعلة لحفظ الهوية التي تشكلت ليس في المغرب الأقصى وحده، ولكن في كل أقطار الشمال الإفريقي. وهكذا حدد المغاربة اختياراتهم التي بلورت هويتهم. وفي عمق التاريخ المغربي نجد هذه الهوية الحضارية الأمازيغية العربية، وهي من الثوابت التي حسمت تاريخ المنطقة، وتبلورت معها هوية المغاربة، وحفظت للدولة المغربية أصالتها واستمراريتها، بل إنها ظلت تستمد منهما عناصر قوتها. (الكتاب، ص: 288/ 290)
لقد عمل الكتاب على تسليط الضوء على إسهامات الدولة الموحدية في تكريس سيادة اللغة العربية على المستوى الإداري والثقافي. أما المجتمع بحواضره وبواديه، فقد انفتح تدريجيا على اللغة العربية، انسجاما مع التحول الذي عرفته المنطقة على المستوى البشري. واستمرت اللغة العربية تمد جذورها لقرون عديدة في المجتمع المغربي إلى جانب اللغة الأمازيغية، ليشكلا معا مكونا أساسبا للهوية المغربية.