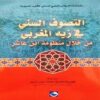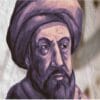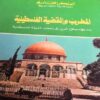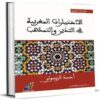المحتويات
مقدمة
تعد الزاوية الشرقاوية بمدينة أبي الجعد (بجعد) من أبرز الزوايا المغربية التي تركت أثرا عميقا في تاريخ المغرب الديني والاجتماعي، إذ أسسها الولي الصالح سيدي بوعبيد الشرقي في القرن السادس عشر الميلادي، فغدت منذ ذلك الحين مركزا للإشعاع الروحي والعلمي، استقطب العلماء والفقهاء والمريدين من مختلف الجهات. ولم يقتصر دورها على الجانب التعبدي، بل امتد ليشمل مجالات اجتماعية وسياسية واقتصادية، حيث شكلت فضاء للتكافل وحل النزاعات، وأداة لترسيخ الشرعية السياسية، كما ساهمت أنشطتها في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة. ومع مرور الزمن نشأ حولها عمران متدرج أفضى إلى قيام مدينة أبي الجعد، التي ما زالت تحتفظ إلى اليوم بخصوصيتها كحاضرة دينية وروحية ارتبط وجودها بالزاوية وأدوارها المتعددة.
الزاوية الشرقاوية.. النشأة والتأسيس
تشير المصادر التاريخية إلى أن مؤسس الزاوية الشرقاوية هو أبو عبد الله امحمد الشرقي بن قاسم الزعري بن عمر بن حمو العمري، وقد نشأ في أسرة عرفت بشغفها بالعلم والدين[1]، في زمن كان فيه النشاط الصوفي في أوجه. وفي منتصف القرن العاشر الهجري (1536م)، إبان حكم الدولة السعدية، أسس زاويته الأولى على بعد نحو 1500 متر من موقع الزاوية الحالي[2]، في مكان يعرف اليوم بـ “رجال الميعاد”. هناك نصب خيمته، وحفر بئرا، وشيد مسجدا، وكان الموضع آنذاك مكسوا بالغابات الكثيفة العامرة بالوحوش والذئاب، التي كانت تعرف محليا باسم “أبو الجعد”، ومنذ ذلك الحين غلب هذا الاسم على المكان.
ويعرف الموضع الذي نزل به الشيخ اليوم باسم “الآبار” قرب “رجال الميعاد”، أما البئر الذي حفره فلا يزال يعرف بـ “بئر الجامع”، وقد أقام هناك مدة قصيرة، قصده خلالها الزوار والمريدون وطلبة العلم، قبل أن ينتقل إلى موضع آخر يدعى “أربيعة”، وهو المكان المعروف حاليًا بـ “رحبة الزرع”، وهناك شيد مدرسة لتدريس العلوم في “المرح الكبير”، وهو درب من أقدم أحياء أبي الجعد، يقع بين درب القادريين ودرب الشيخ. وبفضل هذه المدرسة توافد الطلبة من مختلف الجهات، فأصبحت أبي الجعد مركز إشعاع ديني وعلمي، ونقطة تجارية بارزة في المنطقة.
ومع تأسيس الزاوية الشرقاوية خلال القرن السادس عشر الميلادي، انطلقت النواة الحقيقية لتشكل تجمعا بشريا وعمرانيا عرف بأبي الجعد. فقد أنشئت في البداية مدرسة بالمراح الكبير لتدريس العلوم الدينية، إضافة إلى مسجد وحمام وبعض الدور السكنية، وهو ما أسس أول حي في المدينة، كان يعرف بـ “القصر”. وسرعان ما توسعت هذه النواة الأولى، فانتشرت المساجد والأضرحة في مختلف الأرجاء، وكان كل ضريح يشكل بدوره نقطة جذب لتجمع بشري جديد.
وهكذا أخذ العمران في التوسع تدريجيا، لتغدو أبي الجعد مدينة زاوية بامتياز، استطاعت بفضل إشعاعها الديني أن تؤطر محيطها الجغرافي والبشري والاقتصادي، وتتحول إلى مجال مستقطب يدمج بين ما هو روحي وما هو عمراني.
الزاوية الشرقاوية بين التربية الروحية ونشر العلوم
لقد كانت مدينة أبي الجعد مقرا للزاوية الشرقاوية منذ تأسيسها في القرن السادس عشر إلى غاية إعلان الحماية سنة 1912م، حيث مثلت أحد أهم الأقطاب الدينية بالجهة الداخلية للمغرب، وأبرز المراكز الحضرية والدينية في سهل تادلة. وقد احتلت مكانة مرموقة بفضل إشعاعها، واستطاعت أن تؤسس فروعا لها خارج المدينة في المناطق والقبائل المجاورة، التي عبرت عن ولائها لشيوخ الزاوية. وبهذا حققت الزاوية امتدادا دينيا وروحيا واسعا، وخلفت شعبية مهمة في سهل تادلة خاصة، وفي المغرب عموما، فاستقطبت العديد من الأتباع الذين أسسوا بدورهم زوايا شرقاوية في مواطن استقرارهم.
وقد تمثلت هذه الامتدادات الروحية والدينية للزاوية في كثرة أتباعها من الشرقاويين والحمادشيين؛ حيث بلغ عدد الشرقاويون عند بداية الحماية حوالي 2605 شخصا، وتوزعوا في نواحي الدار البيضاء وفاس والجديدة والتخوم الشرقية.
أما الحمادشيون؛ فقد بلغ عددهم 3399 شخصا، حيث تأسس نظامهم في أواخر القرن الحادي عشر الهجري (17م) على يد سيدي علي بن حمدوش، أحد تلامذة الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد. وكان مقرهم الأصلي ببلدة زرهون قرب ضريح سيدي علي، ثم توزع أتباعهم في نواحي مكناس، وفاس، وآسفي، والجديدة، والدار البيضاء، ومراكش.[3]
وقد اضطلعت الزاوية الشرقاوية بدور محوري في نشر العلوم الشرعية واللغوية، فكانت فضاء للتعليم والتكوين، إذ تخرج من حلقاتها عدد من العلماء البارزين الذين تركوا بصمتهم في الفكر المغربي. ومن هؤلاء العلماء: أبو علي الرحالي، والشيخ سيدي صالح دفين أبي الجعد، والشيخ سيدي المعطي صاحب “الذخيرة”،[4] والفقيه القاضي المهدي مرينو الرباطي الأندلسي،[5] والحسين بن محمد الهداجي المعدني،[6] ومحمد بن عبد الكريم العبدوني صاحب مؤلف “يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ المعطى”، اللذان يعتبران مفخرة الزاوية باعتبارهما من خيرة ما أنجبت حلقات الدراسة بها، بالإضافة إلى محمد بن أبي قاسم بن محمد بنعبد الجليل السجلماسي المعروف بالرباطي.[7]
وقد حظيت الزاوية الشرقاوية بزيارة كبار العلماء والفقهاء، وهو ما يعكس مكانتها العلمية في المغرب. ففي يوم 24 من ذي القعدة 1211هـ الموافق لـ 22 ماي 1797م، خرج من فاس وفد علمي رفيع ضمّ الفقيه سيدي عبد القادر بن شقرون، والحاج محمد بنيس، والطيب ابن كيران، وعددًا من كبار علماء وأعيان فاس، كما شارك فيه مولاي إبراهيم ابن السلطان، وولد سيدي العربي مع عمه عبد السلام بن المعطي. وعند وصول الوفد إلى رباط الفتح (الرباط حاليا)، قام السلطان المولى سليمان بنفسه بتوديع العلماء وتشريفهم، ووجه ابنه مولاي إبراهيم لمرافقتهم إلى أبي الجعد والإقامة فيها للانكباب على دراسة العلم. وعندما وصل الوفد إلى أبي الجعد استقبلهم سيدي العربي استقبالا حافلا يليق بمقامهم، وأكرم وفادتهم، وانقاد لهم تقديرا لمكانتهم العلمية.[8]
كما أصبحت زاوية أبي الجعد الشرقاوية محج القبائل المجاورة التي كانت تأتي بتبرعات وهدايا كثيرة، كانت تصرف على طلبة العلم من قبل الشيخ سيدي امحمد الشرقي، الذي وافاه الأجل المحتوم سنة 1010هـ، عن سن يناهز 84 سنة، وقد خلف إحدى عشر ولدا و هم؛ سيدي عبد القادر، و سيدي أحمد المرسي، و سيدي المالقي، و سيدي محمد الدقاق، و سيدي عبد السلام، و سيدي الغزواني، و سيدي المكناسي، وسيدي الطنجي، و سيدي الحارثي، و سيدي التونسي، ولالة أميرة، وكلهم مدفونون بأبي الجعد، ومراقدهم معروفة عند أهل المدينة.
وقد ورد في مؤلفات كثيرة من تلك التي ترجمت للشيخ أبي عبيد الشرقي، وكذلك ما تتداوله بعض الروايات الشفوية؛ أن الزاوية الشرقاوية حظيت بعناية ورعاية خاصة من لدن السلاطين. فقد نزل بها السلطان المولى إسماعيل، فأمر بترميم ضريح الولي الصالح سيدي امحمد الشرقي، وبنى بجانبه مسجدا وحماما لا يزالان قائمين إلى اليوم. كما واصل أبناء وأحفاد الشيخ نهجه الصوفي، ومن أبرزهم سيدي صالح بن سيدي المعطي الذي درس العلم بفاس وبالزاوية الناصرية بتامكروت، ثم ابنه سيدي محمد المعطي صاحب الكتاب الشهير “ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج”. وبعد وفاته تولى خلفه ابنه سيدي العربي دفين أبي الجعد، وفي عهده شُيد المسجد المعروف باسمه بأمر من السلطان مولاي سليمان. كما أمر السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام بصنع قبة لـ سيدي بنداوود بن العربي الشرقاوي. وقد زار الزاوية أيضا السلطان مولاي الحسن الأول، وأقام بها عدة أيام، جدد خلالها بناء ضريح سيدي صالح والمسجد الملاصق له.[9]
وفي هذا السياق يقول المؤرخ الناصري: “هذه الزاوية من أشهر زوايا المغرب، ولها الفضل الذي يفصح عنه لسان الكون ويعرب، تداولها منذ أزمان فحول أكابر، وتوارثوا مقام الولاية والرياسة بها كابرا عن كابر. قد عرف لهم ذلك السوقة والملوك، والغني والصعلوك، ولم تزل الملوك من هذه الدولة وغيرها تعاملهم بالإجلال والإعظام والتوقير والاحترام.”[10]
الدور الاجتماعي والسياسي للزاوية الشرقاوية
لقد أدت زاوية أبي الجعد دورا محوريا في تأطير الحياة الاجتماعية، سواء داخل مجتمعها الداخلي أو في صفوف القبائل المجاورة لها، إذ شكلت مركزا لانتظام المجتمع القبلي بفضل ما وفرته من شروط الأمن والاستقرار انطلاقا من سلطتها الدينية والروحية. وقد تحولت الزاوية، بما اضطلعت به من مهام، إلى فضاء للتكافل والتضامن، ساهم في تقوية أواصر النسيج القبلي الهش وتماسكه.[11] وقد قيل أنها نسجت علاقات اقتصادية حقيقية مع محيطها، برزت خلال فترات الأزمات، خاصة أزمنة المجاعات والجفاف والأوبئة، حيث تكفلت بتقديم المساعدات لمجالها القبلي في صور متعددة، مثل الإطعام والإيواء والعلاج وأداء الديون عن المعوزين.
وقد أظهرت أحداث المغرب السياسية في أواخر القرن التاسع الهجري وبداية القرن العاشر الأهمية البالغة للزوايا ورجال الصلاح، باعتبارهم قوة دينية لا تجارى في مجال تعبئة الأمة لمواجهة الأخطار الأجنبية، أو في الإسهام في تحديد ملامح البنية السياسية للبلاد.[12]
وتبرز أهمية زاوية أبي الجعد بوصفها نسقا سياسيا متميزا، حيث إن شيوخها أدركوا بوعي شروط وحدود تحركهم، فلم يستندوا إلى عصبية قبلية قوية، ولا إلى موقع جغرافي حصين، وإنما استمدوا مكانتهم من قدرتهم على لحمة النسيج القبلي وربطه ربطا مصلحيا بالكيان العام للمخزن المغربي. وهكذا غدت الزاوية فاصلا معنويا، ورابطا ماديا يؤدي أدوارا متكاملة في خدمة الاستقرار السياسي والاجتماعي.[13]
وبفضل هذا النفوذ المتنامي للزاوية الشرقاوية، أسند إليها المخزن أدوارا جديدة، من بينها: اقتراح أسماء القواد المرشحين لتولي السلطة على القبائل المجاورة، والإشراف على جمع الضرائب والزكوات من بعض المناطق البعيدة نسبيا عن سهل تادلة مثل قلعة السراغنة والحوز، فضلا عن التدخل لتهدئة الثورات المناوئة للمخزن والإسهام في إخضاعها.
الاشعاع الاقتصادي للزاوية الشرقاوية
لقد أكدت معظم الدراسات السوسيولوجية صعوبة تحديد حجم مداخيل الزوايا ومواردها المالية بدقة، غير أن الزيارات ظلت تمثل المورد الاقتصادي الثابت لها في المغرب. وفي حالة زاوية أبي الجعد؛ فقد جمعت هذه الزيارات بين طابع ديني يتمثل في توافد المريدين والتابعين لزيارة شيوخ الزاوية وأضرحتها، وطابع مادي يتجلى في ما كانت تتلقاه من هبات وعطايا متنوعة من نقود وحبوب ومواش، وهو ما وفر لها دخلا قارا وأرباحا مهمة ساعدت على استمراريتها ونشاطها.
وإلى جانب ذلك، استفادت الزاوية من موقعها الجغرافي المتميز قرب الطريق الرئيسة الرابطة بين فاس ومراكش، مما جعلها محطة أساسية لعبور القوافل التجارية، بفضل ما وفرته من شروط الأمن وتبادل المصالح. كما برز دورها الاقتصادي بشكل أوضح على محور الطريق الرابط بين خنيفرة والدار البيضاء، ولا سيما في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، حيث ارتبطت أنشطتها بما كان يعرف بـ “الزطاطة”، أي تأمين الطرق وحماية القوافل، وهو ما عزز مكانتها كفاعل اقتصادي محوري في المنطقة.
من نواة روحية إلى رافعة عمرانية
منذ تأسيسها إلى غاية القرن السابع عشر، مرت الزاوية الشرقاوية بمراحل تطور متتابعة. فقد نشأت الزاوية الأولى في مطلع القرن السادس عشر الميلادي (1536م) في عهد السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي، حيث ضمت مسجدا ومجموعة من الدور السكنية، واعتمد سكانها على نظام الخطارات لجلب المياه.
ومع بداية القرن السابع عشر شهدت تفشي وباء الطاعون، ما أدى إلى انتقال الزاوية إلى موضعها الحالي الذي يبعد بنحو كيلومتر ونصف عن موقعها القديم، حيث ما زالت قبور بعض أبناء الشيخ كـ سيدي الغزالي، وسيدي عبد السلام، وسيدي الحارثي، وسيدي المكناسي شاهدة هناك.
وبالاعتماد على شجرة النسب الشرقاوية والوقائع التاريخية، يمكن تلخيص تطور الزاوية/المدينة على النحو التالي:
- فترة محمد الشرقي: نشأت خلالها النواة الأولى لمدينة أبي الجعد، بإنشاء مدرسة بالمراح الكبير لتدريس العلوم الدينية، إلى جانب مسجد وحمام ودور سكنية، فظهر أول حي بالمدينة، وكان يُعرف بـ “القصر” (درب الشيخ).
- بداية القرن 17م إلى منتصفه: تشكلت ثلاثة أحياء إضافية ضمت تجمعات سكنية ومساجد صغيرة، وهي:درب لغزاونة، ودرب القادريين، ودرب السلاميين، وقد ربطتها علاقات وثيقة بالشيخ محمد الغزالي.[14]
- أما خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين؛ فقد شهدت مدينة أبي الجعد توسعا مجاليا ملحوظا. ففي القرن الثامن عشر تكونت عدة أحياء ودروب جديدة، من أبرزها درب عرباوة الذي احتضن مقر الزاوية، ودرب العلاليين. أما في القرن التاسع عشر؛ فقد عرفت المدينة ازدهارا عمرانيا أكبر بظهور مجموعة من الأحياء، من بينها: درب الزاوية الذي شكل مقرا لزاوية أبي الجعد، ودرب سيدي بن داوود، ودرب القادريين، ودرب السعديين، ودرب بني مسكين، ودرب الحاج حيمر، ودرب آيت ستور، ودرب سيدي الحفيان، ودرب حميد، ودرب زلغي، ودرب لغراري، ودرب لقصيرة، ودرب قلالة، ودرب عيشاء حدو، ودرب خريبكة.
إن التنظيم المجالي للمدينة القديمة بأبي الجعد، لا يختلف في خطوطه العريضة عن النمط العام الذي ميز المدن المغربية التقليدية مثل فاس ومكناس. غير أن ما يميزها هو غياب السور الخارجي الذي عادة ما يفصل المجال الحضري عن المجال القروي، باعتباره عنصرا أساسيا في نظام الدفاع عن المدن. ويظهر غياب السور في أبي الجعد أنها لم تكن على علاقة نزاعية مع محيطها الجهوي، وأنها عاشت في إطار من السلم النسبي مع القبائل المجاورة. وقد عُوض هذا الغياب بوجود أقواس كبرى عند مداخل الدروب، كانت تغلق بأبواب خشبية ضخمة، لتأمين الدور من بعض الغارات المحدودة التي كان يشنها أحيانا بعض السياب. وهكذا شكلت هذه الأقواس وسيلة حماية داخلية تفصل بين الأحياء السكنية (الدروب) وتمنحها قدرا من الاستقلالية والأمن.[15]
ويستمد التنظيم العمراني للمدينة القديمة بأبي الجعد خصائصه من هندسة المدن الإسلامية التقليدية، والتي تتميز بعدد من السمات الجوهرية التي تعكس البعد الروحي والاجتماعي للعمران الإسلامي.
وتتسم المنازل العتيقة بمدينة أبي الجعد بالتجانس في تصميمها الخارجي والداخلي، حيث يغيب في كثير منها وجود النوافذ المطلة على الخارج، في دلالة واضحة على ثقافة الوقار وصون خصوصية الجار، وهو أمر منسجم مع طبيعة مجتمع محافظ نشأ في ظل الإشعاع الديني والروحي لأحد أهم الأقطاب الدينية بالمغرب آنذاك. كما أن المساجد والمرافق العمومية من حمّامات وفنادق تميزت بالجمع بين البساطة والجمال، من خلال التناسق بين هندسة البنايات وزخارفها، وهو ما يعكس حضور العمارة الإسلامية بملامحها الواضحة في فضاء المدينة.
أما التنظيم العمراني للمدينة العتيقة فقد تميز بالتكامل والانسجام بين الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التوزيع المجالي المحكم للأنشطة والسكن، وهو تناسق يعزى في جوهره إلى التجانس بين مكونات المجتمع البجعدي، الذي لعبت الزاوية الشرقاوية دورا أساسيا في تأطيره وتوجيهه.
وفي فترة الحماية الفرنسية، كانت مدينة أبي الجعد من المدن الأوائل التي شهدت دخول قوات الاحتلال الفرنسية، وذلك بعد حملة الجنرال موانييه سنة 1910م. ومع حلول خريف 1912م، أنشأت سلطات الحماية مركزا عسكريا بالجهة الغربية للمدينة بمحاذاة منطقة “رجال الميعاد”، بهدف مراقبة القبائل التي واصلت مقاومتها للمخططات الاستعمارية. وقد تجلى التدخل الفرنسي في أبي الجعد من خلال وضع نواة أولى لسياسة إدارية محكمة، وُضعت بتنسيق بين مديرية الشؤون الأهلية ومصلحة الاستعلامات، أسفرت عن إحداث دائرة وادي زم–أبي الجعد؛ كإطار إداري جديد لفرض السيطرة وتنظيم المجال.[16]
وإلى جانب ذلك؛ عمل المستعمر الفرنسي خلال السنوات الأولى من الحماية على تشييد مجموعة من الأحياء السكنية والإدارية بجوار المدينة القديمة لأبي الجعد لإيواء الأجانب، الأمر الذي أفرز أنماطا جديدة من البناء تجلت في الطراز العمراني الأوروبي، وأسهم في تغيير النسيج الحضري التقليدي. وقد أوجد هذا النمط نواة حضرية جديدة شمال المدينة عُرفت بـ “أبي الجعد الجديدة”، تميزت باتساع أزقتها وانتظام شوارعها المتعامدة، في تناقض واضح مع تخطيط المدينة العتيقة.
وبعد الاستقلال؛ ازدادت الأوضاع الحضرية تعقيدا، حيث أصبح التحكم في التوسع العمراني أمرا بالغ الصعوبة، خاصة في المرحلة الممتدة بين بداية السبعينيات ونهاية الثمانينيات، وهي الفترة التي يمكن وصفها بـمرحلة الانفجار المجالي، إذ تضاعفت مساحة المدينة وعدد سكانها بشكل غير مسبوق، تجلى ذلك في توسع الأحياء الحضرية القائمة، وامتداد الأحياء الهامشية القديمة، فضلا عن ظهور أحياء هامشية جديدة.
لقد أفرزت هذه التحولات التاريخية مشهدا حضريا مركبا، يتجلى في وجود المدينة القديمة بما تحمله من تراث مادي، يقابله التراث اللامادي المتمثل في العادات والتقاليد المتوارثة. ومن ثم، فإن المشهد الحضري لمدينة أبي الجعد اليوم هو حصيلة تراكمات تاريخية متعاقبة، ما يجعل فهمه مستحيلا دون العودة إلى المراحل التاريخية التي مر بها.
خاتمة
لقد شكلت الزاوية الشرقاوية منذ نشأتها وتأسيسها في القرن السادس عشر، فضاء روحيا وعلميا أسهم في إشعاع أبي الجعد والمغرب عامة. ولم يقتصر دورها على التربية الروحية ونشر العلوم، بل امتد إلى التأثير في الحياة الاجتماعية والسياسية من خلال تأطير القبائل وتوحيدها، كما لعبت الزاوية دورا اقتصاديا بارزا بفضل الهبات والزيارات وموقعها الاستراتيجي على طرق القوافل. ومع مرور الزمن تحولت من نواة روحية إلى قوة عمرانية، صنعت حولها مدينة متكاملة. فلم تكن الزاوية الشرقاوية مجرد مؤسسة دينية، بل مشروعا حضاريا جمع بين الروح والعلم والمجتمع والعمران. ومن ثم تبقى دراسة أبي الجعد وزاويتها مدخلا لفهم عمق التجربة المغربية في تداخل الدين والعمران عبر التاريخ.
المراجع
[1] بوكاري أحمد، الزاوية الشرقاوية زاوية أبي الجعد؛ إشعاعها الديني والعلمي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،ط1، 1985م، ص 85.[2] بوكاري أحمد، الزاوية الشرقاوية زاوية أبي الجعد؛ إشعاعها الديني والعلمي، مرجع سابق، ص13.
[3] المالكي م، جوانب من التاريخ السياسي والديني والاجتماعي لأبي الجعد، ورد في مدينة أبي الجعد، الذاكرة والمستقبل، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 40، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ط1، 1995، ص36.
[4] عبد الرحمن بن زيدان، معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين، دراسة ببليومترية وتحقيق، حسن الوزاني، منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، المغرب، 1430هـ، 2009م، ج2، ص364.
[5] الرباطي الضعيف، تاريخ الضعيف الرباطي: تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد مولاي سليمان 9211-9311م، دراسة و تحقيق محمد البوزيدي الشيخي، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المجلد1، ص262.
[6] ليفي بروفنصال، مؤرخو الشرفاء، تعريب: عبد القادر الخلادي، الناشر دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، ط1، 30 أبريل 1977م، الرباط، المغرب، ص212.
[7] عبد الرحمن بن زيدان، معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين، مرجع سابق، ص267-268.
[8] الرباطي الضعيف، تاريخ الضعيف الرباطي، المجلد2، مرجع سابق، ص534.
[9] راجع: مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن، لأبي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهري، تحقيق محمد حمزة بن علي الكتاني، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1429هـ، 2006م.
[10] الناصري أحمد، الإستقصا لأخبار المغرب الأقصى، القسم الثاني، الجزء الثاني، دارالكتاب البيضاء، 1956م، ص56.
[11] بوكاري أحمد، الزاوية الشرقاوية زاوية أبي الجعد؛ إشعاعها الديني والعلمي، مرجع سابق، ص 20، بتصرف.
[12] بوكاري أحمد، الزاوية الشرقاوية زاوية أبي الجعد؛ إشعاعها الديني والعلمي، مرجع سابق، ص97، بتصرف.
[13] بوكاري أحمد، الزاوية الشرقاوية زاوية أبي الجعد؛ إشعاعها الديني والعلمي، مرجع سابق، ص 22، بتصرف.
[14] ضياء ح، تفاعلات المجال والمجتمع بالمدن التقليدية الصغرى، حالة أبي الجعد وأريافها، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ص17.
[15] ضياء ح، تفاعلات المجال والمجتمع بالمدن التقليدية الصغرى، حالة أبي الجعد وأريافها، مرجع سابق، ص39-40. بتصرف.
[16] الشرقاوي محمد، أبو الجعد: التاريخ والمجتمع والمجال خلال القرن 19م والنصف الأول من القرن 20م، أطروحة دكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس سايس، ص141. بتصرف.