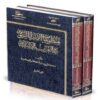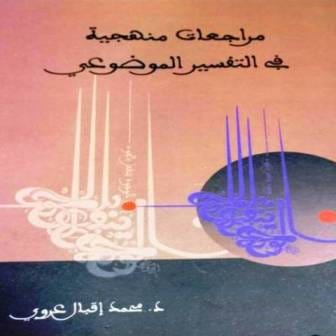
المحتويات
توطئة
ما زال القرآن الكريم، بوصفه خطاب الخالق جل وعلا إلى البشر كافة بخصوص ما دق وجل من شؤون وجودهم مبدأﹰ ومسارا ومصيرا، يستحث بل يتحدى العقول لتنهض لسبر معانيه، والوقوف على مراد اﷲ فيه، وإدراك مقاصده، والتحقق بوصاياه، والامتثال لأوامره ونواهيه، والتواصل مع رسالته. فهو في ذلك مثله مثل الكون الفسيح الذي لم يزل منذ أن درج الإنسان على وجه البسيطة تبهر عقله وروحه أرجاؤه الوسيعة، ويهزه ما يزخر به من مظاهر التكوين وعجائب الخلق وأصناف الموجودات وبديع الحركة، فيسعى تفكرا وبحثا لاكتناه أسراره، والتعرف على حقائقه، واكتشاف سننه، والمتح من خيراته، والتوقي من عوامل الضر فيه. وقد انشغل المسلمون عبر القرون بالقرآن تلاوة وحفظا ودرسا، فهو أُس وجودهم المعنوي، ومبنى هويتهم الحضارية، ومرصد وجهتهم التاريخية، وقوام كينونتهم الاجتماعية، وهو مصدر سعادتهم في الدنيا، ومرجع فوزهم في الآخرة. وقد تعددت لديهم سبل التعامل مع سوره وآيه تفسيرا وتأويلاﹰ، وتنوعت عندهم مناهج فهمه استنباطا، وما زعم أحد منهم أبدا أنه استنفد معانيه، وبلغ الغاية في استنباط أحكامه، وتحقق بالكمال في العمل بمقتضاه، ولم يخل عهد من عهود التاريخ ولا جيل من أجيال المسلمين من أناس يتدبرون نصوص القرآن، ويتفكرون في أقوم المناهج لتفسيره ودرك حقائقه، ويبحثون في أنجع الوسائل للعمل بأحكامه وإتباع هديه. ويأتي كتاب “مراجعات منهجية في التفسير الموضوعي” للدكتور محمد إقبال عروي ليجلي بعضا من هذا الاهتمام بكتاب الله تفسيرا وتقديم مراجعات، وبعض الاستدراكات والقيود التي بدت له عناصر ضامنة لتحقق وصف “الجامع المانع” في مفهوم التفسير الموضوعي وفق التقاليد الإصلاحية المعهودة.
مضامين الكتاب
لقد استقر التفسير الموضوعي على أرضية مقبولة من حيث المفهوم والمنهج، لكنه لا يخلو كغيره من المفاهيم والمناهج من ملاحظات واستدراكات، وذلك لأن تراكم الدراسات التي تستظل بالتفسير الموضوعي شكل وما يزال مناسبة لأن تتقوى آلية اختبار المفهوم والمنهج على حد سواء.
ووعيا من المؤلف بأن الدراسات التطبيقية كفيلة بأن تصقل كلا من المفهوم والمنهج، وتقوي دعائمهما، وتخرجهما من حالة النظر المجرد إلى النظر المسدد، فقد استوعب هذه المراجعات “موضوعات” و “مفاهيم” قرآنية، ودرسها دراسة مؤسسة على الاستقراء الجمعي والتحليل السياقي والنظر المقاصدي، وخلص إلى نتائج ربما لم يكن بمقدور التفسير الترتيبي الوقوف عليها. (الكتاب، ص: 5\6)
ولم يكن اختيار تلك الموضوعات راجعا إلى نسبة ورودها في الخطاب القرآني، وإنما بسبب أهميتها في تشكيل الوعي لدى الأفراد والجماعات. وبمقتضى هذا المعيار، فقد تناولت المراجعات مفهوم “الأمن” و”الجسد” و”دار الحرب ودار الإسلام” و”الزمن” و”الاتصال” كما يعرض لها القرآن الكريم، مستندة في تحليلها أربع آيات. واستخلاص دلالاتها من التراث التفسيري لأعلام الأمة الذين بذلوا الوسع والجهد في تحقيق قيمة “التدبر” التي أمر بها القرآن الكريم في أربع آيات. (الكتاب، ص: 6)
لقد اجتهدت المراجعات في صياغة مفهوم للتفسير الموضوعي يرشح المصطلح لتجاوز ما يمكن أن يتوجه إليه من نقود أو استدراكات، ولعل من شأن الاهتمام الذي يمكن أن يحظى به ذلك التعريف أن يمنحه مزيد تهذيب وتشذيب يقوى بهما عوده، وتستقر دلالته. وقد اتخذت المراجعات ذلك التعريف مرجعا في دراستها لبعض العناصر الآتية: “الموضوعات” القرآنية، وانتهت إلى خلاصات يمكن صياغتها ضمن مجموعة من العناصر من أهمها: أن الدراسة تقترح أن يتحول مفهوم التفسير الموضوعي” إلى قاعدة من قواعد التفسير تنضاف إلى بقية القواعد التي تشكل منظومة المفاهيم والآليات والمناهج المرتبطة بسلامة التفسير. وهي قاعدة ترفع الخلاف، وتقوي الترجيح، لأنها تتعامل مع الآية الواحدة في سياقها التنزيلي وعلاقتها الدلالية بغيرها من الآيات في الموضوع الواحد. كما تتطلع الدراسة إلى إبراز الأسباب الكامنة خلف طغيان نفسية عدم أمن مكر الله لدى المسلم خلافا لما عليه الأمر في استقراء مظان لفظة “أمن” في القرآن الكريم، وتتبع سياقات ورودها.
وإذا كان البعض يعتقد بأن الحديث عن “الجسد” في القرآن الكريم يمثل مغامرة محفوفة بمخاطر تصورية وأخلاقية، فقد أمكن للمراجعات أن تضع اليد على مجموعة من المعطيات التي يمكنها أن تشكل “مهادا” قرآنيا لعلماء النفس والاجتماع والتربية وصناع المحتويات الثقافية والفنية، وذلك بغية رسم ملامح المنظور القرآني للجسد. ولقد اهتمت الدراسة بمقولة “دار الإسلام ودار الكفر” وأبرزت أن النصوص الشرعية، لا وجود فيها لحديث صريح عن تقسيم البلاد إلى دارين، بقدر ما استدعى النظر الفقهي هذه المصطلحات بين يدي توصيف واقع تاريخي وسياسي. وركزت الدراسة على “وعي الزمن” وكشفت أن القرآن يقدم للوعي الزمني الإنساني خطاطات وظيفية. (الكتاب، ص: 254\260)
هذا وقد تضمن الكتاب بعد المقدمة خمسة مباحث جاءت على الشكل التالي: المبحث الأول عنونه ب: التفسير الموضوعي: قراءة في المفهوم. المبحث الثاني: مفهوم “الأمن” في البيان القرآني. المبحث الثالث: مستويات حضور الجسد في الخطاب القرآني. المبحث الرابع: مقولة دار الإسلام ودار الكفر بين السياق التاريخي والبيان القرآني. المبحث الخامس: منظومة الاتصال في البيان التفسيري.
خلاصة
إذا كان القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، فإن إحدى عجائبه الباهرة تكمن في أنه زاخر بالتوجيهات والمعالم التي ترسم الوسائل والآليات المساعدة على تمكين ثقافة الاتصال… ولم يتنعم العقل المسلم بأن تنسلك تلك الآليات في وعيه مسلكا يحقق ثقافة الاتصال إلا في ما نذر. من تلك الوسائل: تقرير اختصاص الله بالحكم على الناس، واعتبار الدنيا فضاء لاستباق الخيرات لا الصراعات وإبراء الذمة من سلوك النقمة، وإقرار قاعدة الوقوف عند محمود الاختلاف ونبذ مذمومه والاحتكام إلى تفويض الأمر إلى الله. وهذه الآليات مستنبطة من نجوم آيات موزعة في المصحف، تنزيلا وتلاوة لكن يتعين سلكها في منظومة واحدة، وهي منظومة الوصل والاتصال.