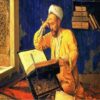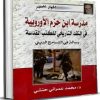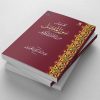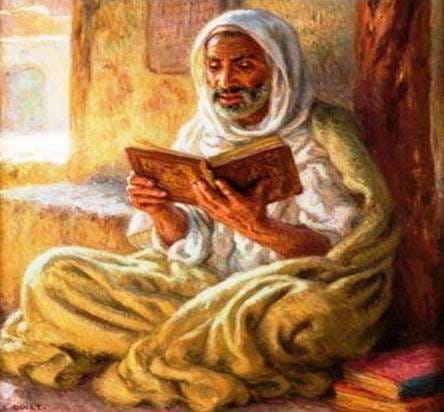
المحتويات
نسبه ومولده ونشأته
لا نكاد نَعثر فيما كُتِب عن مُترجَمنا ونُقولات مَن تتلمذوا على يديه خبراً عن تاريخ ميلاد الرجل، ولا عن طفولته وصباه، إلا أنَّ بعض المؤرخين[1] أرجعوا ميلاده إلى أواسط عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي (1710م_1790م)، ومسقط رأسه إلى مدشر أكَرْسيف [بالكاف الـمُعْجَمة]، من توابع أمانُوز بالأطلس الصغير الغربي بمنطقة سوس، التابع إداريا ضمن التقسيم الترابي للمملكة المغربية حاليا إلى الجماعة القروية تارْسواط، ضمن دائرة تافراوت، التابعة لعمالة إقليم تزنيت، في جهة سوس ماسة.
قلَّما يُلتَفتُ إلى علماء الأطراف؛ وصاحبنا عمر بن عبد العزيز الذي آوَتْه قرية أكَرسيف في بيوتات علمائها، وبين رحابِ كتاتيبها، وفي رُبى ودْيانها وجبالها، قد قدَّمته للوَطن من العلماء الراسخين، وجادَت به صدقةً جارِية تنتفع بها الأجيال، عقوداً وسِنين.
ينتمي العالم الجليل عمر الكرْسِـيفي إلى الأسرة الكرسيفية السوسية التي توارثت العلم والنبوغ كابرا عن كابر، بشهادة الشيخ المدقِّق المحقق في الأنساب العلامة المختار السوسي الذي أكَّـد أنّ العلم لم ينقطع في هاته الأسرة من بدايات القرن الثاني عشر الميلادي وإلى غاية القرن العشرين، وأخبرنا في موسوعته الأثيرة “المعسول”[2]، عن الشخصية العلمية الفذّة من هذه العائلة، التي حملت رقم 61 ضمن الـمترجَم لهم في “معسوله”، وهو عمر بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن عبد الرحمن بن محمد الكرسيفي الإيــرْغِــي، وأوردَ أقوال النبهاء مِن العلماء فيه، التي أجْمَعت على أنّ “الفقيه السيد عمر بن عبد العزيز الكرسيفي كان رحمه الله عالما بارعا، أديبا بليغاً، فصيحَ وقْتِه، وناصح عَصْره، مشاركا في الفنون، حَيْسوبِيا، فَرَضيا، نحويا، له قصائد وأجوبة وفتاوى..”، ولا غَرو أنْ يوصف بهكذا وصْف، وهو الذي تَلقّى مبادئ العلوم في باديته، وانتقَل حينَ شبابهِ راحلا في سبيل العلم إلى سجلماسة فلازَم فيها شيخها الكبير أحمد بن عبد العزيز الهلالي حتى تخرَّج فقيهًا من زاويته، ثم رحل بَعدها إلى فاس، ودَرس على الشيخين العالمين عبد القادر بن علي الفاسي، وعبد الوهاب الفاسي، وعاد إلى سوس، معزِّزا رصيد المعارف في الحديث والتفسير وفقه النّوازل على يد رائد النهضة العلمية في الإقليم السوسي الكبير سيدي محمد الـحُضيكي[3] الذي وصَف الفقيهَ عمر الكرْسيفي حينَ إجازتِه له بــ”العالِم العامِل، العلّامة الجامع لخِصال الفضائل ومُشفِّعها بالفواضل (..) المنتظِم في سلك أهل التّحقيق (..) الفقيه الجليل مولانا عمر بن عبد العزيز”، فيما عَدّه الشيخ الإدْكِــيلي مِن “المحقِّقين في فنون العلم، فِقهاً، ونحوا، ولغةً وحسابا، وتفسيرا وبياناً ومنطقا وتصريفا”.
ونظرا لإرث عائلته العلمي الزاخر، ولمكانته في بني طبقته من العلماء والفقهاء؛ فقد جَـمعته صُحبة طيِّـبة مع العالم المتمكن محمد الـحُضيكي، وبالعَلّامة أبي العباس الهلالي وبأشياخ الوقت ممن ذكرَهم الأستاذ المختار السوسي في “المعسول”[4]. كما كان مِن بَنيه علماء ونجباء، لعل أشهرهم الفقيه الأديب محمد بن عمر الكرسيفي، ومن حفَدته العالم الشّهير يحيى الكرسيفي.
الكرسيفي.. الفقيه النوازلي
كان الفقيه المتفرّد عمر الكرسيفي “أنشطَ مُعاصريه في كلّ الميادين العلمية، فألَّف، وذيَّلَ، وبَيَّنَ، وشَرح، وأفْتَى وأقْضى”[5]، فَعَبَر حِقبَتي السلطان محمد بن عبد الله والمولى سليمان مُثْقَلا بتاريخٍ علمي مجيدٍ ورِثه عن أسرته السوسية الماجِدة، وواسِما مرحلته بالمشاركة في شتّى المعارِف والعلوم، ومجدِّدًا دَوْر “الكرْسِيفِـيِّينَ” باعتبارهم طَليعة العائلات التي أرْست النهضة العلمية في سوس بعد القرن الثامن الهجري، إلى جانب “الرّسْـمُـوكِـيّين والوَادْنُـونِـيِّين والـحُضَيْكِيِّين”[6] ” لِــمَا امتازَ به مِن “رؤية تدريسية ثاقبة وجامعة وشاملة لكافة الفنون” حسب تعبير الباحث خالد الطايش في مقاله “التعليم العتيق بسوس من خلال الأسَر العلمية”، منفَرِداً عن “العديد ممن عاصَره مِن العلماء باهتمامه بقضايا النوازل والمستجدّات التي كان يعرفها مجتمعه (…) ويَظْهَر من خلال تَصَفُّحِ معالجاتِه؛ هاجِسُه الإصلاحي المتجِّه إلى الالتزام بالأحكام الفقهية، والمنضبِط بضرورة رعاية حقوق النّاس وأحوال المجتمع على قياس الشّرع، واحتواء المستجدَّات وِفق أحكام المذهب المالكي”[7].
عمر الكرسيفي.. موجها تربويا
لم يَـفُت الشيخ الفقيه العلّامة الكرسيفي الاهتمام بمجال التعليم والتدريس والتربية، فمارسهما وأتقنهما؛ وأبْدع في الإتيان برسائل ونصوص وضَع فيها الفقيه عمر الكرسيفي شروطاً لإنجاح العملية التعليمية التعلمية – تُذكّرنا بالقواعد الخلدونية وبجملة القواعد التي ذبّجها العلامة محمد بن مسعود الطرونباطي في “بلوغ أقصى المرام في شَرف العلم وما يتعلَّق به من الأحكام“[9]– منها ما تخُصّ الأستاذ/الشيخ/المدرِّس، ومنها ما له صِلة بالمتعلِّم/التلميذ/الطّالْب.
فعلى الأستاذ/الفقيه [في سياق الماضي] أنْ يُعنى بتجميل الهيئة، والسّمت الـحَسَن، واستحضار الهيبة والتّعظيم لـمَحَلِّ نِيابته عن الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أنْ يفتتح دروسه بالتَّعوذ والبَسملة والتَّصلية والترضية والحوقلة، وعليه أنْ يُـبيِّن جيّدا الألفاظ والمواد التي يُدرِّسها، وأنْ يمتاز في أسلوبه التّعليمي بِسهولة العبارة، وأنْ يسْتَدِلّ بالأمثلة والشواهد، وأنْ يَكون حليما بالمتعلِّمين، صَبورا على أخطائهم، لا يملُّ نهيهم عن المساوئ. ومن الناحية الكلية؛ أنْ ينتصر للمذهب وللدين الرسمي للبلد، وأنْ يكون مُساهما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أما آداب المتعلّمين والوِلدان فكثيرة، أهمها؛ الصبرُ على التغرُّب عن الديار والأهل، والانقطاع للدروس والتلقِّي عن الأساتيذ، والصِّدق في المعاملة لأصدقاء الدراسة صغارا وكبارا، والاتِّصاف بمكارم الأخلاق، والاقتصار في المطالعة على كُتُب علماء أهل السُّنة والجماعة مع ضرورة الابتداء بقراءة المراجع والمصادر الـمُيَسَّرة السهلة قبل الكتب الـمُــسْـتَغْــلَقة، وتوقير الشيوخ والفقهاء والعلماء، والترفُّع عن الصِّراع مع الأقران، والحرص على الصّلاة والذِّكر والنوافل والصيام ليستعينوا بها على المسار الطّويل للتعلُّم والدّراسة. وفي الجوانب الشكلية؛ حُسْن اختيار الملبس، ونقاوة الجسم، وحُسن اختيار أوقات الخروج من المحضْرة أو المسيد؛ بما يُفيد غَيْرة الإمام الكرسيفي على حقل التربية والتعليم، وسعيه لتطويرهما، ورغبته في استمرار برَكة العلم في الناحية السوسية وتَسَلْسُله في أبناء القبائل والبوادي.
والكْرسيفِيُّ في كلّ هذا يَعتمد منهجاً قَــد “تحَرَّرَ مِن قيود استعمال النَصوص التّقليدية والإسراف في تِكرارها” ويبْني “على الوثائق وتوظيف المراجع لبناء موضوعاته”، ويستعين بــ”المنطق والأسلوب الجدلي واستعمال الفِكر” و”لا يُهمِل الاستشهاد بالنصوص التّشريعية وبالقواعد الأصولية والمنطقية”، حسَب تعبير محقِّق الأعمال الفقهية الكبرى للشيخ الكرسيفي، الدكتور المؤرخ عمر أفا[10].
آثاره العلمية
يَـتَبَيَّن المنحى النوازلي في فكر الكرسيفي في رصيده العلمي الزاخرِ، بدْءً مِن رسالته في “تَحقيق الـمُدِّ والصاع النَـبَوِيين وصُنعِهما من النحاس بواسطة قياس درهم الكيل (الدرهم الشرعي)”، التي اعتنى بها المؤرخ العلاَّمة المختار السوسي ونَشرها ضمن كتاب “المجموعة الفقهية في الفتاوى السوسية” وتمَّ طبعها من قِبل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير سنة 1993، مروراً بأعماله النوعية التي ناهزت 29 كتابا، جُمِعت 19 منها فقط في “الأعمال الفقهية الكاملة”، في 471 صفحة، وطُبِعت بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
وأعمالٌ أخرى في فقه العبادات والأدب والنوازل والحساب والتوقيت والحديث، نذكر منها: “الكوثر الثَّجّاج في كَفِّ الظِّمئ المحتاج”، و”فتوى في مَسائل عن إخراج زكاة الفطر”، و”الدُّرَر في النَّظائر من مسائل المختصَر”، و”الأجوبة الروضية في مسائل مرضية في البيع بالثَّنا والوصية”، و”كفاية الـمَؤونة في فهم المعونة”، و”رسالةٌ في بيان معرفة بداية السنة الفلاحية الشمسية وما يُوافقها من السنة القمرية”، و”نَظْمٌ في بيان منازل الشمس الفلكية”.
وفي مجال والأوزان والـمكاييل كَتَبَ “السّكك المغربية في القرون الأخيرة”، و”تحقيق أوزان النقود في سوس”، و”اقتناء الموازين الكَـيْلِـية الشَّرعية وتحقيقها”.
كما اعتنى بمجال السِّيرة النَّبوية الشّريفة فَخَلَّفَ لنا كتابَيْه “دلالةُ الهائم الـكئيب على أطلال رُبوع الحبيب”، و”السِّراج الـمتوقِّـد الأصفى في ذِكْر بعض أحوال المصطفى”. ورسالة مهمة جدّا تمَّم بها ما أثاره الفقيه الشّهير في شمال المغرب ابن عَرْضُون[8] في موضوع الإرث والكدِّ والسِّعاية وحقوق المرأة، وعَنْوَن كتابهُ بــ”رسالةٌ في قِسمة التركة إذا كان فيها كَدٌّ وسِعايةٌ، حفاظاً على حقوق المرأة والـكَسَبة”. إضافةً إلى أرجوزةٍ ومنظومتان شعريتان، ومن أبياته قوله:
لَقد أخَذَت مني قوافيك مأخَذا *** عظيمًا كأنِّي قد سُقيتُ بِها صَرْفَا
سمِعـتُ بـيانا بارعاً وفَصاحةً *** إذا سِمْتُها فِكري فقد سِمْتها حَـيْفَا
وقوله:
نفْسي ارعَوِي عَمّا اقترفتِ ولا يَكن *** أبداً إلى العِصيان منكِ جُـنُـوحُ
وابْـــكِ على ما قــــد جَـنــيتِ فإنّـهُ ***حقٌّ على حِلْف الذنوب ينـــوحُ
وفاته
إنّ هذا الرجل الذي جَعَل على جادّة الصِّدق سَيْره، وعلى آثارِ العلماء خَطْوه، فأبدَع ونَفع، جَرَت أقدار الله أنْ يُصابَ بعدوى الوباء الـفتّاك الذي عَصَف بالمغرب الأقصى سنتي 1799م– 1800م في عصر السلطان العلوي سليمان، فتُوفِيَّ إلى رحمة الله سنة 1800م على رأس القرن التاسع عشر، ودُفِن في قرية إيرغ بالأطلس الكبير.
المراجع
[1] أنظر مثلا: محمد المختار السوسي، "رجالات العلم العربي في سوس من القرن الخامس الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر"، مراجعة وضبط رضا الله عبد الوافي السوسي، مؤسسة الطباعة والتغليف والنشر والتوزيع للشمال، طنجة، الطبعة الأولى 1989.[2] (السوسي) محمد المختار: "المعسول في الإلغيين وتلامذتهم وأصدقائهم"، الجزء 17، مطبعة النجاح – الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1963، نسخة إلكترونية، ص: 81.
[3] (الحضيكي) محمد بن أحمد: "طبقات الـحُضيكي"، تحقيق الباحث أحمد بومزكو، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2006.
[4] السوسي محمد المختار، "المعسول.."، مرجع سابق، ص: 82
[5] السوسي محمد المختار، "المعسول.."، مرجع سابق، ص 83.
[6] (السوسي) محمد المختار: "سوس العالمة"، مطبعة فضالة –المحمدية، الطبعة الأولى 1960، ص: 20 وص: 47.
[7] أحمد التوفيق في تقديمه لــ"لأعمال الفقهية الكاملة للفقيه الكرسيفي"، ص: 6.
[8] انظر ترجمته في: (المكناسي) أحمد بن القاضي: "جِـذوة الاقتـباس في ذِكــر مَـن حَـلَّ من الأعلام مدينةَ فاس"، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، الطبعة الأولى 1973، ج. 2، ص: 558 - (ابن القاضي) أحمد بن محمد: "درّة الحِجال في غرة أسماء الرجال"، مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية، المطبعة الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 1934.
[9] (الطّـرُنْباطي) محمد بن مسعود: "بلوغ أقصى المَرام في شَرف العلم وما يتعلَّق به من الأحكام"، تقديم وتحقيق عبد الله رمضاني، مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، الطبعة الأولى 2008.
[10] (أفا) عمر: "المؤلفات الفقهية الكاملة للعلاّمة عمر بن عبد العزيز الكرسيفي"، جَمْع وتحقيق، الطبعة الأولى 2006، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.