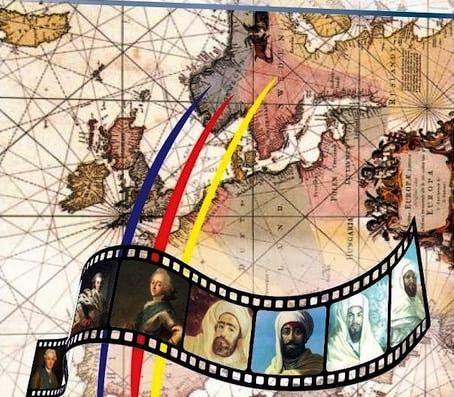
المحتويات
تمهيد
أُسدل الستار على العصر الحديث بالبحر الأبيض المتوسط وقد خلّف وراءه تحولات عميقة، جعلت من ضفتي المتوسط منطقتين تقفان على طرفي النقيض أو تكادان، فالضفة الأوربية عرفت تحولات سياسية عميقة، وراكمت مناهج علمية وأنماط اقتصادية خوّلت لدولها التحوّل إلى دول قوية سياسيا واقتصاديا ومتطورة عسكريا. أما دار الإسلام حسب تقسيم مسلمي تلك الفترة فقد طال بُناها الركود وغابت عنها محفّزات داخلية لتجديد الفكر والثقافة وتطوير الصناعات بنفس الوتيرة التي تطورت بها نظيراتها الأوربية، أما سياسيا فالانشغال بالصراعات الداخلية لم تفض إلى إبداع أنظمة سياسية تحفظ الاستقرار وتؤمّن الانتقال السلس للسلطة من مرحلة إلى أخرى.
هذه التحولات هي نتائج لعوامل عدة ربما أبرزها حالة الصراع التي تسيّدت الأحداث ضفتي المتوسط طيلة العصر الحديث، ما أفضى نسبيا إلى انعزال هذين العالمين عن بعضهما البعض، وبالتالي اختلف المسار التاريخي لكل منهما، بالاستناد إلى هذه المقدمات نتساءل كيف انعكست هذه الفجوة الحضارية بين شمال المتوسط وجنوبه على تطور الأحداث التاريخية بالمغرب خلال النصف الأول من القرن 19م؟ وما مستوى إدراك المغاربة واستيعابهم للتحولات التي طرأت في تلك الحقبة وانعكست في شكل ضغوط عسكرية وسياسية على المغرب؟
صورة الآخر الأوربي في الذهنية المغربية أواخر القرن 18م
إلى حدود نهاية القرن 18م، كانت صورة الآخر (النصراني) في الذهنية المغربية يغلب عليها التبخيس والدونية إذ أن موازين القوة كانت لا تزال متكافئة إلى حد ما، وبالتالي لم تكن هناك قرائن يُستدلّ بها على الطفرة الحضارية التي تشهدها أوربا، ونلمس نزعة التفوق هذه عند الرحالة المغربي المهدي الغزال (ت.1777م)، في حديثه عن الجيوش الإسبانية بأنّهم “لا قدرة لهم على مباشرة القتال صفا صفا، إلا ما كان من رمي المدافع والبنب واستعمال الخدائع” بل “إن المائة ألف منهم تقاومها العشرة آلاف من المسلمين بنص الكتاب العزيز”[1]، إذ كانت هذه النظرة للآخر هي الداعي لاستعمال “أسلوب المفاضلة” كما وصفه عبد المجيد القدوري، لكن مع الوقت ستتغير هذه النظرة تدريجيا في كتابات السفراء المغاربة إلى أوربا ويحلّ أسلوب الدهشة والانبهار محلّ أسلوب الحطّ والتبخيس.
بدأت حالة التوجس من الخطر الأوربي عند المغاربة مع انطلاق الحملة النابليونية على مصر سنة 1799م، حيث كانت هذه الحملة الأولى من نوعها التي تجاسرت على بلد إسلامي منذ الحروب الصليبية، فالأمر لم يقتصر على ثغر من الثغور الساحلية، وإنما بالسيطرة على بلد في عمق دار الإسلام. أمام هذا المستجد تذكر المصادر التاريخية كيف استقبل المغاربة هذا الخبر بنوع من الارتياب والإحساس بالخطر الوشيك، يقول القنصل البرتغالي غولاصو في رسالة بعثها إلى دولته سنة 1801م: “يوجد عند هؤلاء الناس قلق من غزو محتمل من طرف إسبانيا وفرنسا شبيه بما حدث لمصر. ويعتبرون ما وقع بسبتة مقدمة له”[2].
بل إن التصور الذهني عند المغاربة لقوة الآخر (العدو) ذهب في توقعاته إلى ابتداع إشاعات بعيدة عن الواقع؛ تعكس بعمق حالة الخوف السائدة آن ذاك، كما يحضر في سرد الضعيف الرباط الذي نقل لنا كيف أشيع في أوساط المغاربة أن نابليون ينوي تشييد قنطرة خشبية لتعبر عليها جيوشه من إسبانيا نحو المغرب: “وفي هذه السنة (1222ه) قوي سلطان الفرنسيس وهو نابليون بنابارطي، وقهر أجناس النصارى وغلبهم، ولا بقي مخالفا عليه إلا النكَليز، وأراد الخروج للمغرب وأتى بأجناس النصارى للبوغاز وإلى طريفا والخزيرات وصنع قنطرة من اللوح ليقطع عليه”[3].
ثم استمرت حالة الخوف والتأهب في هذه المرحلة مما لا يدع مجالا للشك في أنه كان هناك نوع من الإدراك للتربص الأوربي بالمجال المغربي: “وفي أوائل العام محرم 1223ه شاع وذاع بأن النصارى دمرّهم الله خارجين للمغرب، وأخذ الناس في الاستعداد للجهاد من جميع جهات المغرب كأهل فاس وتطاون والرباط وسلا وغير ذلك، وفي يوم الثلاثاء 13 صفر من العام المذكور ورد كتاب السلطان من مراكش يحذر أهل سلا وأهل الرباط من بني الأصفر.
وفي يوم الثلاثاء 21 ربيع الأول سمعنا بأن النصارى نزلوا بمرسة تامراغت بقرب أكادير، وشاع خبرهم بسلا والرباط. ثم كان الخبر غير صحيح”[4].
لكن في حقيقة الأمر يبدو أن ذهنية النخبة المغربية آن ذاك -من خلال الضعيف الرباطي- لم تتجاوز حالة الخوف إلى فعل التساؤل الكامنة وراء هذا التربص، هل هي مناوشات بحرية عابرة أم أن الأمر أكثر تعقيدا يرتبط بتحولات كبرى شهدتها قارة أوربا.
اختلال التوازن العسكري بين المغرب وأوربا الغربية
توالت الأحداث السياسية أوائل القرن 19م، إبان حكم المولى سليمان (ت.1822) في اتجاه تقوية النفوذ الأوربي في البحر الأبيض المتوسط وإضعاف الدول المغاربية، وفي هذا السياق تأتي الاتفاقية التي وقّعها المغرب مع أمريكا 1803م، على إثر الرد الأمريكي على اعتراض سفينتهم، ثم كانت محطة مؤتمر فيينا 14-1915م، التي تم فيها تسوية النزاعات السياسية بين الدول الأوربية بالتقاء مصالحهم في محاربة ظاهرة “القرصنة”، واتقاء لأي عواقب قد تضرّ بالإيالة الشريفة أبطل السلطان الجهاد في البحر سنة 1817م[5]، وأتى مؤتمر “اكس لاشبيل” 1818م، بألمانيا، ليؤكد على القضاء بصفة نهائية على “قراصنة الدول البربرية”، وهذا ما تمّ بالقضاء على الأسطول الجزائري 1827م، من قِبل الإنجليز بعد فشلهم في المحاولة الأولى سنة 1824م[6].
بعد اعتلاء المولى عبد الرحمان بن هشام سُدّة السلطنة 1822م، حاول إحياء “سنّة الجهاد البحري”، إلا أن “قيام شوكة الفرنج ووفور عددهم وأدواتهم البحرية” وقفت سداً منيعا أمام طموحه فأعرض عن هذا التوجه تجنبا لإثارة “الخصومة والتجادل والنزاع”[7] كما يقول أحمد الناصري.
تزايد الوعي باتساع الهوة الحضارية بين دار الإسلام وبلاد النصارى عند المغاربة باحتلال فرنسا للجزائر 1830م، وما يعكس هذا الوعي بتفاوت القوة هو ذلك التيار الذي كان يدفع باتجاه إحجام السلطان عن قبول مبايعة أهل تلمسان وعدم الانجرار إلى المواجهة مع فرنسا “وأن من نهاه (أي نهى السلطان) عن مقاربتها على كل حال، وهم أهل العقول الراجحة، والآراء السليمة، والطريقة الواضحة”[8] فرجاحة العقل والرأي السليم هنا بالنسبة للكنسوسي نابعة من تقدير الموقف من منطلق تفكير واقعي بعيدا عن العواطف الجياشة والاندفاعات الوجدانية.
كما يُستشفّ من “الظهير الرحماني لعاملي العدوتين الرباط وسلا بالاستعداد للطوارئ المنتظرة من فرنسا”، سنة 1258ه، أن المخزن وإن كان متوجسا من تحركات الأجانب إلا أنّه تعامل بسياسة النديّة والاستعداد حتى لا يحسب “الأعداء كلّ بيضاء شحمة” أي حتى لا تضع فرنسا الجزائر والمغرب في سلّة واحدة. فعمل على رفع جاهزية الثغور والتأهب لأي نوع من الخطر حتى “يبلغ العدو من ذلك ما يغيظه ويسوءه”[9]، وفي هذا الإطار يمكننا أن نخمّن كيف فسّرت فرنسا دخول الجيش المخزني إلى تلمسان؟ بالنسبة للمغرب وإن كانت هذه الحملة قد فشلت إلا أن وقعها عند الجيش الفرنسي سيترك على الأقل انطباعا بأن المجال المغربي هو مجال محصّن ليس سهل المنال.
وعليه مما يدعم فكرة تكوّن انطباعا فرنسيا عن المغرب يتّسم بوجود دولة وقوة ومجتمع مقاوم رسالة بعثها أحد قناصلة فرنسا بطنجة بتاريخ 3 يوليوز 1841م، يقرّ فيها أنه: “من الصعب التأكد من الحقيقة: أن يكون هناك تأهّب للحرب، فهذا لا شك فيه، أن يكون السلطان منع الحرب، فهذا شيء محتمل، ولكن أن يكون قد استطاع مقاومة التيار الجارف للسكان المتعصبين فهذا بعيد الاحتمال”[10].
إذا كان الفرنسيون قد توجسوا من رد فعل المغاربة تجاه أي هجوم، رغم إدراكهم افتقاد الدولة المغربية لدفاع منظم ولآليات عسكرية متطورة، إلا أن اندفاع المجتمع المغربي والإجراءات التي اتخذها المخزن أخّرت سيناريو احتلال الجزائر في المغرب حوالي ثمانين سنة.
المراجع
[1] عبد المجيد القدوري، سفراء مغاربة في أوربا 1610-1922في الوعي بالتفاوت، منشورات كلية الآداب بالرباط، الطبعة الأولى، 1995، ص 54.[2] عثمان المنصوري، "صدى الحملة النابليونية في المغرب"، أعمال ندوة العلاقات المصرية المغربية عبر التاريخ، نظمت بجامعة حلوان بمصر 2002، ج1، ص 205-227.
[3] محمد بن عبد السلام الضعيف، تاريخ الدولة السعيدة (تاريخ الضعيف)، تحقيق أحمد العماري، الرباط، 1986، ص 342.
[4] محمد بن عبد السلام الضعيف، تاريخ الدولة السعيدة (تاريخ الضعيف)، مرجع سابق، ص 344.
[5] محمد القبلي، تاريخ المغرب تحيين وتركيب، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الرباط، 2011، الطبعة الأولى، ص 455-456.
[6] محمد النوني، مظاهر يقظة المغرب الحديث، ج1، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، 1975م، الطبعة الثانية، ص، 11-12.
[7] أحمد الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ج9، تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتب، الدار البيضاء 1997م، ص 26.
[8] محمد الكنسوسي، الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا السجلماسي، ج2، تحقيق أحمد الكنسوسي، ص، 20.
[9] عبد الرحمان بن زيدان، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضر مكناس، ج5، تحقيق علي عمر، متبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2008، الطبعة الأولى، ص 57-58.
[10] ثريا برادة، الجيش المغرب وتطوره في القرن التاسع عشر، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ص 189.




















