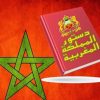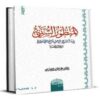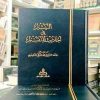المحتويات
توطئة
منذ عصورٍ والعلماء المغاربة يَحفَظون ويُوثِّقون مسارات الثقافة والفكر والحضارة[1] والشريعة والعلوم التي بَصمت كلّ قرن على حِدة، من خلال مُدوَّنات ومخطوطات ومصنّفات وفهارس، هاته الأخيرة لعِبت دورا بارزا في إحاطتنا عِلْمًا بحياة وإضافات مشاهير رجالات العلم والأدب والتدريس والسياسة والتصوّف والجهاد، لا سيما بعد أنْ امتدَّت إليها يَدُ العناية العلمية تحقيقًا وتخريجاً ودراسةً، فصِرنا أمام تُراث مغربي هائل، نُباهي برجاله ونسائه، ونستعيد مِن خلال مَا كَتبوه لحظات الإشراق والنبوغ المغربي.
ينفرد كلّ عَلَم مِن أعلام عصر مِن العصور المغربية عن سابقيه ولاحقيه، فيُتحِفنا بما لم نكُن نُحاطُ به علما، ويُركّز بذكاء على ما يُشكِّل إضافة نوعية في حقلٍ من حقول المعرفة والإنسانيات واجتماعيات الثقافة وغيرها من المجالات. ونتوقّف هنا عندَ سيرة عالِمٍ تمَّمَ جهود سابقيه بأنْ اختَصَّ بوضع فهرسٍ ضمَّ أهمَّ معالم ومسارات التعليم وطُرق التدريس والإقراء في العصر السَّعدي الزاهر، يتعلَّق الأمر بالشيخ المجتهد المتفنِّن المكابِد في سبيل الترقِّي العلمي، العلّامة عبد الواحد بن أحمد السجلماسي.
مراتع الصِّبا ومنابِع العـلم
كانت ولادة عبد الواحد في الثاني عشر من يونيو 1527م بسجلماسة العريقة، من أصول ضاربة في الشَّرف، فتربّى في أحضان والده الذي كان فقيها وعالما، ومنذ سنته الثانية عُهِدَ به إلى شيخ الزاوية الشهيرة بالحنّا في زاكورة الحالية، الشيخ محمد بن المهدي الجراري، فترعرع بين يديه ومَجالسه العلمية والتربوية.
تلقّى السجلماسي الحسني تعليمه في مبادئ العربية والعلوم الشرعية، وختَم مرارا صحيح الإمام البخاري وأراجيز عديدة في النّحو والصرف والفرائض، إلى جانب اشتغاله على كُتب التصوف وأصول الفقه بجدية ونهَم، إضافة إلى المختَصَرات والألفيات الشّهيرة في التدريس إلى ذلكم الوقت. أما القرآن الكريم فقد أتمَّ حِفْظَهُ على يديْ شيخه الفقيه اللامع سعيد بن علي الهوزالي[2]، إضافة إلى أخْذِه عنه علم القراءات والحساب.
استزادَ مِن العلوم عن نوابغ ومشايخ أجلاّء، ذَكر منهم محمد بن المهدي الجراري، وسعيد الهوزالي، وأحمد بن علي المنجور، ومحمد بن مُجبِر المساري شيخُ اللّغة والقراءات في عصره، الذي وَصَف لنا العلّامةُ عبدُ الواحدِ طريقتَه في التدريس بأنها كانت مُتقَنَة، لا سيما في علم النحو بما كان يمتاز به الشيخُ المساري مِن قدرة فذّة على استنطاق وشرح الألفية ودقائق النحو حتّى كانت “تَرتفع في مجلسه للأبحاث النحوية سوق نافعة (..) ويُتحِف المتعلِّمين بتقاييده وفوائده، ويَمُدُّهم بفرائده”[3].
بَعد مرحلة طويلة من الطّلب العلمي في عُمق درعة، تاق الرجل إلى مُصاحبة الشيوخ الكبار ومحادثة ذَوي المعارف في الحواضر المغربية الشهيرة بأعلامها وعلمائها. فارتحل إلى فاس، وفيها أُجيز على يد كبار العلماء، وأساساً على الإمام العلّامة رضوان الجنْوي ابتداءً من سنة 1574م وعنه أخذ الإجازة في الحديث وفي فِهْرِسَتيْ ابن غازي وابن حجر، و”يَظهَر أنَّ هذه الإجازة كانت المبتَغى الذي اجتهَدَ في الوصول إليه، والمادة العلمية التي جَعَلَتْه يُؤسّس لتدوين سيرته التّعليمية انطلاقا منها”، تقول الدكتورة نفيسة الذهبي.
ذروة المجد العلمي والتألق الوظيفي
ارتَقى الفقيه السجلماسي إلى مصافّ علماء المغرب الكبار، وكان يَفتخر على المجتمع العلمي الفاسي بأعالي الأسانيد الصِّحاح التي تلقَّاها عن جِلّة المشايخ، ومنها مشيخته المشرقية التي أناله إياها الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الهاشمي الشافعي إجازةً سنة 1580م – عن بُعد إنْ جاز التعبير، لأنّ الشيخ السجلماسي لم يَسبق له أنْ سافر خارج المغرب الأقصى أو قام بأيّ رحلة علمية أو روحية-، كما أجازه العالِمانِ محمد المقدسي ومحمد العلقمي المصري سنة 1584م، وبذلك اجتمع له إجازَتا المشرق والمغرب ومَشْيختِهما، حتّى وصَلت سُمعته إلى الأمراء السَّعديين فقَرَّبوه “منذ المراحل الأولى لتأسيس دولتهم، وتَوَلَّى أيام أحمد المنصور خِطَّة الفتوى بحاضرة الدولة مراكش، والإمامة والتّدريس بجامع الأشراف في حيّ المواسين (..) حتّى عُدَّ شَيخ الجماعة في عَصره”[4]، بل قَبْل عهد المنصور بسنواتٍ؛ عمِل السجلماسيُّ كاتبا في ديوان الوزير محمد بن عبد القادر بن محمد الشيخ السعدي، وذلك في مرحلة حُكم السلطان السعدي عبد الله الغالب (1557– 1574م).
لم يَنل الشيخ السّجلماسي منزلة السُّمو العلمي في الطور السعدي الأوّل مِن فراغ، فسيرته العلمية عامِرة، ونبوغه لا مجال للشك فيه، فضلا عن مَحاسن أخلاقه ومَتانه ارتباطه بدينه، وانكبابه على التحصيل العلمي في ظِل زَحمة الأعمال العامة والخاصة، فالرجل مُدرِّس بارز في جامع الأشراف، ومُفْت رَسمي بعاصمة السَّعديين، وواحدٌ من نخبة البلاط السلطاني، مُقرَّب جدا من رأس السلطة، لدرجةٍ كان أحمد المنصور السَّعدي يُنيبه عنه في كثير من القضايا المجتمعية والمظالم، ويُكلِّفه بتحرير بعض المراسلات والوثائق المهمة إلى الشّخصيات والعلماء والخارج. ويُسنِدُ إليه تكليفاتٍ علمية، منها على سبيل المثال؛ جَمْعُ “ديوان أشعار أهل البيت”، الذي صار مع الوقت كتاباً مرجعيا هاما، قُدِّر له -مع الأسف- أن يكون مِن جُملة الكُتب التي صادرها القراصنة الإسبان والفرنسيين ضمن محتويات سفينة السلطان المولى زيدان النّاصر تَاسع الأمراء السعديين الذي حَكم فيما بين (1613-1628م)، وتُوجَد مخطوطته بخطّ يد العلّامة السّجلماسي في الجناح الخاص بالمكتبة الزيدانية في خزانة الإسكوريال بالعاصمة الإسبانية مدريد حسب أقوال المؤرخين والباحثين.
وإلى جانب هذه المكانة؛ كثيراً ما سَعت السلطة السعدية إلى إبراز نخبتها العلمية وإعطائها إشعاعاً لدى الساكنة ودُوَل الجوار الأوربي، فكان الشيخ عبد الواحد دائماً في مقدِّمة الشخصيات العلمية والدينية التي تتبوّأ منزلةً رفيعة في الاحتفالات الرسمية بِعيد المولد النبوي الشريف، وكان المنصور الذَّهَـبِـي يُقَدّمه “في إنشاد قصائد المولديات”[5]، وكان دائم الحضور ضمن الوفد السلطاني السعدي من مراكش إلى فاس ومن فاس إلى مراكش لسنوات عديدة.
التأريخ لطرائق الإقراء والإجازات العلمية
الإسهام الهام للعلّامة السجلماسي يَتمثَّل في عمله العلمي الجليل النافع “الإلمام ببعض مَن لقيته من العلماء الإسلام”، الذي فرِغ من كتابته أواخر 1575م، سنة واحدة قبل معركة وادي المخازن الفاصلة[6]، وتداعيات المرحلة الانتقالية فيما بين حُكم محمد المتوكل ومعركة الملوك الثلاثة وانتقال الـحُكْم للمنصور الذّهبي، فَجَاء شاملاً “جانبَ الحركة التّعليمية، مِن وَصْفِ مَجالس الدّرس، وعناية بالمشايخ، ووقوف على العلاقات الطيبة الـمُعَبَّر عنها والمتبَادَلة بين الطلبة والأساتذة، سواء في صِيَغ التحلية والدعاء، أو في الحرص على الزيارة والإجازة. كما تَشمل تَقاليد الرواية والسَّنَد، ورصْد ضَوابط العلوم الـمتدَاوَلة، والإحساس بأهمية العلاقات الثّقافية المغربية، والمغربية – المشرقية” حسب عبارة الدكتور نفيسة الذهبي مُحقِّقة الفهرس القيم للسّجلماسي “الإلمام ببعض مَن لقيته من علماء الإسلام”.
نرتحل معه متعرِّفين على نَسيج الـمَشيخة في القرن السادس عشر، مِن تخوم الصحراء إلى حاضِرتَـيْ فاس ومراكش، ومكتشفين لَون الثّقافة التعليمية والتربوية في البيئة السعدية بالمغرب، ونتعرّف على مسارات تكوين النخبة المغربية.
لقد تَعدّدت الفهارس المغربية بين الشّاملة والجزئية وفهارس المرويات والطبقات والرحلات، والفهارس الصوفية، إلا أنّ السجماسي يُضيف إلى هذا الرصيد فهرس الإجازات من كافة المدارس والزوايا والرُّبُط التي جسَّدت مراكزَ الجاذبيةِ العلميةِ في المغرب، وكيفيات تكوين رجالات العلم والشريعة والفكر، وطبيعة الإجازات العلمية، فيُـقرِّبنا أكثر لاكتشافِ البصْمة المغربية في مجال التدريس والإقراء.
فمن زاوية الــحنَّا بدرعة؛ الموئل الأوّل لتعلُّم الشّيخ السِّجلماسي، نستفيد مِن مَدحه وإطْرائه الكبير لشيخه العالِم ابن المهدي أنّ الرجل كان يَعتمد في تدريسه على “تقديم أسلوب تعليمي نَظَري لتأسيس عنصر التكوين عند الـمتلَقِّي، ثم بعد ذلك يأتي التحسيس بأهمية تَجاوُز الاجترار ومُجَرَّد الحفظ لبُلوغ مُستوى الإدراك والتعمُّق في كل علم أو كتاب”[7].
ويَصِف لنا السّجلماسي مُجمَل طريقة التدريس بالزاوية على يد الشيخ ابن المهدي بأنها “كانت تقوم على الاقتصار في الإقراء على تَصحيح الـمتن وحلّ المشكِل وإيضاح المعقَّد”[8]، أما طريقة شيخه أحمد المنجور فتعتمد على المحاضَرة، وإتقان فنّ العَرض والبسْط والنقاش واستنباط الأحكام.
ويُعيننا الشيخ عبد الواحد -مغاربةً وباحثين- من خلال هذا العمل الفريد على فَهْمٍ دقيق للمسار الفكري والعلمي والتعليمي للمغرب في الطور السعدي الأوّل، ويَخدِمُ به هدفاً نبيلا يتمثَّل في “جَعْل التاريخ الثقافي والعلمي شيئا محبوبا ومألوفاً عند الشّباب والمثقَّفين وعامة الناس (..) ورَفْـد البرامج التعليمية بنُصوص مُستقاة من التراث العلمي المغربي”[9] وهدفاً آخر، يتمثَّل في إحاطة الناشئة والأجيال بأسماء وإجازات ومرويات الشيوخ والعلماء من فاس ومراكش ودرعة والصّحراء، وجهودهم العلمية وكفاءاتهم في تخريج النخَب العلمية المحلية، وانخراطها في الشأن الثقافي والعلمي والسياسي والديني في عصر دولة السّعديين.
إفادَة الناس بالمؤلَّفات الـنّـفـائس
أما على مُستوى الكفاءة التي أَهَّلَتْهُ لوَضْع فهرسه المفيد للأجيال، فالرجل كان ذا ذائقة أدبية رفيعة متميّزا بــ”سلاسة التعبير والكفاية اللُّـغوية وحُسـن الصِّياغة السَّجْعية”، حسب الباحثة نفيسة الذهبي. وله ما يَشهد بذلك مما أوردناه أعلاه؛ ومصنّفات أخرى غير الفهرس المذكور، أورَد له الباحث محمد حجّي رحمه الله في “معلمة المغرب”، منها: “شَرْح مَقصورة المكّودي في المديح النبوي”، و”تعاليق على ألفية ابن مالك”، و”اختصار نكت السيوطي على الألفية”. فاستحَقَّ بذلك وافر الثَّـناء على علمه وبراعته في الكتابة وخدمته لسيرة العلم في المغرب من قِبَلِ علماء كُثُر منهم، ابن المؤقِّت المراكشي في فهرسته الشهيرة “السعادة الأبدية في ذكْر مشاهير الحضرة المراكشية”[10]، والعلّامة أبو المحاسن الفاسي[11]، والمؤرّخ الكبير محمد بن الطيب القادري في “نَشر المثاني لأهْل القرن الحادي عشر والثاني”. فيما وَصَفهُ الإمام محمد بن أبي العافية المكناسي الشهير بابن القاضي بــ”الفقيه المحدِّث العالِم العامِل العلَّامة الـمُشارِك المتفنِّن الفهَّـامة، وحيد عصْره، ومصباح دهره” بعبارة ابن القاضي المكناسي، وذلك حين حديثه عن إجازته المعروفة عن الشيخ السجلماسي. وعَدَّه المُستشرِق البحّاثة لِـيفي بروفنصال من “جهابذة أهل الحديث في عصره”[12].
وقال السجلماسي عن نفسه في مقدّمة كتابه “الإلمام”: “حتى رجوتُ أنْ أكون بِـسِـمَةِ العلماء موسوماً، وفي ديوانهم مَرسوما” وذلك ما كان.
وتَوالَت منكَ الجهود حثيثة *** وتَعزَّزت في غير ما مدانِ
وفاته
خلَّف الشيخ السجلماسي الدّنيا وراء ظَهره وانتقَل إلى دار البَقاء يوم الخميس 25 رجب عام 1003 للهجرة الموافق لــ 6 أبريل 1595م ودُفن في ضريح الإمام القاضي عياض رحمهما الله، بمراكش المحروسة.
المراجع
[1] انظر: (الكتاني) محمد: "مسارات مغربية في الحضارة والثقافة"، منشورات دار الثقافة، الطبعة الأولى، 2005.[2] انظر: "أجوبة سيدي سعيد بن علي الهوزالي 913 – 1001هــ"، جمع وترتيب وتنسيق العروصي عبد الواحد، الطبعة الأولى 2015.
[3] (السجلماسي) عبد الواحد: "الإلمام ببعض مَن لَقيته من علماء الإسلام"، تقديم وتحقيق الدكتورة نفيسة الذهبي، مطبعة Rabat Net، الطبعة الأولى 2008، ص: 91.
[4] حجي محمد، "معلمة المغرب"، ج10، مطابع سلا، 1998، ص: 3433.
[5] محمد حجي، "معلمة المغرب"، مرجع سابق، ص: 3434
[6] انظر: (الإفراني) محمد الصغير: "نُزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي"، تقديم وتنسيق عبد اللطيف الشاذلي، الطبعة الأولى 1998، ص: 145.
[7] (السجلماسي) عبد الواحد: "الإلمام ببعض مَن لَقيته من علماء الإسلام"، مرجع سابق، ص: 24.
[8] (السجلماسي) عبد الواحد: "الإلمام ببعض مَن لَقيته من علماء الإسلام"، مرجع سابق، ص: 85.
[9] مجلة "ميثاق الرابطة"، العدد 238، منشورات رابطة علماء المغرب.
[10] انظر: (المراكشي) محمد بن المؤقِّت: "السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية"، مراجعة وتعليق أحمد متفكر، الطبعة الثانية، مراكش، مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، المطبعة والوراقة الوطنية، 2011.
[11] (الفاسي) محمد العربي: "مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن"، منشورات رابطة أبي المحاسن بن الجد، تحقيق ودراسة الدكتور محمد حمزة الكتاني.
[12] (بروفنصال) ليفي: "مؤرخو الشُّرفاء"، تعريب عبد القادر الخلّادي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة التاريخ، العدد 5، الطبعة الأولى 1977، ص: 166.