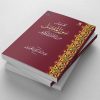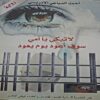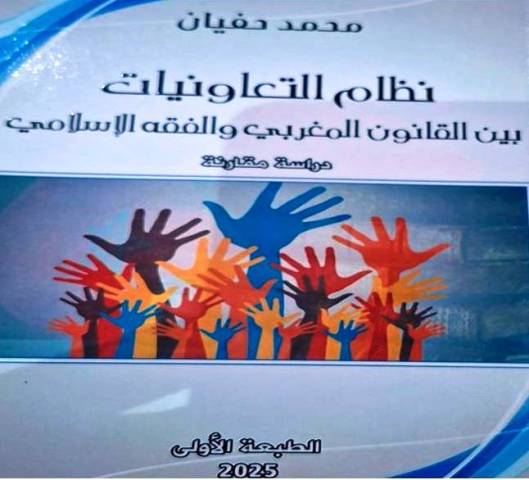
المحتويات
توطئة
إن نظام التعاونيات في المغرب يخضع لمقتضيات القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، والذي يحدد القواعد المنظمة لتأسيس التعاونيات وإدارتها وحلها. يهدف هذا النظام إلى تنظيم عمل التعاونيات في مختلف القطاعات، سواء كانت فلاحية، صناعية، أو خدماتية، وتشجيع التعاون بين الأعضاء وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد عرف التعاون الإنساني تطورا كبيرا، فبعد أن كان فطريا فرديا وأسريا ثم قبائليا، صار تعاونا منظما ومقننا، وصار للفكر التعاوني منظرون فلاسفة ومصلحون اجتماعيون واقتصاديون عبر التاريخ، وفي جل بلدان العالم المتقدم والمتخلف، حتى أضحى هذا الفكر ينافس الفكر الرأسمالي والفكر الاشتراكي، إن على المستوى النظري أو التطبيقي العملي. كما عرف انتشارا واسعا بفضل انتشار التعاونيات، وتوسعها لتشمل جميع المجالات: الاجتماعية منها، والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها. وبفضل تعاون التعاونيات وتكتلها محليا ودوليا، الشيء الذي رسخ لها مكانة رائدة على ساحة الاقتصاد العالمي.
أمام الدور الفعال المتنامي الذي تقوم به هذه التعاونيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذا الإنساني، وفي خضم الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الإسلامي الذي بدأت تتسع رقعة انتشاره ونفوذه على المستوى العالمي بكل سلاسة، إن على مستوى المصارف، أو التأمين أو البورصة، أو شركات توظيف الأموال… وخصوصا بعد صموده القوي أمام الأزمة المالية العالمية الرأسمالي لسنة 2008، وبهذا غدا الاقتصاد الإسلامي بديلا واعدا للاقتصاد الرأسمالي. وتبعا لذلك، يأتي كتاب “نظام التعاونيات بين القانون المغربي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة” لمحمد حفيان، ليساءل واقع التعاونيات وموقعها باعتبارها مؤسسات اقتصادية واجتماعية في الاقتصاد الإسلامي؟ وما موقف الشريعة الإسلامية من هذه التعاونيات، خصوصا فيما يتعلق بالقيم وبالمبادئ التي تنبني عليها في تحقيق وجودها وأسلوب إدارتها في تدبير أعمالها وأنشطتها لتحقيق أهدافها من خلال مشاريع وبرامج مخططة؟ وما هي الضوابط الشرعية لأنشطتها مقارنة مع القانون المغربي المنظم لأنشطتها ؟.
إشكالية البحث وأهميته
إن المتصفح للإحصائيات الدولية عن عدد التعاونيات ببلدان العالم، لابد أن يصدمه ويستوقفه العدد الهزيل، الذي يحظى به العالم العربي والإسلامي من هذه التعاونيات مما يدفع إلى الاستفسار عن سبب ذلك، وأول سؤال يتبادر إلى الذهن، هل ذلك راجع لموقف الإسلام من التعاونيات أم لأسباب أخرى؟ فكان من الواجب أن يجيب المؤلف عن هذا التساؤل. وما هذا البحث إلا محاولة للإجابة قدر المستطاع.
وتتجلى أهمية البحث في ملامسته الموضوع: التأصيل للعمل التعاوني المنظم، وفي كونه أول بحث حسب علمه يتناول هذا الموضوع من زاوية شرعية، كما يتوخى البحث أن يعطي العمل التعاوني دفعة قوية للانتشار والتأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني.
مضامين الكتاب
لقد فطر الله عز وجل الإنسان على التعاون، فصار له سلوكا تفاعليا، ضروريا لإشباع حاجاته المختلفة والمتجددة، التي لا يمكن أن يشبعها لوحده، وهذا الذي وضحه ابن خلدون في مقدمته. علاوة على ذلك فالتطور السريع الذي عرفته البشرية في جميع المجالات، خاصة بعد الثورات المتتالية الصناعية، والتكنولوجية، والمعلوماتية، أصبحت مطالب الإنسان ومصالحه الضرورية والحاجية والكمالية كبيرة ومتنوعة.
وبفعل تعقد العلاقات والمعاملات وحفاظا على استقرارها واستمرارها ودفعا للمنازعات، صار من اللازم تنظيم التعاون الجماعي وتقنينه وتوثيقه بعقود منظمة. مما عجل بمأسسة التعاون الجماعي المنظم، بظهور المؤسسات التعاونية، ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي، على اختلاف أنواعها وأحجامها، فعرفت انتشارا كبيرا على الصعيد المحلي وكذا الدولي، فرضت من خلاله مكانتها بديلا واعدا لتحقيق التنمية المستدامة وأملا منشودا أمام الإنسانية للرقي والرفاهية.
والكتاب الذي بين أيدينا يحاول أن يقرب هاته التعاونيات من القارئ، والتساؤل بشأنها باعتبارها مؤسسات اقتصادية واجتماعية، والذي يقع في 108 صفحة، وصدر عن مطبعة وراقة بلال بفاس. وهو محاولة للتعريف بالتعاونيات وأدوارها، ودراسة مقارنة تجلي الرؤية الغربية والإسلامية للتعاون والتعاونيات، ووضعها في القانون المغربي.
وقد قسم الباحث بعد المقدمة كتابه إلى أربعة فصول جاءت على الشكل كالتالي:
- الفصل الأول: الرؤية الغربية للتعاون والتعاونيات.
- الفصل الثاني: الرؤية الإسلامية للتعاون والتعاونيات.
- الفصل الثالث: التعاونيات في القانون المغربي.
- الفصل الرابع: التعاونية بين الرؤية القانونية المغربية والرؤية الشرعية.
خلاصة
اعتمد الكاتب، المغرب نموذجا لبحثه، باعتباره بلدا إسلاميا، وله قانون عرف إصلاحات متتالية حتى يواكب وينظم حركية التعاونيات المتسارعة، كما توسع في تعريف التعاون والتعاونية لغة واصطلاحا، وتتبع بشيء من التركيز بداية وتطور الفكر والحركة التعاونية وروادها عبر التاريخ في كل من اليونان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ووقف على أهمية التعاونيات وأنواعها وقيمها ومبادئها العامة وكيفية تكونها ومكوناتها، وطرق تدبيرها إدارة ومراقبة. كما وقف على الموقف الإيجابي للإسلام من التعاون إجمالاً من خلال آيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤطر التعاون المنشود وتدعو إليه. وسجل انقسام الفقهاء اتجاه التعاونيات الحديثة إلى ثلاثة تيارات الأول: الرافضون بالمطلق، والثاني: القابلون بالمطلق، والثالث: القابلون بشروط، وهذا التيار الأخير هو تيار الوسط وهو الذي تبناه الباحث. كما استعرض البحث خصائص التعاونية وما يميزها عن الشركة والجمعية الخيرية، وفصل في أنواع التعاونيات، وأبرز عدة تجليات قديمة للتعاون والتعاونيات بالمغرب التي كان يؤطرها العرف. كما وقف على بداية تقنين التعاونيات وتطوره لمواكبة صيرورة الحركة التعاونية العالمية، وسجل هذا التطور في شروط التأسيس وإدارة التعاونيات. وقام بتأصيل القيم والمبادئ التعاونية التي تبناها القانون المغربي رقم 12-112 المنظم لنشاط التعاونيات، وبين أنها لا تتعارض مع قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية بل تتوافق معها إلى حد التطابق.