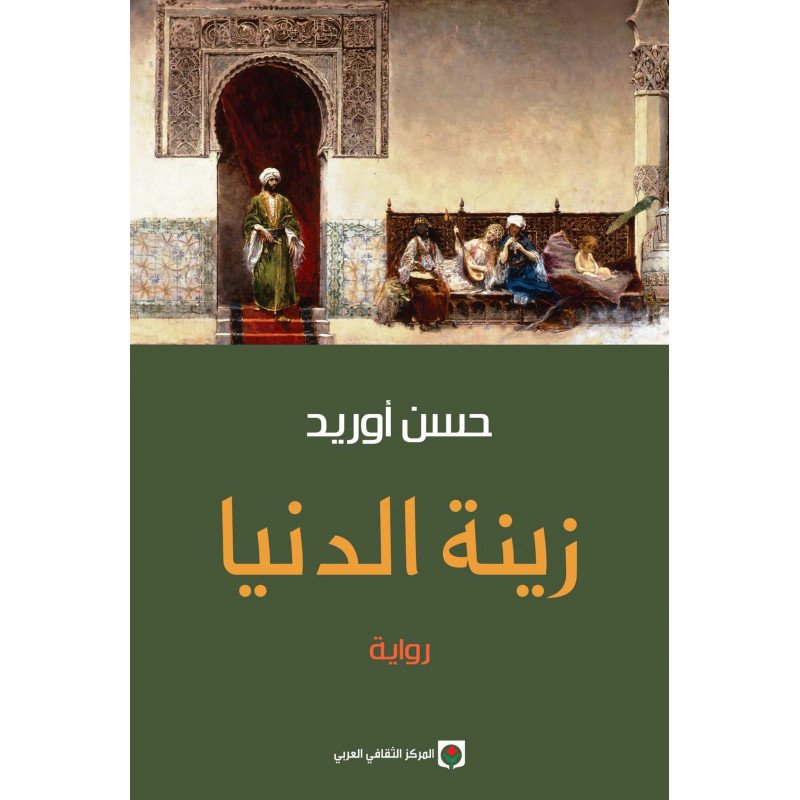
المحتويات
عمل روائي محترِف
تسترجع هذه الرواية البَدينة[1] مرحلة حاسمة ومتقلّبة من تاريخ الأندلس، بنَفَس روائي بديع وحبْك مُقنع، يُدمِج الوقائع التاريخية الحقيقية بالخيال الواسع، ليُتحفنا بعمل فني أدبي رائق.
رواية “زينة الدنيا” من الأعمال القيمة للمفكر واللأديب المغربي حسن أوريد، تممّ بها جهود التأسيس الروائي عن تاريخ الأندلس الذي بدأه في “ربيع قرطبة”[2]. لن تدعَك تفلت من قبضتها وستُلزمك القعود لساعات طمَعًا في إنهائها، أمّا إن كُنتَ من دارسي تاريخ الأندلس ومحبيه، وعلى اطلاع ببعض مساراته وأبرز أحداثه من خلال المصادر والمراجع؛ فإني على يقين أنك ستحرص على أنْ لا تُنهيها، ستطمع في أنْ لو ناهزت 1000 صفحة. ستَغضب وتحزن وتَستفزك مواقف الرجل من السلطة ومساراتها ورجالاتها في الغرب الإسلامي، ولكن حتما ستستمع، لأنك أمام عمل روائي مُتقَن.
الأندلس؛ الوقائع لأهلها والخيال لكاتبه
تقاطعات كبيرةٌ وكثيرةُ التِّرداد بين التاريخ والواقع والإبداع الخيالي، يُقيم الأديب أوريد هَيكل الرواية على أرضية مُتون تأسيسية حينَ استدعائه للأحداث الممتدة ما بين تاريخ وفاة الخليفة الثاني الـحَكم بن عبد الرحمن، وتاريخ وفاة الحاجب القوي محمد بن أبي عامر المعافري، ويَبنيها على زيارة ميدانية قام بها لقرطبة وإشبيلية ومجريط والجزيرة الخضراء وما بينها من أرباض وقرى وحصون، الباقي منه والتالد والقائم في بطون الكتب ودواوين الشعر.
تمتدّ الوقائع ودينامية الأشخاص الحقيقين الذين كانوا فاعلين في مسرح الأحداث بالأندلس عبر فصول الرواية جميعها، تُدخل القارئ في عملية إعادة القراءة لمساراتٍ مِن تاريخ تلك المرحلة وتلك البلاد، ومُسائَلة بعض المسلَّمات التي انبنت في ذهنه، ورفْض مواقف وأحكام الكاتب أحياناً، لأنه لا يمكن لنصٍّ روائي وقراءة أدبية لما حَدث أنْ يُقحمنا في نفس الإطار، لقَبول ما يتلجلج في خاطر الكاتب.
من مُفتتح الرواية إلى مُنتهاها؛ يَنصَبّ الجهد الجبار للكاتب على الجانب المتعلق بالخيال، بالإبداع، بالحوار، بالسّرد وفنون الرد، وهو الشِّق الثاني الذي تنبني عليه الرواية. فالواقعي والخيالي لا ينفصلان، بل يتعالَقان، يَسيران صِنوان ليُقدّما لنا عملاً متميزا، مُواكِبان مجالات تنافُسِ وتداخلِ السلطة والثقافة والدين، ومتعقّبان طبيعة الصراعات الداخلية والبينية الحضارية، والصّراعات الثقافية والتأويلية بين السّلطة والمجتمع والنخبة، وكاشفان ما كان عليه حال زينة الدنيا.
الرواية رحلة خاصّة مع تجربة إنسانية لذيذة ومتقلِّبة، حُزنا وفَرحا، بطلها شخص يتقلّب في هويات وشخصيات ومواضع عديدة، سعيا للحقيقة من أجل زينة الدينا؛ الأندلس التي تليق بجميع مواطنيها، متسلِّحا في ذلك بذخيرة الأمل، وبالفطنة، وكَرم القَدَر معه، وتَصبُّ أنهار حياته في مَجرى حياة أسرة آمنة مستقرة، ليُضيف إليها نكهة خاصة، ومعنىً إلى معناها. عالَمٌ صغير مكون من مرية الغجرية وباشكوال القوطي الروح العربي اللسان الدهري الأدلوجة، وراحيل اليهودية، وجُمانة/الرميكية المسيحية وتُودة الزنجية، وزيري المسلم الأمازيغي الأندلسي. وفي سنوات أُخَر؛ يَنضافُ يوسف المنشطر بين الانتماء للمُنجِب والـمحتضِن، ثمّ تَتْريت التطوانية الأمازيغية، والبُنية هند، آخر العنقود. توليفة عجيبة وبيت جمَع الأشتات، في منطقة أستجّة، مِرساة الروح الحائرة لــزيري، والعِقد الفريد حيث يَتحقَّق المجتمع الصغير الممثِّـل لحقيقة زينة الدنيا.
تحبُل الرواية بقضايا حقوق الإنسان والقيم والعقد الاجتماعي والفكر وطبائع الاستبداد واللغة والهوية وموقع العالم والفقيه في بنية السلطة “تهمني البنية التي أنجبت هؤلاء”، ص: 99، والجمال والنخبة، والجنس والعلاقات الغرامية (..) الأديان والعيش المشترك[3]، والدين والسياسة، وحرية الأفكار[4] والحروب.
يحضُر التاريخ شامخا في النص، تاريخ الأفراد، تاريخ الهامش والمهمَّشين، تاريخ الأقليات، تاريخ الأمكنة، تاريخ الـحُكم والـحكَّام، تاريخ الفتوحات والغزوات، تاريخ الأفكار والمعرفة[5] والشخصيات الـمبرَّزة في قرطبة وإشبيلية والمغرب الأقصى.
طبائع الاستبداد ومَصارِع المؤتَمن على زينة الدنيا
في الجزء الثاني تطالِعُنا أحداثُ الرواية كاشفةً عن وقائع فجائعية في تنامي طبائع الاستبداد وتخلُّق النخبة السياسية بأخلاق مرحلة الـمُستبد، وتنتعشُ ذاتُ الكاتب (أوريد) في التعبير عن مكنون مواقفه من السلطة والبلاط وفيالق تبرير الاستبداد من علماء وشعراء وحكماء ومثقفين وأدوات تنفيذية أخرى، ويوظِّف المؤلِّف تخصُصه في العلوم السياسية وانحيازاته الفكرية إلى كتابات حكماء الإغريق ومتنوّري حركة النهضة الأوربية في الدفاع عن العقل والعقلانية والعدل وثقافة الاعتراف. وتتوارى إلى الخلف ربما بحكم تطوّرات مرحلة الأوْج السياسي والعسكري للمنصور بن أبي عامر؛ عبارات التقدير لإنجازات الرجل _ وما أكثرها مما ذَكَرَته مصادر المرحلة وغيرها (ابن عُذاري المراكشي، لسان الدين بن الخطيب، عبد الرحمن بن خلدون، أبو العباس المقري، محمد عنان)_، وحتى إن وَردت على لسان بطل الرواية أو العقلاني السياسي المعتزل (باشكوال) فهي من باب التهكم.
يَتوسّع المنصور خارجيا لتجديد شرعيته داخليا، ويَستعمل سطوة الانتصارات الخارجية لضبط الرعية تحت مبرِّر حماية الدولة وصيانة بيضة الإسلام، فــ”كان اللجوء إلى القوة والبطش والعنف؛ احتماء من الخوف، من الهلع الذي يَسكن كل متجبر”[6]، بينما يقرر الكاتب أنّ القوة الحقيقية “هي أنْ يُقيم المنصور نموذجا تتعايش فيه الملل والنحل”.
لا يُـثنينا هذا الجانب في الرواية عن التمتع بالولوج إلى “الزاهرة” و”حي دار النعمان” و”مُنية السرور” وتعقُّب إيقاع الحياة الخاصة في العامرية وقصور الزاهرة والنقاشات المصاحِبة للحملات الصيفية والشتائية للمنصور شمالا وجنوبا، وحواراته مع وزرائه ونُدمائِه.
تتطوّر شخصية زيري وتَنضج على نار الحياة المتقلّبة والظروف العَصيبة، يُزاوج فيها بين خبرته السياسية، وحنكته في التخفي وإدارة أزمة الهوية، وحياته الخاصة. نتابعه في كَبدٍ يَفوقُ كَـــبَدَهُ، تَتلاحق أنفاسنا ونحن نعايش انقماعه تحت آلة التّحول الرهيب في مواقف وشخصية ابن أبي عامر، ونخبته الفاسدة، نعاني مع انشطاره بين ظاهر يُبديه وحقيقة يُخفيها، بين حرصه على الوفاء للإرث الثقيل الذي خلَّفه له الراحلون (تُودة، إستير، باشكوال، راحيل)، وصيانته لزينة الدنيا التي جسّدوها قيْد حيواتهم، ومُجاراة الواقع العنيد بُغية تغييره، تصحيح مساره، وحماية “الفكرة” التي يحملها.
يأتي خبر الوفاة الغامضة لــإستير والنهاية الأليمة لرفيقة حياته الرّميكية ليهزّ كيانه، ويُبديه لنا هشا ضعيفا، ووفيا في الآن ذاته. تُخرجه تطورات الأحداث عن طَوره، فيتموقف سلباً من عذاب الضمير الذي يُلحقه به ابن أبي عامر نتيجةَ تصفيته المتتالية لوالي سَرَقسطة وابنه البكر عبد الله والسّياف ابن خفيف وغيرهم، واستغراقه في الإهانات والسلطوية، فيفهم المنصورُ تموقف وزيره منه، ويشرع في ترتيب مراحِل الردّ. لأول مرة وبَعد مسار مطبوعٍ بالدهاء والفطنة والنجاة من الأحابيل؛ يجد زيري نفسَه أمام شخص استثنائي، يفوقه ذكاء[7] وخبرة ودهاء، سياسي من الطراز الخطير، يَقرأ ما يجول في خاطره، ويُدخله في متاهة من الأسئلة والشك والخوف. تتلاحق شكوك زيري ويَتَأَكّد مِن أنه مُستَـهَدف، وقاب قوسين من فُقدان حياته، عندما سيُلقى به في الإقامة الجبرية، التي ظَــــنَّها خياراً محمودا بادئ ذي بدء، لتنقلب جحيما لا يُطاق، وقد طالت لتسع سنين.
محنة حقيقية سيُكابدها زيري، لكن المؤلِّف سيُدخلنا إلى عوالم القوة لدى هذه الشخصية؛ الانكباب على العلم، التأمل، نهل الحكمة، الصبر الإيجابي، الغَور في أرشيف هند بمكتبة باشكوال، استجماع المعطيات عن الخارج من يوسف، النجاح في الالتفاف على ظروف الحُكم والسياسة للظفر بزيارةِ أهله وقضاء بعض الوقت في أستجة التي تُشَكِّل لديه الواحةَ الفيحاء من هجير قرطبة والزاهرة.
تتصاعد الأحداث منذِرة بقُرب انهيار منظومة الحكم الفردي العامري، ومعها اشتداد ظروف الأسْر على زيري، الذي أضحى حائراً لا يدري أفي الموت راحة أم في الصمود وانتزاع الحياة من مخالب الإقامة الجبرية والظرفية النفسية والعائلية والاقتصادية العصيبة؟ تنصرم الأعوام؛ ليَلقى زيري نفسهُ مُطالَبٌ بمغادرة بيته صوب وجهة لا يعلمها، ليلتقي أخيراً وجهًا لوجه أمام المنصور، الذي حافظَ على توهُّج عقله ودهائه رغم مرضه الأليم في غزوته الأخيرة صوب الشمال. فاجأَ المنصورُ زيري أنه كان على علم بحقيقته، بحقيقة شخصيته، بحقيقة اندساسه في بلاط الحكم وتَــقرّبِه إليه وأنه استنكَفَ عن قَتْله، فيُقابِل زيري كلام المنصور بجرأة التعريف بنفسه ومساره، بل ويهدِّده أنّه أكثر من مجرد رجل[8]، أنه فكرة، وحامي زينة الدنيا وشاهد على حقيقة الأندلس، وأنه لسان التاريخ.
تجري سُنّة الحياة على الملك المنصور الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، ويموت على مشارف مدينة سالم بقلعة النسور، سنة 392 هجرية، لتسقُط أكبر سلطة سياسية وعسكرية في الغرب الإسلامي آنذاك، ونتفاجأ بالكاتب يُعْلِمنا نبَأ استشهاد البطل زيري ويُبدع في إدخالنا متاهة السؤال عن حقيقة موته إذ الجميع في الأندلس شَكَّك في الرواية الرسمية لوفاته، فنأسى ونأسف على موت الـحالِم بأندلس تتَّسع للجميع، الحالم بترميم شظايا العلاقة المشطورة بين الحاكم والمحكوم، العالم والمتعلم، الصبي والراشد.
المراجع
[1] أوريد حسن، زينة الدنيا، 639 صفحة، عن المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى 2021.[2] أوريد حسن، ربيع قـرطبة، 170 صفحة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى 2018.
[3] أوريد حسن، ربيع قـرطبة ، ص: 294.
[4] أوريد حسن، زينة الدنيا، ص: 336 _ 337.
[5] أوريد حسن، زينة الدنيا، ص 287.
[6] أوريد حسن، زينة الدنيا، ص: 399_ 400
[7] أوريد حسن، زينة الدنيا، ص 425.
[8] أوريد حسن، زينة الدنيا، ص: 638.





















